لا تُعيِّرهُمْ.. فيَسْخَروا منكَ!
عيّرتْ بعضُ الطُّيورِ البشرَ بالأمراضِ، فقالتْ: كفاكُم ظلماً وجَوراً بعضَكم ببعضٍ، وبغيرِكم من المخلوقاتِ، فلعنَكمُ اللهُ، وابتلاكُم بأمراضٍ كثيرةٍ، خطيرةٍ وخبيثةٍ، وحلّتْ عليكمُ النّقمةُ بالزّلازِلِ والبراكينِ والأعاصيرِ والفيضاناتِ والحروبِ والنّيرانِ والقتلِ والتّدميرِ، ولوَّثتُم الماءَ والهواءَ والبحارَ والأنهارَ، ووصلَ حقدُكم إلى النُّجومِ والكواكبِ، فلا تنتظرُوا رحمةً أو شفقةً أو نعمةً أو سلاماً وأمناً من السَّماء.
فالطّبيعةُ باتتْ تكرهُكم بكلِّ ما فيها من عناصرَ ومكوِّناتٍ، والسّماءُ تَبغُضُكم بما فيها من نجومٍ وكواكبَ وشهبٍ؛ لأنّكم منذُ أن خلقَكم اللهُ على الأرضِ، وتاريخُكم سجِلٌّ حافلٌ بالقتلِ والدّماء والخداعِ والإغواء، بدءاً من أبناءِ آدمَ وحوّاء، إذ قتَل قابيلُ أخاه هابيلَ، وأَخرجَت حوّاءُ زوجَها آدمَ من الجنّةِ.
وكلُّ تاريخِكم مؤامراتٌ وفتنٌ وحروبٌ وظلمٌ واستبدادٌ وقهرٌ، فليس بعيداً عليكم أنْ يبتليَكم اللهُ بالكثيرِ من الأمراضِ الّتي تحصدُكم حصْدَ النّارِ للهشيمِ، ولا بدّ أن نذكِّرَكم بأهمِّ الأمراضِ الّتي تفتكُ بكم، منها: الطّاعونُ الّذي ابتلاكُم به اللهُ حين دمَّرتُم الطّبيعةَ وقتلْتُم البشرَ، وتركتُموهم جثثاً تتفسَّخُ وتتعفَّنُ تحت أشعّةِ الشّمسِ في عصورِكمُ التّاريخيّةِ المختلفةِ، وفي مختلِفِ بقاعِ الكرةِ الأرضيّة. ثمّ اقتحمَتْكمُ الكُوليرا، وراحتْ تقضُّ مضاجعَكم، وتنتَهِكُ حُرماتِ أرواحِكم وأجسادِكم، وكان ذلك عقاباً لكم من ربِّكم، بسببِ جرائمِكم وطغيانِكم ضدَّ جميعِ الكائناتِ.
وتفنَّنتُم في إحراقِ الطّبيعةِ، وتلويثِ الأرضِ والسّماءِ بدخانِ حقدِكم، وبمختلِفِ أنواعِ الإشعاعاتِ والسُّمومِ ونيرانِ حروبِكم، وبشتّى أنواعِ أسلحةِ الدّمارِ الشّاملِ والأسلحةِ الكيميائيّةِ، فابتلاكُمُ اللهُ بالسّرطانِ الّذي راحَ يفتكُ بالملايينِ منكُم، ويتفنَّنُ في إصابةِ مختلفِ نواحي أجسادِكم، ابتداءً من الدّماغِ ومروراً بالحلْقِ والأنسجةِ المختلفةِ والدّمِ والرّئةِ والقلبِ والثّديِ والجِلدِ، فلم يدعْ لكم عضواً يسلَمُ من الخطرِ.
وانهمكْتُم في الملذَّاتِ وأطلقتُم لها العنانَ، وتجاوزْتُم فيها كلَّ حدودِ الأعرافِ والقوانينِ والشّرائعِ، وتفوَّقتُم فيها على كلِّ الأممِ الّتي خلَتْ من قبْلِكم، فأينَ منكم قـومُ عادٍ وثمودٍ وقومُ لوطٍ، لقد صنعْتُم ما لم يصنعْهُ الأوّلُون، وفعلتُم ما لم تفعلْهُ دوابُّ الأرضِ منذُ أن أنشأَها اللهُ على وجهِ البسيطةِ، وأضحيْتُم ترتكِبُون المعاصِي في وضحِ النّهارِ دونَ خجلٍ أو وجَلٍ، حتّى صحّ فيكم قولُ شاعرِكم أبي تمّامٍ:
يعيشُ المــــــــــرءُ ما استَحْيَى بخيـرٍ ويَبقَى العــــــــودُ مــــــــا بقيَ اللِّحـاءُ
فـَلا واللهِ مـــــا في العَـــيْشِ خيـــــرٌ ولا الدُّنيـــــــــــا إذا ذهَـــــــبَ الحيــاءُ
إذا لم تخشَ عاقـــــبةَ اللّيــــــالي ولمْ تســــــتَحْيِ فاصـــــــنعْ مــا تشـــــــاءُ
وشذَذْتُم عن الفطرةِ الّتي فطَرَكمُ اللهُ عليها، فارتكبْتُم الرّذائلَ والمعاصيَ الشّاذّةَ مع بَني جنسِكم ومعَ سائرِ مخلوقاتِ اللهِ، وأطلقْتُمُ العنانَ للدَّاعِراتِ واللُّوطيّين أمامَ مرأَى النّاسِ وفي شاشاتِ فضائيَّاتِكم، وصارَ الشّذوذُ دعايةً اقتصاديّةً وسياسيّةً، وبرنامجاً منظَّماً تُنفِقُون عليه الملايينَ؛ لتحقيقِ أهدافٍ ومصالحَ لا إنسانيّةٍ ولا أخلاقيّة؛ ولذلك حلّتْ عليكمُ مصائبُ أمراضٍ لم يعرفِ التّاريخُ البشريُّ لها مثيلاً فيما خلَا من القرونِ، ومن هذهِ الأمراضِ اللّا أخلاقيّةِ: مرضُ الزُّهْريّ ومرضُ نقصِ المناعةِ المكتَسبةِ (الإيدز) والسِّفْلسُ وغيرُها ما ظهرَ منها وما بطنَ، وقد يبتلِيْكمُ اللهُ بأمراضٍ أشدَّ منها فتكاً في المستقبلِ.. وها أنتمْ تُهلِكون أنفسَكم وتُلْقُون بها إلى التَّهلِكةِ، وتقذفُون بها في مَهاوي الرّدَى، وتَدفعُون بها إلى نارِ الجحيمِ، غيرَ مُبالِين بالعواقبِ، وغيرَ خائفينِ من المصيرِ المحتومِ بالهلاكِ والفناءِ!
وها أنتم – رغمَ تجبُّرِكم وتحضُّرِكم – ما زلتُم عاجزينَ عن إيجادِ دواءٍ ناجعٍ للقضاءِ على واحدٍ من تلكَ الأمراضِ، بالرّغمِ من أنّكم غزوتُمُ الفضاءَ، وخرقْتُم أجوافَ الكرةِ الأرضيّة! فنِقْمةُ اللهِ عليكم يا أعداءَ أنفسِكم، وأعداءَ الطّبيعةِ والكائناتِ، وأعداءَ الكونِ والإلهِ.
وازدادَ حِنقُ الطّيورِ على الحيواناتِ، فراحتْ تُعيِّرُ قطيعَ الأبقارِ بجنونِ البقرِ، وراحتْ تدعُو للحيواناتِ الأخرى بأنْ تُصابَ بالهلْوسةِ والهِيسْتِيريا؛ لأنّ الحيواناتِ تركتْ طبيعتَها الحيوانيَّةَ الجميلةَ، وأصبحتْ تُمارسُ الجنونَ كالبشرِ.
فالأبقارُ خرجتْ على طعامِها التَّقليديِّ: الحشائشِ والأعشابِ والحبوبِ، فأخذتْ تتشبَّهُ في طعامِها بطعامِ البشرِ، وشرعَتْ تتناولُ وجباتٍ غنيَّةً بالبروتيناتِ والأملاحِ، وراحتْ تعيشُ في حظائرَ مرفَّهةٍ جدّاً أكثرَ من بيوتِ البشرِ من الفقراءِ في الدُّولِ الفقيرةِ والنّاميةِ.
وأصبح عندَها الخدمُ والحشمُ من المهتمِّينَ والمربّينَ، وباتَ لكلِّ مجموعةِ أبقارٍ طبيبٌ بيطريٌّ، وصارَ الطّبيبُ البيطريُّ يتجوَّلُ في القُرى والمزارعِ بحثاً عن الدّوابِّ المريضةِ، في حينٍ لا نجدُ طبيباً بشريّاً واحداً يُغادرُ عيادتَه الّتي باتتْ أشبهَ بنباتِ صائدةِ الذُّبابِ، حيثُ يصطادُ مرضاهُ، وهو جالسٌ خلفَ طاولتِه، وأدواتُ صيدِه سمّاعةٌ لا يسمعُ بها إلّا قرقعةَ الدَّراهمِ في جيوبِ المرضَى، وميزانُ حرارةٍ لا ينقلُ له إلّا حرارةَ الفُلوسِ أو برودتَها، وسريرُ خداعٍ يُوهِمُ المرضَى بأنّهم تحتَ إشرافِ العنايةِ الإلهيّةِ تحفُّ بهم الملائكةُ صفّاً صفّاً، وتنفُثُ في أبدانِهم الشّفاءَ والدّواءَ، فيشفَى المريضُ قبلَ أن يتناولَ الجُرعةَ الأُولى من الدّواءِ.
هذا ولم تعُدِ الأناملُ البشريّةُ تُعجِبُ الأوانسَ من الأبقارِ المُدِرّةِ للحليبِ، لتُدغدِغَ أثداءَها؛ كي تدرَّ بلبانِها، وإنّما صارتْ لا تشعرُ بلذّةِ الحلْبِ، إلّا على لمساتِ الأجهزةِ الكهربائيّةِ، مع أنغامِ الموسيقَا الرّومانسيّةِ الّتي تُنْسي البقرةَ همومَها، وتُقلِعُ عن أفكارِها الثّرثارةِ، فتسْترخِي لمشاعرِها، وتستلِذُّ بالوسائلِ الحديثةِ، بعد أن ملّتْ من الطّرائقِ التّقليديّةِ والكلماتِ ذاتِ المعاني المعجمِيّةِ الجامـدةِ من مثلِ (هو عَيْنيْ.. عَينيْ جمّول.).
إنّها بحاجةٍ إلى موسيقَا هادئةٍ؛ لترتاحَ وتدرَّ بخيراتِها على أصحابِها، على نقيضِ الأجيالِ الصّاعدةِ من البشرِ الّتي لا تعرفُ للنّومِ طعْماً ولا للرّاحةِ سبيلاً إلّا على هديرِ الآلاتِ الموسيقيّة الّتي تُشبِه هديرَ الطّائراتِ والدّبّاباتِ والبنادقِ، وكأنّكَ في معركةٍ حربيّةٍ، وقفَ فيها المغنّي يتبجَّحُ كالقائدِ العسكريِّ، وأمامَه غوغاءُ من المستمِعينَ البُلهاءِ، وهو يحتسيْ مع فرقتِه كؤوسَ الخمرةِ، كأنّه في نشوةِ النّصرِ يردِّدُ ملحمةَ الانتصارِ، ومن أمامِه الجنودُ يهتفُون له ويصفِّقُون ويردِّدُون كلماتِه تعبيراً عن روحِ الحماسةِ ونشوةِ الظَّفَرِ.
وكيفَما درّتِ البقرةُ بلبانِها، فللّهِ درُّها! ووفّقَها اللهُ لما يُحبُّ صاحبُها ويرضَى، وطالما أنّ الغايةَ واحدةٌ، ألا وهيَ الحصولُ على الحليبِ بغزارةٍ، فلا يهمُّنا نوعُ الوسيلةِ؛ لأنّ الغايةَ تبرّرُ الوسيلةَ، كما أنّ الاستعمارَ، بشتّى أشكالِه، يبرّرُ كلَّ الوسائلِ المحرَّمةِ أخلاقيّاً ودوليّاً في سبيلِ تحقيقِ غاياتِه من الاحتلالِ والهيمنةِ على مقدَّراتِ الشُّعوبِ السّياسيّةِ والاقتصاديّةِ والثّقافيّةِ.
في حينٍ نجدُ أنّ الكثيرَ من الأمّهاتِ من جنسِ حوّاءَ قد تخلّيْنَ عن رضاعةِ أطفالِهنَّ، وضربْنَ بالغايةِ الّتي من أجلِها أصبحْنَ أُمّهاتٍ، عُرضَ الحائطِ، وحَرَّمْنَ كلَّ الوسائلِ الّتي من شأنِها إدرارُ الحليبِ للرّضيع؛ وذلك حفاظاً على حجمِ أثدائهنَّ وجمالِ أجسادِهنّ، مُتجاهِلاتٍ مشاعرَ أطفالِهنَّ وأزواجِهنّ على السّواء.
فكانتِ العقوبةُ الإلهيّةُ للنّساءِ سرطانَ الثّدي الّذي باتَ يهدِّدُ كلَّ نساءِ العالمِ، وأضحى الخطرَ الأكبرَ الّذي يُقلِقُ بناتِ حوَّاءَ من النّساء.
وكانتِ العقوبةُ الرّبّانيّةُ لمجتمعِ الأبقارِ بسببِ خروجِه على تقاليدِه في الغذاءِ والشّرابِ والرّفاهيّةِ الزّائدة، هي جنونُ البقرِ الّذي حصدَ عدداً كبيراً من أفرادِه، وباتَ يهدّدُ المجتمعَ البشريَّ الّذي يفوقُ جنونُه جنونَ البقرِ بعشراتِ الدّرجاتِ على مقياسِ (جنونِ ريختَر). ولم يبقَ في أيديْنا إلّا رفعُها بالدّعاء: الّلهمَّ جنِّبْنا جنونَ البقرِ، وقِنا مهالِكَ جنونِ البشر!
والسُّؤالُ المهمُّ الّذي يطرحُ نفسَه هو: لماذا لمْ يُصَبِ الحميرُ مثلاً بجنونِ الحميرِ؟!
قد يقولُ قائلٌ: ليسَ عندَ الحميرِ عقلٌ ليُصابُوا بالجنونِ، فأقولُ: والبقرُ ليسَ عندهُم عقلٌ، ولكنَّهم تخلَّوا عن طبيعتِهم، ولحِقُوا بجنونِ أصحابِهم الّذين أصابَهم جنونُ الثّراءِ والسّعيِ وراءَ المادّة، فحلَّ وباءُ جنونِهم المادّيِ في مجتمعِ الأبقارِ، وأصابَهم بمرضِهم الّذي عُرفَ باسمِهم.
أمّا الحميرُ الطَّيِّبـونَ المحافِظُون على أخلاقِهم، فعندَهم من سَعةِ العقلِ والتّفكيرِ أكثرُ ممّا عندَ كثيرٍ من قوَّادِ العالمِ وساستِه ووجُوهِه العسكريّةِ الطّاغيةِ، ولذلكَ باركَ اللهُ بهم وسدَّدَ صحَّتَهم على الشَّعيرِ والعشبِ النَّضيرِ والقناعةِ بالقليلِ من الكثيرِ، وجنَّبَهم كلَّ أمرٍ خطيرٍ، ورحمَ اللهُ حماراً عرفَ حدَّهُ، فوقفَ عندَه.
لكنّ الطّيورَ ظلّتْ تنعمُ بنعمةِ الصّحّةِ، طالمَا كانتْ تعتمدُ في غذائِها على الطّبيعةِ ومواردِها، إلى أنْ تدخّلَ المجرمُ البشريُّ في تدجينِها وتدليلِها وإطعامِها ما ليسَ في طبيعتِها، فأطعمَها البروتيناتِ، ولقَّحَها؛ ليجنيَ أقصَى درجاتِ الرّبحِ، ضارباً -عُرضَ الحائطِ- بكلّ القيمِ والمثلِ الأخلاقيّةِ والإنسانيّة والحيوانيّةِ، وما كانتِ النّتيجةُ إلّا مرضاً خطيراً، لم يعرفْه جيلٌ من الطّيورِ على مرِّ العصورِ، وهذا المرضُ هو إنفلُونزا الطُّيور h5 n1)) .
وقد عرفَ الإنسانُ مرضَ الإنفلُونزا باسمِ (الكريبِ أو الرّشحِ أو الزّكام) الّذي لم يكنْ مرضاً خطيراً؛ لأنّه سرعانَ ما يَختفِي، ويَنتهي بتناولِ الفيتامين (سِي) الّذي يَكثرُ وجودُه في اللّيمونِ وغيرِه، أو باستخدامِه في أقراصٍ دوائيّة، ويُعرفُ المصابونَ بهذا المرضِ الفصليِّ الّذي – غالباً- ما ينتشرُ في فصلِ الشّتاءِ، بعلاماتٍ تدلُّ على إصابتِهم به، كالعطسِ المتكرّرِ، وسيَلانِ الأنفِ، وتغيُّرِ طبقةِ الصّوتِ، والخمولِ.
أمّا إنفلُونزا الطُّيورِ، فمرضٌ حديثُ العهدِ ابتلَى به اللهُ مجتمعَ الطُّيورِ، وهو أعظمُ بلاءٍ يحلُّ به، منذُ أن خلقَ اللهُ أوّلَ طائرٍ في الفضاءِ؛ لأنّه يفاجئُ فرائسَه من الطُّيورِ الأخرى بالعَدْوى، ولم يقتصرْ خطرُه على الطّيور فحسبُ، بل امتدَّ ليشملَ البشرَ بإصابتِهم به، وعدمِ منحِهم فرصةً واحدةً للنّجاةِ؛ لأنّه صار وباءً قاتلاً، لا دواءَ له، وليسَ له علاماتٌ تدلُّ عليه لاتّقاءِ شرّه، وليس بالإمكانِ التّصدّي لغزوِه بشتّى حصونِ الفيتاميناتِ والمضادّاتِ الحيويّةِ وغيرِها.
وهكذا عمَّ البلاءُ على جميعِ الكائناتِ في الكونِ، فحلَّتْ بها الأوبئةُ والأمراضُ الّتي باتتْ تحصدُ أرواحَ الملايينِ من البشرِ سنويّاً، والملايينِ من أرواحِ الحيواناتِ والطّيورِ، وربّما عشراتِ الملايينِ من كائناتٍ أُخرى، ولولا فسادُ الإنسانِ في الأرضِ والطّبيعةِ والكونِ، عاشتِ الدّنيا بخيرٍ، وعاشَ الكونُ بسلامٍ.
لقد جنتْ يدُ الإنسانِ الطّاغي على البشريّةِ بأسرِها، فاستعرَت نيرانُ الحقدِ البشريِّ على الجنسِ البشريِّ، فقامتِ الحروبُ الاستعماريّةُ والسّياسيّةُ والقبليّةُ والهمجيّةُ واللّا أخلاقيّةُ، فحصدتْ ملايينَ الأرواحِ البريئةِ، وجنتْ على جميعِ كائناتِ الكونِ من حيوانيّةٍ ونباتيّةٍ، ودمّرتْ كلَّ معالمِ الجمالِ والصَّفاءِ والطّهارةِ والنَّقاءِ.
الشارقة في 15/12/2012
Recommend0 هل أعجبك؟نشرت في مشاركات الأعضاء
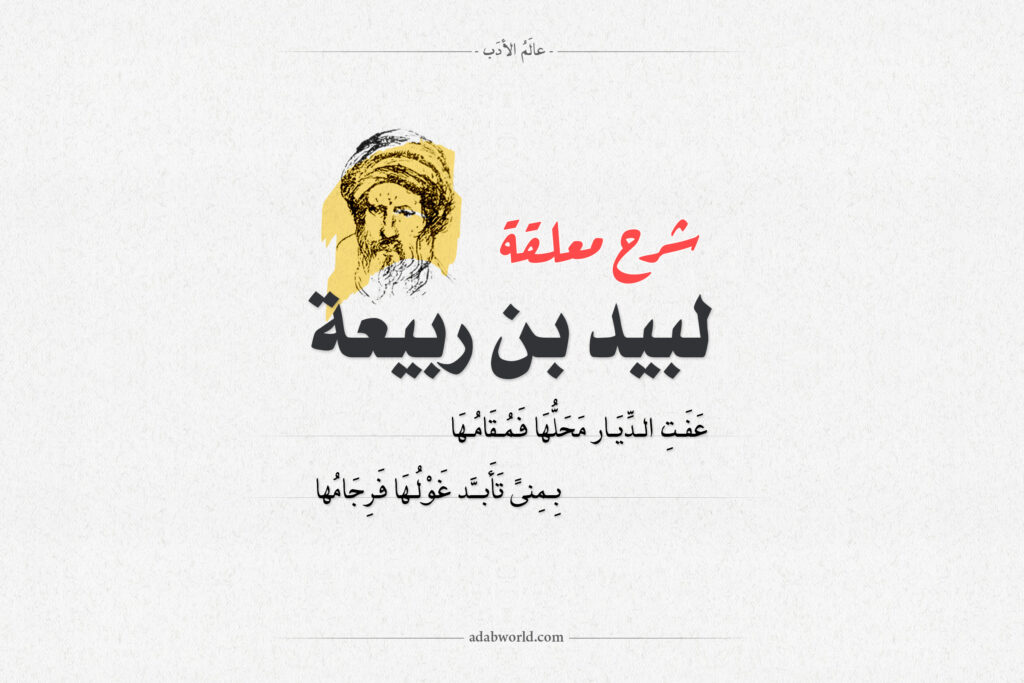
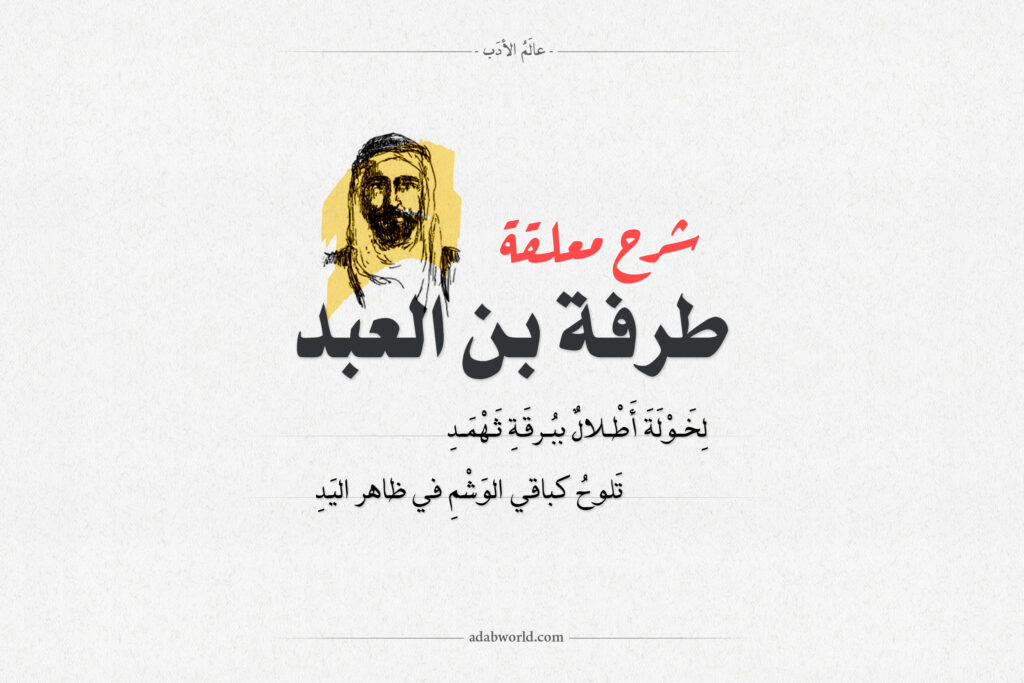
تعليقات