صراعُ الأضداد- الوطنُ والغربةُ -2
5- الوطنُ والحرّيّة
لا شكَّ في أنَّ الوطنَ الحرَّ هو منبعُ سعادةِ ومحبّة وطمأنينةِ وإبداعِ كلِّ مَن يتنفَّسُ نسائمَ الحرّيّةِ في وطنه، ولا شكَّ في أنّ كلَّ وطنٍ مستباحٍ هو نهرٌ آسنٌ ملوّث بقاذوراتِ الشّقاء والبغضِ والقلق والجهلِ، فليس ثمّةَ سعادةٌ حقيقيّةٌ للفرد إلّا في ظلالِ وطنٍ حرّ أبيّ، كما عبّر عن ذلك الزّعيمُ السَّمرقنديّ الأوزباكستانيّ إسلامُ كريموف بعد استقلالِ بلادِه من قبضةِ دكتاتوريّة واحتلالِ الإمبراطوريّةِ السّوفييتيّة الّتي ولّت إلى مزبلةِ التّاريخ على أيدي المجاهدينَ الأفغانِ الأشاوس: “لا تُوجَد سعادةٌ بالنّسبة لي أكثرَ من حرّيّةِ موطني”.
ولا شكَّ كذلك في أنّ الوطنَ الحرَّ الأبيّ حينَما يداهمُه خطرٌ خارجيّ يهدِّدُ أمنَه وحرّيَّتَه وسلامتَه، فإنّ كلَّ أبنائِه جنودٌ للذَّودِ عن حياضِه، على نحوِ ما نرى في قولِ الكاتبِ الفرنسيّ جاين لاكورداير: “عندما يكونُ الوطنُ في خطرٍ فكلُّ أبنائِه جنودٌ”.
ولكنْ من السّخريةِ بمكانٍ أن تجدَ روائيّاً عربيّاً يُؤثِرُ سجنَ الوطنِ على حرّيّةِ المنفى حين يقول: “سجنُ الوطنِ ولا حرّيّةُ المنفى!”. ولا سيَما في وطنٍ عربيّ لا يتمتَّعُ فيه بحرّيّةِ النّشرِ سوى فئةِ “النّجّارين” كما عبّر عن ذلك شاعرُ الحرّيّةِ والتّمرُّد أحمد مطر.
ولكنّني أرى أنّ الفئاتِ الّتي تتمتَّعُ بحرّيّةِ “النّشرِ” كثيرةٌ وعديدة: فالبنوكُ الرّبويّةُ بشتّى أصنافِها وألوانها، والمؤسَّساتُ الخِدميّة بمختلفِ مشاربِها وأجناسِها بارعةٌ في النّشر حينَ تنشرُ الجيوبَ نشراً، فتحرمُها من دفءِ فلسٍ يُحتَضرُ قبلَ بلوغِ اللّيالي العشرِ الأوائلِ من الشَّهرِ الحرام.. والمحامُون المهرةُ “ينشرون” الحقوقَ والأموالَ بمنشارٍ ذي حدَّين، والأطبَّاءُ العباقرة ينشرُون الكِلْيةَ السَّليمةَ بدلَ الكِليةِ المعطوبةِ والأعصابَ الصّالحةَ بدل الأعصابِ الطّالحة، والأصابعَ المتحرّكةَ بدلَ الأصابعِ الصّامتة، والخصيةَ الّتي ما تزالُ عامرةً بالحيواناتِ البشريّة بدلَ الخصيةِ الّتي فقدَت الأملَ بالحياة!
ولا ننْسى حرّيّةَ نشرِ الصيدليَّات، والحوانيتِ ومراكزِ التَّسوُّق والدِّعاية، وبلاهةَ الكثيرِ من المغنّينَ الصّاعدينَ في نشرِ المقياسِ الأوبّرالي لصوتِ الحمير الطّبيعيّ، وتفاهةَ الخلعاءِ في نشرِ غسيل أوساخِهم على حبالِ وسائلِ التّواصلِ الاجتماعيّ، وحقارةَ وسائلِ الإعلام الرّسميّةِ الّتي تنشرُ عقولَ الجهلَةِ والمغفَّلين نشراً يجعلُهم هُبْلاً خُبْلاً، ولا يمكنُ للذّاكرةِ أن تَنسى همجيَّةَ نشرِ القصَّابين للحيواناتِ المسكينةِ المغلوبةِ على أمرِها، ودمويَّةَ الجزّارين السَّايكوباثيّين في نشرِ أعضاءِ ضحاياهُم من البشرِ في زنزاناتِ وسجون الدّكتاتورِ السّفّاح!
فهناك مساحةٌ كبيرةٌ من الحرّيّةِ في أنواع النّشرِ الّتي ذكرتُها، ولكنَّ المساحةَ المتاحةَ للكتّاب حقيرةٌ جدّاً، ولا تكادُ الكمّيّةُ المعطاةُ من الحرّيّة في الوطنِ العربيّ تكفي كاتباً واحداً، كما في رأيِ الكاتبِ المسرحيِّ والرّوائيّ يوسف إدريس.
وأيُّ عقلٍ يقبل الوطنَ جهلاً، ويأبى الوعيَ منفىً؟! وأيُّ وعيٍ حقيقيّ يرضى بأسْرِ نجومِ السّماء وتقييدِ الفلكِ باسمِ إلهٍ أرضيّ مصطنعٍ، والسّماءُ بكلِّ ما فيها من كواكبَ هي موطنٌ لا يملكُه إلّا كلُّ حرّ أبيّ، كما عبّر عن ذلك الكاتبُ العربيّ الكبير مصطفى صادق الرّافعيّ:
ويكَ مــــــن رامَ تقيــــــيـــــدَ الفـــــــــــلَكْ أيُّ نجمٍ في السَّما يسْطعُ لكْ؟
وطــــــــنُ الحـــــــــــــــرِّ ســـــماً لا تُمـــــتلَكْ والفَــــــــــتى الحُـــــــــــــــرُّ بأفْــــــــــقِه ملَــــكْ
6- الوطنُ والتَّشرُّد
قد تكون الغربةُ طلباً لرزقٍ أو مجدٍ أو حبّا بالتَّغرُّب بعد مللِ المقام، أمّا التّشرُّدُ فقسريٌّ ناتجٌ عن احتلالٍ أو طغيان واستبدادٍ أو حروبٍ ظالمة اختلط فيها الحابلُ بالنّابل، فاشتبكَت العشائرُ بالقبائل وتطاحنَ فيها النّاسُ لأتفهِ المسائل، وهنا يعيش المشرّدون مرارةَ الهجرةِ إن وصلُوا بسلامٍ إلى مَواطنِ العالمِ الّتي تستقبلُ المهجَّرين، ومن كان مصيرُه الهلاكَ فقد ابتلعَتهُ أمواجُ البحر، أو أكلَتْه الوحوشُ والكلاب، أو انهالَت عليه كوارثُ الزّلازل، فطحنَتهُ فجائعُ الوطن وأتمَّتْ عليه كوارثُ المِحن.
فها هو الشّاعرُ الكبير محمود درويش يشبِّهُ وطنَه فلسطينَ بحقيبةٍ كحقيبةِ الغجر ليس لهم وطنٌ إلّا في الارتحالِ يحملُون وطنَهم في خيمةٍ، وينتقلُون بها من مكانٍ إلى آخرَ بحثاً عن مكانٍ آمن يوقِدون فيه النّارَ ويُنشدون الأغانيَ والأشعار، ولكنّهم لا يجِدون إلّا موطناً محاصراً بين شظايا الحروبِ وعواصفِ الأمطار: “وطني حقيبةٌ وحقيبتي وطنُ الغجرْ.. شعبٌ يخيّمُ في الأغاني والدُّخان.. شعبٌ يفتّشُ عن مكانٍ بين الشّظايا والمطرْ”. ويمضي عامٌ ويأتي آخرُ ووطنُه الفلسطينيّ يزدادُ سوءاً وضياعاً وفجرُ الخلاص يزداد بعداً: “عامٌ يذهب وآخرُ يأتي وكلُّ شيءٍ فيك يزدادُ سوءاً يا وطني”. وحينها يضيعُ الإنسانُ ويضيعُ الوطن، فلا يدري مَن الّذي هاجر الشّعبُ المشرَّدُ أمِ الوطنُ؟!
وثمّةَ تشرُّدٌ يعاني من ظلمِه المفكّرون المشرَّدونَ في بقاعِ الأرض بسببِ القمع، فتسوَدُّ الدّنيا في عينِ الأديبِ والمفكّر، ويغدو الوطنُ وهماً كبيراً يقابلُه الكاتبُ بالحبِّ والعطاء، فيكافِئُه بالقمعِ والتّشرُّد، ويراه جنّةً موعودة، لكنّ طغاتَه يصرُّون على تحويلِه إلى زنزانةٍ، كما في كلماتِ الرّوائيّ العربيّ الكبير عبدِ الرّحمن مُنيف: “الوطنُ وهمٌ كبير عندَما نقابلُه بالحبِّ والعطاء، ويقابلُنا بالقمعِ والتّشرُّد.. عندما نراهُ جنّةً موعودةً ويصرُّون على أن يحوّلُوه إلى زنزانةٍ كبيرة”. ولا يمكنُ لإنسانٍ عاقل أن يهجرَ وطنَه إلّا إذا تخلّى وطنُه عنه، كما في قولِ وارسان شاير: “تتركُ وطنكَ فقط حين ﻻ يتركُ لكَ الوطنُ مجالاً للبقاء”.
7- الوطنُ والضّياع
حينَ تغيبُ عن الوطنِ قيمُ الحقّ والعدالةِ والمساواةِ والحرّيّة، يعيش الإنسانُ في حالةٍ من الضّياع، لا يعرفُ أين وكيف يستقرُّ به المقامُ، فثمّةَ وشائجُ نفسيّةٌ تشدُّه للبقاء، وثمّةَ دوافعُ تشتِّتُ فكرَه وتقذفُه للبحث عن وطنٍ بديل، وبين الجذبِ والنُّفور يعيش الإنسانُ في قهرٍ وتشرُّدٍ وضياع.
فها هو شاعرُنا الكبير نزار قبّاني يعبّر عن هذه الحالةِ المأساويَّة التي يعيشُها الشّاعرُ، فيتساءل: “لا يعرفُ الإنسانُ كيف يعيشُ في هذا الوطن.. لا يعرف الإنسانُ كيف يموتُ في هذا الوطن؟!”.
وفي خضمِّ هذا الضّياعِ يقفُ الأديبُ عاجزاً عن وصفِ ما آلَ إليه الوطنُ من يأسٍ وحرمان وتقهقرٍ نتيجةَ تكالبِ الذّئاب والوحوشِ، وكأنّه غابةٌ، فهي تتضوّرُ جوعاً لافتراسِ الموارد والضَّحايا من الأبرياء، فلا أملَ في الخلاص ليتَعافى هذا الوطنُ، وكأنّه دخل سنَّ الشّيخوخةِ واليأس، فكلُّ شيءٍ قد تبدّل، فتغيّر النّاسُ وضاعتِ الأهدافُ، فضاع الوطنُ.. وأصبح كلُّ شيءٍ ممكناً في ذلك الوطنِ، فمِن فوقِ قبورِ الموتى تُعْقدُ صفقاتُ الكبارِ لبيع مقدَّراتِ الأمّة، وأصبح النّاسُ البسطاء أضاحيَ تُقدَّم قرابينَ رخيصةً تحت أقدامِ المتحكمّينَ بمصيره، فلم يبقَ أمام الأحياءِ، وهم أشبهُ بالموتى، إلّا الوقوفُ في طوابيرَ أمام القنصليّاتِ الأجنبيّة للحصول على تأشيرةِ حياةٍ خارجَ أسوارِ الوطنِ الجريح المستباحِ..
وأمام هذا التّشرذُمِ وغيابِ الإحساسِ الوطنيّ، يُضطرُّ المواطنون إلى الاستنجادِ بمحتلٍّ أجنبيّ بل باحتلالاتٍ عديدةٍ كي يُخلّصوا وطنَهم من طاغيةٍ سفّاح يأبى السُّقوطَ أو الرّحيل، فيستعينُ الطّاغيةُ بكلِّ مرتزقةِ العالم وقطّاعِ الطّرق؛ كي ينجوَ بنفسِه وعرشِه ولو كلَّفهُ ذلكَ تدميرَ الوطنِ برمَّتِه ورهنَ ما تبقّى من أشلائِه المبعثرةِ لقمةً سائغةً رخيصة للّصوصِ والغُزاة.. كما عبّرت الكاتبةُ الجزائريّةُ المبدعة أحلام مستغانمي عن هذه الحالِ بكلماتٍ تحمل في طيّاتها همومَ الإنسانِ والوطنِ: “تراني أنا الّذي أدخلُ الشّيخوخةَ.. أم ترى الوطنَ بأكملِه هو الّذي يدخل اليومَ سنَّ اليأسِ الجماعيّ؟ بين أوّلِ رصاصةٍ، وآخر رصاصةٍ، تغيّرتِ الصُّدورُ، وتغيّرت الأهدافُ، وتغيّر الوطنُ. كلُّ شيءٍ ممكنٌ في وطنٍ من فوقِ قبورِه تُبْرم صفقاتُ الكِبار، وتحت نعالِ المتحكِّمين بمصيرِه يموتُ السُّذَّجُ الصّغار.. أمام كلِّ القنصليّاتِ الأجنبيّة تقف طوابيرُ موتانا، تطالبُ بتأشيرةِ حياةٍ خارجَ حدودِ الوطن.. لنَنْجوَ من طاغيةٍ، نستنجدُ دوماً بمحتلٍّ، فيستنجدُ بدورِه بقطّاعِ طرقِ التّاريخ، ويسلِّمُهم الوطنَ..”.
وأمام هذا الضّياعِ والانحطاط والتَّخلُّفِ وغيابِ الحرّيّةِ والكرامة يطالبُ الأديبُ والمفكّر الوطنَ برفعِ جميع القيودِ والحواجز الّتي تطغى على حرّيّةِ المواطن وكرامتِه؛ كي يعيشَ حرّاً كريماً منتصبَ القامةِ، مرفوعَ الهامة، فما أكثرَ الأوطانَ الّتي ترفع شعاراتِ الزّيفِ والعار، فيبدأُ فيها سجنُ الإنسان بالنّشيدِ الوطنيّ، كما عبّر عن ذلك الكاتبُ الكبير أدونيس: ” أيُّها الوطنُ ارفعْ سقفَك كي أستطيعَ أن أرفعَ رأسي تحتَه.. ما أكثرَ الأوطانَ الّتي يبدأ فيها سجنُ المواطنينَ بالنّشيدِ الوطنيّ!”.
ومن أساليبِ المتاجرةِ بالوطن وبالإنسانِ الّتي يمارسُها الطغاةُ فيضيعُ الوطنُ ويموت الإنسانُ، أنّهم “يُلخِّصُون الوطنَ في قانونٍ.. يضعُون القانونَ في علبةٍ.. ثمّ يضعون العلبةَ في جيوبِهم!!” كما قال الرّوائيّ الأردنيّ جلال الخوالدة.
ومن حالات المفارقةِ العجيبة بين همومِ الإنسان الوطنيّ وبين الرّجلِ السّياسيّ أنّ الأوّلَ “يفكّرُ بالأجيالِ القادمة، أمّا السّياسيُّ فيفكّرُ بالانتخاباتِ القادمة”. كما عبّر عن ذلك أميرُ البيانِ العربيّ شكيب أرسلان. وهذا الضّياعُ في القيمِ والمثُل الوطنيّةِ جعل “الخيانةَ لعِباً هذه الأيّامَ وغربةَ الوطنِ هوايةً إجباريّة. كما في قول الدّكتور محمّد رضا. وفي خضمّ ضياعِ الوطن بكلِّ مقدّراتِه نتيجةَ دكتاتورٍ فاسدٍ يختزلُ الوطنَ كلَّه ببناء تماثيلِه الزّائفة، فيهدمُ الإنسانَ في ذاتِ المواطن: “النّظامُ الدّكتاتوريُّ، قد يَبني التّماثيلَ في الوطن، لكنّه يهدمُ الإنسانَ في المواطن”. حسبَ ما يرى الشّاعرُ الفلسطينيُّ سميح القاسم.
ويقول الشّاعرُ المصريُّ فاروق جُويدة معبّراً عن ضياعِ أمجاد الأمّةِ العظيمة الغابرةِ، فضاع الإنسانُ والوطن، فلا يُجْدي البكاءُ بعد أن ماتَتِ العزائمُ وتمزّق جسدُها الكاملُ إلى أشلاءَ مبتورةٍ، ومن شدّةِ حرقةِ الدّموع ماتتِ المقَلُ:
ﻧَﺒْﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻣّــــــــــــــﺔٍ ﻣـــــــــــﺎﺗَﺖْ ﻋـــــــــــــــﺰﺍﺋِﻤُﻬﺎ ﻭﻓــــــــــــﻮﻕَ ﺃﺷْـــــــــــﻼﺋِﻬﺎ ﺗﺴـــــــــــﺎﻗﻂَ ﺍﻟﻌِـــﻠلُ
هل ينفعُ الدَّمعُ بعدَ اليومِ في وطنٍ من حرقةِ الدَّمعِ ما عـادَت لهُ مُقَـلُ
وأمامَ ضياعِ أمجاد الأمّةِ العظيمة الّتي تحوَّلَت إلى وطنٍ جريحٍ يئنُّ تحتَ وطأةِ الانكسارِ والهزيمة، يعبّرُ الشّاعرُ عن حزنِه الّذي ما حلَّ به نتيجةَ ضياعِ سنينَ عمرِه، طال عمرُه أم قصُرَ، لكنّ حزنَه الحقيقيَّ كان على وطنِه الجريح وصرخةِ الحلم البريءِ الّذي ضاع ولم يرَ النّورَ:
أنَا مَــــــــــا حــزِنْتُ على سِنينِ العُمــــــــرِ طــــــــــالَ العُمــرُ عِنْــــــــــــدي أمْ قَصُــــــــــــــرْ
لكنَّ أَحْزاني على الوطنِ الجريحِ وصَرْخـــةِ الحُـــــــــلمِ البريءِ المنكسِرْ
وأمامَ حالةِ الضّياعِ الّتي يعيشُها الرّوائيُّ الجزائريُّ واسيني الأعرج، فلم يعدْ يشعرُ بوجودِه الحقيقيِّ في وطنٍ، فباتَت كلُّ الأماني أوهاماً وأضغاثَ أحلامٍ بعيدةً عن الواقعِ المرير، وعلى الإنسانِ في هذه الحالةِ أن يعلَمَ أنّه لا يملكُ من الوطنِ سوى بقعةِ أرضٍ يعيش فيها، وهذا السّبيلُ الوحيد للنّسيان: ” أشعر بأنّنا نملكُ الكثيرَ من الأوهامِ والأحلام في وطنٍ يحرمُنا من حقِّ الوجود.. عليكَ أن تملأَ قلبَكَ بأنْ لا وطنَ لديكَ إلّا الأرضُ الّتي تعيش فيها. هذا هو السّبيلُ الوحيد للنّسيان”. وهذا ما يدفعُه إلى الدّهشةِ والاستغرابِ حين يتساءل: “ما معنى الهُويّةِ في وطنٍ ليس لكَ؟”.
وفي غمرةِ ضياع وطنٍ يُستباحُ فيه كلُّ شيءٍ، ويتحوّل إلى سوقِ نخاسةٍ يُباع فيه الإنسانُ ويُشتَرى، فيغدُو الإنسانُ أرخصَ من ترابِ الوطن، كما عبّرتْ عن ذلك الكاتبةُ المصريّة سامية أحمد: “عندما يُستباحُ الوطنُ.. يُستباحُ كلُّ شيءٍ، وتصبحُ الدُّنيا سوقاً كبيرةً للنّخاسةِ فيه الإنسانُ أرخصُ من ترابِ الأرض”.
أمّا الكاتبُ والشّاعرُ السّوريّ السّاخر محمّد الماغوط، فلهُ فلسفةٌ خاصّة وطريقةٌ فريدةٌ في السُّخريةِ من وطنٍ عربيّ يتمنّى الإنسانُ فيهِ- بعد أن فقدَ كلَّ مقوّماتِ الوجودِ الإنسانيّ الحرِّ الكريم- أن يُسدِّدَ عليه الرّصاصَ بإحكامٍ من بندقيَّتِه السَّريعةِ الإطلاقِ الكاتمةِ للأنفاس، ولو مرّةً في العمر بطلقةٍ صائبة كي تريحَه من عذابِه وقهرِه: “أيُّها الوطنُ السّريعُ الطّلقاتِ والكاتمُ الأنفاسَ سدِّدْ بإحكامٍ! خذْني على محملِ الجدِّ ولو مرَّةً في العمر بطلقةٍ بائنةٍ”.
وهذا الوطنُ العربيّ الّذي يعيش فيه سكّانُه في صمتٍ مطبقٍ لا يحتاجُ إلى أجهزةِ تنصُّتٍ على مواطنيهِ في أيّ مكانٍ؛ “لأنّه في الأصلِ لا أحدَ يتكلّمُ”. وتبلغُ سخريةُ الماغوط ذروتَها من وطنِه الكبير الّذي أصبح يخالفُ جميعَ أوطانِ العالم الّتي تنامُ وتنام، وحين يدقُّ ناقوسُ الخطر تتأهّبُ للدّفاع عن نفسِها؛ أمّا الوطنُ العربيّ التّائهُ الحائر فهو في يقظةٍ تلو يقظةٍ وحينَما يداهمُه الخطرُ يخلدُ إلى النّوم: “يا إلهي، كلُّ الأوطانِ تنامُ وتنام، وفي اللّحظةِ الحاسمةِ تستيقظُ، إلّا الوطنُ العربيُّ فيستيقظُ ويستيقظُ، وفي اللّحظةِ الحاسمةِ ينام”. وهذا الوطنُ بكلّ ما في أرضِه وسماواتِه ومحيطاتِه ملكٌ لبضعةِ لصوصٍ.. فماذا ينتظرُ الإنسانُ العربيّ في وطنٍ لم يعدْ وطنَه؟!
8- الوطنُ والحدود
كلُّ أممِ الأرض الّتي تجمعُها روابطُ التّاريخِ واللُّغة والهويّةِ اجتمعَت في جسدٍ واحد، واتّحدَت في كيانٍ قوميّ كبير، وأصبحَت إمبراطوريّةً تفرضُ هيمنتَها وسطوتَها على العالم، إلّا الوطنُ العربيُّ الكبير الّذي تجمعُه من الرّوابطِ ما تفتقدُ إليها تلك الإمبراطوريّاتُ النّاشئة، ومع ذلكَ فقد تمزّق إلى أشلاءَ متناحرةٍ ضعيفة تنهشُها ذئابُ العالم.
والأمرُ المثير للجدلِ أنّ الأجنبيَّ يستطيع عبورَ كلِّ بلدانِ هذا الوطنِ العربيّ الكبير دونَ أن يحتاجَ لتأشيرةٍ واحدة، بينَما العربيُّ يحتاجُ لتأشيراتِ دخولٍ وخروجٍ بعددِ تلك الحدودِ الفاصلةِ بين دولةٍ وأخرى، كما يقولُ المفكّرُ والبرلمانيُّ البريطانيّ جورج غالوي: “من العجيبِ أنّني كبريطانيٍّ استطعتُ أن أعبرَ الوطنَ العربيَّ من شرقِه لغربِه دون أن أحتاجَ لتأشيرةٍ، بينَما يحتاج العربيُّ لتأشيرةٍ قد لا يحصلُ عليها لعبورِ تلك الحدودِ من دولةٍ عربيّةٍ لدولةٍ عربيّة”.
ولعلّ أبرعَ من عبّر عن سخطِه تجاهَ هذه الحدودِ المصطنعةِ بين بلدانِ العالمِ العربيّ هو الشّاعرُ الدّمشقيُّ الكبير نزار قبّاني في قصيدتِه (أنا يا صديقَتي مُتْعبٌ بعروبتي) الّتي يقولُ فيها:
هلْ في العُيونِ التُّونســيَّةِ شاطئٌ ترتاحُ فـــــــــوقَ رمالِــــــــــــهِ الأعصابُ؟
أنا يا صَــــــديقةُ مُتْعـــــــبٌ بعُــــــــروبتي فهلِ العُــــــــــروبةُ لعــــــــنةٌ وعِقــــــــــابُ؟
أَمْشي على ورقِ الخريطةِ خائفاً فعلَى الخـــــــــــريطةِ كلُّـــــــــــنا أَغْـــــــــــــرابُ
وخريطةُ الوطَنِ الكبيرِ فضِيحةٌ فحَــــواجِزٌ … ومخــــافِـــــــــرٌ … وكِلابُ
والعــــــــــالمُ العــــــربيُّ …. إمّــــا نَعْجةٌ مذبُـــــــوحَــــــــــــةٌ أو حـــــــــــــاكِمٌ قصَّـــــــــــــابُ
والعــــــــــــالمُ العــــــــربيُّ يرهُــــنُ سيفَهُ فحِكايةُ الشَّــــــــــرفِ الرَّفيعِ سَـــرابُ
9- الوطنُ والنّاس
لولا البشرُ ما قيمةُ الوطنِ، ولولا النّاسُ ما قيمةُ الحاكمِ ولو كان ملاكاً، وما قيمةُ الدّكتاتُور لولا الرَّعيّةُ الّتي يقودُها كالماشيةِ، فالنّاسُ هم الوطنُ.. والنّاسُ هم الحاكمُ والمحكوم.. النّاسُ هم التّاريخُ وهم الحضارةُ، ولكنْ شتّانَ ما بين حاكمٍ عادل يسكنُ قلوبَ جماهيرِه وبين حاكمٍ مستبِدٍّ يسكن أحذيةَ لاعنيهِ، فالحاكمُ العادل وإنْ رحلَ يظلُّ ساكناً قلوبَ النّاس رحمةً ومحبّة، ويسجّلُ سيرتَه العطِرةَ في سجلِّ الخالدينَ، فقد انقضَى عهدُ الخليفتينِ العادلينِ عمرَ بنِ الخطّاب وعمرَ بن عبدِ العزيز رضيَ اللهُ عنهما، وظلّت سيرتُهما مدرسةً في الرّجولةِ والعدالةِ والنّزاهة.. وولّى زمنُ الفراعنةِ والقياصرةِ والأكاسرةِ، ولم يتركُوا في قلوبِ البشر غيرَ اللّعنةِ عليهم، وغيرَ تاريخٍ أسودَ بات لعنةً على تاريخِ البشريّة.
والنّاسُ للنّاسِ، ومَن كان لغيرِ النّاسِ لعنتْهُ السّماءُ ولعنتهُ الأرضُ ومَن يعيشُ عليها، وبعضُ النّاس “كالوطنِ، إن غابُوا عنّا شعرْنا بالغربةِ”. كما قالَ الرّوائيُّ الكبير نجيب محفوظ.. والوطنُ عزيزٌ على أناسِه الشُّرفاء كما قالَ فولتير: “كم هو الوطنُ عزيزٌ على قلوبِ الشّرفاء!”. ولا يمكنُ لأحدٍ من هؤلاءِ الشّرفاء أن يرحلَ عن وطنِه “إلّا إذا كان الوطنُ فمَ قرشٍ”. كما يَرى وارسان شاير.
ولكنْ حينَ يتكالبُ النّاسُ على السُّلطةِ، تصبحُ القِلَّةُ القليلةُ حولَ الوطن، كما رأى الزّعيمُ الهنديُّ المهاتْما غاندي: “كثيرون حولَ السُّلطةِ، وقليلُون حولَ الوطن”.
وحين يصبحُ النَّاسُ رهينةً للحاكمِ المستبِدِّ فيعيشُون في فقرٍ وفاقةٍ، ولا يملكُون أدنى مقوّماتِ الحياة، تنقلبُ الصّورةُ فيعيشُ الأهلُ في الوطن غرباءَ، ويعيشُ الأبناءُ وطناً في الغربةِ، فينْسى النّاسُ خوفَهم على أبنائِهم، ويستبدُّ الخوفُ بالأبناءِ على ذويهم، كما عبّر عن ذلك الكاتبُ الرّوسي العبقريُّ فيودور دوستويفسكي: “انتهى الزّمنُ الّذي كان فيه أهلُنا يخافُون علَينا في الغربة.. وأصبحْنا نحن في غربتِنا نخافُ عليهم في الوطن”.
وقد يصلُ التّشاؤمُ بالنّاس- بسبب انتمائِهم إلى أمّةٍ تضحكُ من جهلِها الأممُ- إلى مرحلةِ السّخطِ والقنوط؛ لأنَّ الهويّةَ باتتْ لعنةً على أبنائِها، وقد عبّر عن ذلك شاعرُنا الكبير نزار قبّاني:
أنا يا صديقةُ متعبٌ بعروبتي فهلِ العــــروبةُ لعــــنةٌ وعقابُ؟
وكما في قولِ النّاشطِ آلان كيكي: “من أفضالِ جنسّيتِنا العربيّةِ.. أنّنا غرباءُ في كلِّ مكانٍ.. غرباءُ حتّى في الوطن”. وثمّةَ أقوالُ كثيرة تعبّر عن العلاقةِ بين النّاسِ والوطنِ وبين النّاسِ والنّاس في وطنٍ لا يكونُ جميلاً إلّا بهم.
ب- الغربةُ عن العالم
قد يشعر الإنسانُ بالغربة، ولا سيَما إذا كان مفكّراً أو أديباً، وتتنوّع هذه الغربةُ، فقد تكون غربةً نفسيّةً داخليّة، فيشعر الإنسانُ أنّه غريبٌ عن نفسِه حينما ينشأُ صراعٌ مميتٌ في الذّاتِ الإنسانيّة قد يدفعُه إلى نهايةٍ مأساويّة، وقد تكون هذه الغربةُ عن النّاس، فيعتزلُ الأديبُ أو المفكّر كلَّ وشائجِ التّواصل، ويعيش مع ذاتِه أو مكتبتِه أو ريشتِه، وقد تكون الغربةُ عن الوطن في أرضِه أو خارجِ حدودِه، وقد تكون غربةً عن العالم، وهي أشدُّ أنواع الغربةِ قسوةً على الإنسان.
فلنتأمّلْ غربةَ جبران خليل جبران عن هذا العالمِ حين لا يجدُ من يعرفُ كلمةً من لغةِ نفسِه: “أنا غريبٌ عن هذا العالمِ.. أنا غريبٌ وليس في الوجودِ مَن يعرفُ كلمةً من لغةِ نفسي”. وأمثالُ جبران كثرٌ في ميدانِ الفكر والأدبِ ممّن عاشوا في عزلةٍ؛ لأنّهم كانوا غرباءَ على أزمانِهم.
ومثلُ هذه الغربةِ نلمسُها عند الإنسانِ المؤمن الحقيقيّ الّذي باع دنياهُ بآخرتِه، فلا يجزعُ من ذلِّ الدِّنيا ولا ينافسُ أهلَها في عزّ؛ لأنّ قناعتَه وإيمانَه ورضاهُ بما قسمَه اللهُ له لا تبالي بمحنةٍ في زالِ نعمةٍ، ولا تتشوّقُ إلى جاهٍ أو مال أو سلطانٍ، كما نرى في قولِ الحسن البصري: “إنّ المؤمنَ في الدّنيا غريبٌ لا يَجزعُ من ذلِها ولا يُنافسُ أهلَها في عزّها”.
ومثلُ هذه القناعةِ الرّاسخةِ والإيمانِ المطلَق نلمسُها في قولِ الفقيهِ ابن تيميةَ، فالإنسانُ المؤمنُ الّذي وطّنَ فؤادَه على محبّةِ الله قد سكنَ واطمأنّ واستراحَ من عناءِ الحياة، أمّا مَن وطّن قلبَه في الدّنيا والنّاسِ اشتدّ به القلقُ: “مَن وطّن قلبَه عند ربِّه سكنَ واستراح، ومن أرسلَه في النّاس اضطربَ واشتدَّ به القلقُ”.
ومثلُ هذه الغربةِ عن العالم نجدُه في المآلِ الّذي وصل إليهِ دينُ الحقِّ والهداية كما في حالةِ الإسلام، فإنّه بات بمؤمنِيه الحقيقيّينَ وقيمِه وسلوكيَّاتِه غريباً عن هذا العالم، كما في رأيِ محمّد المنسي قنديل: “الإسلامُ غريبٌ ونحن أكثرُ غربةً”.
Recommend0 هل أعجبك؟نشرت في مشاركات الأعضاء
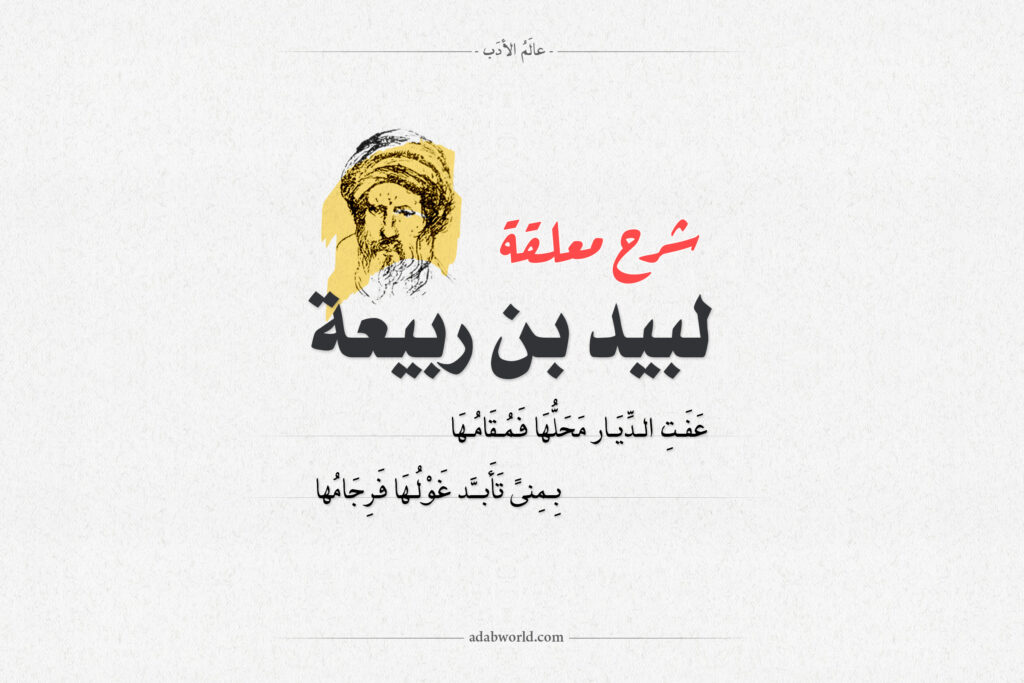
تعليقات