وداعاً (عامودا)
وكَما بدأْتُ رحلَتِي وأنا أخُوضُ معركةَ الحياةِ في عالمٍ جديدٍ، كانَ يَبدو لي – منذُ الوهلةِ الأُولى – عالماً غريباً كلَّ الغرابةِ، لكنَّ الأُلفةَ الّتي ربَطَتْ فؤادِي بأفئِدةِ ساكنِيهِ طردَتْ تلكَ الغُربةَ والغَرابةَ، وجعَلَتْني أشعرُ بأنَّني مِن سكَّانِهِ.
أمضيْتُ عاماً دراسيَّاً كامِلاً في هذهِ البلدةِ الجميلةِ (عامُودا) الّتي تقعُ في الجهةِ الشَّماليّةِ مِن سُوريا، ولعلَّ سرَّ حبِّي لها يَكمُنُ في مَهاراتي التَّدريسيَّةِ الّتي منَحتْني طاقةً ونشاطاً وحيَويَّةً، كمَا يَكمُنُ في مَرَحي وخِفَّة روحِي الّتي يشْهدُ لي بها جميعُ جُلسَائي وأصدِقَائي.
مضَى عامٌ كاملٌ وكأنَّه يومٌ أو يومانِ، لم أكنْ أشعرُ فيهِ بالغربةِ أو المللِ والضَّجرِ، كانتِ المدرسةُ الّتي أدرِّسُ فيها (إعداديةُ الشَّهيدِ سليم السّيَّد) مدرستِي ومَنزلي، حيثُ أدرِّسُ فيها طلاَّبَ الصفِّ الثَّالثِ الإعداديِّ، كمَا كانتْ مأوىً لي، حيثُ سكنْتُ في مكتَبتِها في فُسحةٍ صغيرةٍ خلفَ خزاناتِ الكتُبِ، وكانَ هَذا البيتُ يتألَّفُ مِن سريرٍ صغيرٍ وراءَ الخِزاناتِ وبعضِ المفروشاتِ البسيطةِ الّتي قدَّمَها لي طلاَّبي، وتلفازٍ وآلةِ تسجيلٍ، إضافةً إلى كتُبي الّتي تنتَبِذُ جانباً مِن رفُوفِ المكتبةِ.
أيَّامٌ ولحظَاتٌ رائعةٌ مضَتْ وكأنَّها حلُمٌ جميلٌ، إذْ كنْتُ أصعُدُ إلى الطَّابقِ الثَّاني منَ المدرسةِ بعدَما أَنْتَهي منَ الدَّوامِ الرَّسميِّ، وكأنّي أَملُكُ جامعةً في مَنزلي، ولم أكنْ أُعاني مَشقَّةَ سفرٍ أو مشقَّةَ التَّلوُّثِ بالأوحالِ المتراكمةِ في شوارعِ المدينةِ بعدَ هطولِ الأمطارِ، فكانَ السَّيرُ بضعةَ أمتارٍ خارجَ سُورِ المدرسةِ همَّاً كبيراً يُعاني منهُ الذَّاهبُون والعائِدونَ، في حينٍ كنْتُ أسيرُ تحتَ سقفِ المدرسةِ وأعيشُ فيها كلَّ أيَّامِي.
ما أجملَ ذلكَ المشهدَ الّذي كنتُ أرى فيهِ نفسِي سجينَ إرادَتي! كنتُ أُقفِلُ البابَ الرَّئيسيَّ عليَّ منَ الدَّاخلِ مثلَ سجينٍ يُودِعُ ذاتَهُ في قفَصِ الاتِّهامِ، ونفسُهُ مليئةٌ بالثِّقةِ والأملِ والتَّفاؤلِ؛ لأنَّهُ يَدْري أنَّهُ بريءٌ، وأنَّ العدالةَ لا تظلِمُه.
كانتْ ساحةُ المدرسةِ ملْعَبي الّذي أمارِسُ فيهِ الرِّياضةَ بأنواعِها المختلِفةِ: منْ هرولةٍ وتَمارينَ تكوينيَّةٍ وغيرِها.
لم تكُنْ هذهِ العُزلةُ داخلَ المدرسةِ لتَبعثَ على الملَلِ أو الضَّجرِ، بلْ كانتْ عُزلةَ النَّاسكِ الَّذي انعَكَفَ على نفسِه لاكتِشافِها وتأمُّلِ الكونِ والخلْقِ، وعُزلةَ الأديبِ الّذي قرَّرَ أنْ يَعتزلَ النَّاسَ؛ ليجِدَ سعادتَه ولذَّتَه في صفحَاتِ الكتُبِ المتنوِّعةِ، وعُزلةَ الباحثِ الّذي أعرضَ عن هُمومِ الحياةِ، وعزَمَ الإرادةَ لصقْلِ فكْرِه، وإنارةِ عقلِه ببحثٍ يَرْتقي بهِ سلَّمَ الحياةِ في المستقبلِ الآتي؛ ليَفرضَ نفسَه ووجودَه في كلِّ مَحافلِ المجتمعِ.
لكنَّ عُزلتي لم تكُنْ هروباً أو انطواءً أو أنانيَّةً، وإنَّما هي عزلةُ مَن يريدُ أن يُنجِزَ ما عزمَ عليهِ، ولم تكنْ لتخلُوَ من زيارةِ بعضِ الأصدقاءِ، وفي مقدِّمتِهم الشَّاعرُ جميلُ داري الّذي بَنيْتُ معهُ أمتنَ العلاقاتِ الأخويَّةِ، فاستَمرَّتْ صداقتُنا بكلِّ صدقٍ وإخلاصٍ معَ تلاقي الرُّوحِ والفكرِ.
ما أروعَ هؤلاءِ الأصدقاءَ الّذينَ عِشْتُ معَهم عيشةَ أسرةٍ واحِدةٍ، تَجمَعُنا رابطةُ الأُخوَّةِ والصَّداقةِ والمحبَّةِ والاحترامِ! أذكرُ منهمْ: مديرَ المدرسةِ الأستاذَ أحمد مَنْتَش (أبا راشد) الّذي يمتازُ بخفَّةِ روحِه ومزاجِه الجميلِ، وكنْتُ أزورُه في بيتِه، وتعرَّفتُ أسرتَه الطيِّبةَ، ومنهُم مُعاونُ المديرِ الأسمرُ محمود شيخو، والموجِّهون في المدرسـةِ: محمَّد مَهدي وسطّام، وأمينُ المختبرِ عبدُ الإلهِ العَالي، والصديقُ المثقَّفُ مدرِّسُ العلومِ محمَّد فيضُ الله الحامِديّ، والصَّديقُ الإدلبيُّ أحمدُ شيخُ الدَّانا، والأستاذُ حُسين نَعَامة منَ السَّاحلِ السُّوريِّ، والأستاذُ المضرِبُ عنِ الزَّواجِ إسماعيلُ الرَّاوي، وغيرُهم منَ المدرِّسين والمدرِّساتِ.
لم تكنِ المدرسةُ هي الملاذَ الوحيدَ الّذي أجِدُ فيهِ سعادَتي ومَرفأَ تَحقيقِ أُمْنياتي وطُموحَاتي، بلْ كانتْ أوقاتي المسائيَّةُ تتوزَّعُ فيها بينَ زيارةِ الأصدقاءِ وبينَ الرِّياضةِ، ثمَّ المطالعةِ، وما زلْتُ أذكرُ تلكَ التَّكيَّةَ الإسلاميَّةَ الّتي كانتْ تَأويْ كلَّ عابرِ سبيلٍ وكلَّ مَن أرادَ أن يكونَ ضيْفاً علَيها.
وما زلْتُ أذكرُ ذلكَ الوجْهَ الملائكيَّ المنيرَ صاحِبَ التكيَّةِ الشَّيخَ عبيدَ اللهِ القادريّ الّذي كنَّا نحضُرُ عندَه أحياناً حلَقاتِ الذِّكرِ، نُنشِدُ ونبتهلُ إلى اللهِ على منهجِ الصُّوفيَّةِ القادريَّةِ؛ حتَّى نصِلَ إلى ثُمالةِ النَّشوةِ الصوفيَّةِ بالذِّكْرِ والتَّهليلِ والتَّكبيرِ والأناشيدِ الدِّينيَّةِ.
كانتْ هذهِ التكيَّةُ مسْجداً تُقامُ فيهِ الصَّلاةُ وحلَقاتُ الذِّكرِ ودروسُ الطَّريقةِ القادريَّةِ، كمَا كانتْ مأوىً للضُّيوفِ وملْجأً لعابرِي السَّبيلِ ومَطْعماً لإقراءِ الطَّعامِ لكلِّ نُزلائِها.
وكان أبناءُ الشَّيخِ عبيدِ الله وأحفادُه يُديرون شؤونَ التَّكيَّةِ، ويُعامِلُون النُّزلاءَ والضُّيوفَ بكلِّ حفاوةٍ وكرمٍ ونُبلِ أخلاقٍ، وكانتْ هذهِ التَّكيَّةُ المفتاحَ السِّحريَّ الّذي فتحَ قلْبي للإيمانِ ونوَّره بنورِ الحقِّ والطَّاعةِ للهِ سبحانَه وتَعالى! فعكفْتُ على عبادةِ اللهِ، وامتلأتْ نفسِي بالتَّقْوى، وفاضَ فكري بمحبَّة اللهِ وتأمُّلِ آلائِه في الكونِ والإنسانِ.
وزادَ مَحبَّتي للإسلامِ والحضارةِ الإسلاميَّةِ، وازدَدْتُ إجلالاً لعلمائِها الأفاضلِ، وازدادَ تواضُعِي، ولانَتْ ورقَّتْ عواطفِي ومشاعرِي وازدادَ يَقيني بوحدانيَّةِ الخالقِ، وزالَ غُروري، فعكفْتُ على دراسةِ الحضارةِ الإسلاميَّةِ، وخرجْتُ بمُحاضراتٍ وندوَاتٍ لبيانِ تأثيرِها على الحضاراتِ الأخْرى في العالمِ.
كان المركزُ الثَّقافيُّ في عامُودا المنبرَ الّذي اجتَذبَني لإطلاقِ أفكارِي إلى عالمِ الوجودِ، فكنتُ كلَّ أسبوعٍ أُلقِي مُحاضرةً أمامَ الحاضرينَ حولَ الحضارةِ الإسلاميَّةِ، أو أُلقي الضَّوءَ على كتابٍ منَ الكتبِ عرْضاً وتَحليلاً ونقْداً. وامتدَّ نشاطيَ الثَّقافيُّ إلى منطقةِ مِصْيافَ الّتي ألقيْتُ في مركزِها الثَّقافيِّ محاضرةً عنِ الحضارةِ الإسلاميَّةِ وجوانبِ الإبداعِ فيها، وكانَ ممَّن شجَّعَني على ذلكَ الأخُ رفعَتْ عطْفَة مديرُ المركزِ الثَّقافيِّ الّذي يَحملُ شهادةَ الدُّكتوراه في الأدبِ الأندلسيِّ والإسبانيِّ، ويجيدُ الُّلغةَ الإسبانيَّةَ.
ولا زلْتُ أذكرُ مِن علماءِ عامُودا وشيوخِها: الشَّيخَ عفيفَ الحُسينيّ وأخاهُ الشَّيخَ سليمَ الحُسَيني الَّلذينِ كانا مرجِعينِ عظيمينِ في الفِقهِ والمذاهبِ الإسلاميَّةِ وفي التَّشريعِ والقانونِ والحِسْبةِ والأدبِ والنَّحوِ وغيرِ ذلكَ منَ العُلومِ.
كنتُ أزورُهما معَ بعضِ الأصدقاءِ ونَطرحُ عليهِما الأسئلةَ المتنوِّعةَ، وكانا رجلَينِ فاضلَينِ لا يأْلُوانِ جُهداً في تثقيفِ العقولِ وتنويرِ قلوبِ البشرِ.
كان بيتُ كلٍّ منهُما جامِعةً يقصِدُها الرَّاغبونَ في المعرفةِ والثَّقافةِ، ويَستَعيرونَ منها الكتبَ ويَقرؤونَ فيها ويبْحثُون، وكان الشَّيخُ عفيفٌ يَختبرُ بعضَ مدرِّسي الُّلغةِ العربيَّةِ ليكتَشِفَ مَقدرتَهم الأدبيَّةَ والُّلغويَّةَ.
وقدْ طرحَ عليَّ ذاتَ يومٍ مُعضِلةً لغويَّة في تفسيرِ وإعرابِ آيةٍ قرآنيَّةٍ، فلمْ أستَسلِمْ أمامَ اختِبارِه، بلْ حاولْتُ أنْ أجيبَ بمَا ملكَتْ ذاتُ يَدي، فلمَّا سمِعَ إجابتِي، سألَني:
o ماذا تدرسُ الآنَ؟
o فأجبْتُه: أحضِّرُ رسالةَ الماجستيرِ في البلاغةِ والنَّحوِ، وعنوانُ رسالَتي: (أسلوبُ القصْرِ في القرآنِ الكريمِ بين النَّحوِ والبلاغةِ).
أُعجِبَ الشَّيخُ الفاضلُ بقُدُراتي وطمُوحَاتي، وشجَّعَني على المثابرةِ، وعرضَ عليَّ كلَّ خِدماتِه ومساعداتِه، وكلَّما تأخَّرتُ في زيارتِه، كان يُرسلُ في طلَبي ويُحاورُني ويَطرحُ عليَّ الأسئلةَ، ويستَمعُ إلى إجاباتي.
لا أدريْ كيفَ أستطيعُ مكافأةَ هَذا الشَّيخِ العالمِ؟! ولا كيفَ أقدِّرُ أخاه الشَّيخَ سليمَ الحسينيَّ؟! وكلاهُما ذو فضلٍ كبيرٍ عليَّ وعلى الكثيرينَ!
أسئلةٌ جمَّةٌ كانتْ تدورُ في نفسِي! أليسَ هذانِ الرَّجلانِ العالمانِ شاهدينِ حيَّينِ على علماءِ ماضيْنا الأغرِّ الّذينَ قرأْنا عنهمُ الكثيرَ، وكنَّا نظنُّ أنَّنا نقرأُ أساطِيرَ الماضِي! أوليسَ منْ واجبِ المجتمعِ أنْ يرعَى هؤلاءِ وأمثالَهم، ويجعلَهُم نِبراساً عظيماً لأجيالِه؟ ولكنْ وا أسفاهُ على أمَّةٍ أصبحَ علماؤُها طيَّ الجدرانِ وهَباءَ النِّسيانِ، لا نَعرفُهم ولا نسمَعُ بهم إلّا لحظةَ رحيلِهم! يَعيشونَ ويَموتونَ مثلَ عامَّةِ النَّاسِ أو أدنَى، هَذا إنْ لم يكونُوا في زنزاناتٍ مُنفردةٍ في غياهِبِ الظُّلماتِ، لا يَدرِي بهم إِنسٌ ولا جانٌ!
أمَّا الدَّجَّالونَ والمنافقونَ والُّلقطَاءُ وقطَّاعُ الطُّرقِ، فتُقامُ لهم حفلاتُ التَّكريمِ، وتُطبِّلُ لهم الدُّنيا وتُرمِّزُ، وتُعْقدُ لهمُ النَّوادي، وتهتَمُّ بهِم كلُّ وسائلِ الإعلامِ؛ وكأنَّهم روَّادُ الحضارةِ وصنَّاعُ نهضةِ الأمَّةِ!
هَا أنا اليومَ أعودُ إلى عامُودا، لا لأُتابعَ مَسيرةَ حياتي هناكَ، وإنمَّا لأخْتُمَ رحلَتِي وأقولَ:
وداعاً يا عامُودا الجميلةُ!
وداعاً لشعبِكِ الطيِّبِ الكريمِ المعْطاءِ.
وداعاً يا تكيَّةَ القادريِّ.
وداعاً يا مساجِدَ عامُودا.
وداعاً يا شيوخَ وعلماءَ عامُودا.
وداعاً أيُّها المركزُ الثَّقافيُّ.
وداعاً يا أصدقائِي وزملائِي وزمِيلاتي.
وداعاً يا مدرسَتي.. يا بيتيَ الجميلَ وجامعَتي العزيزةَ.
وداعاً وقلْبيْ مشْحونٌ بلوعةِ الفِراقِ!
ولكنَّني لن أحزنَ طويلاً؛ لأنَّني حملْتُ معِي مُذكِّراتي وصُورِي الّتي تذكِّرُني بكلِّ ركنٍ من أركانِكِ يا عامُودا!
إنَّني عائدٌ إلى حيثُ أُقيمُ في قريتِي؛ لأتابعَ رحلتِي الدِّراسيَّةَ والحياتيَّةَ.. عائدٌ مثلَ طيرٍ هجرَ وَكْرَه؛ ليستقرَّ في ملاذِه الدَّائمِ، حيثُ الأهلُ والأحبَّةُ، وحيثُ مسقِطُ الرَّأسِ وتاريخُ طفولتِي وشَبابي.
وداعاً.. وألفُ وداعٍ، لكنَّني لنْ أنساكِ!
عامودا في 3\9\1995م
Recommend0 هل أعجبك؟نشرت في مشاركات الأعضاء
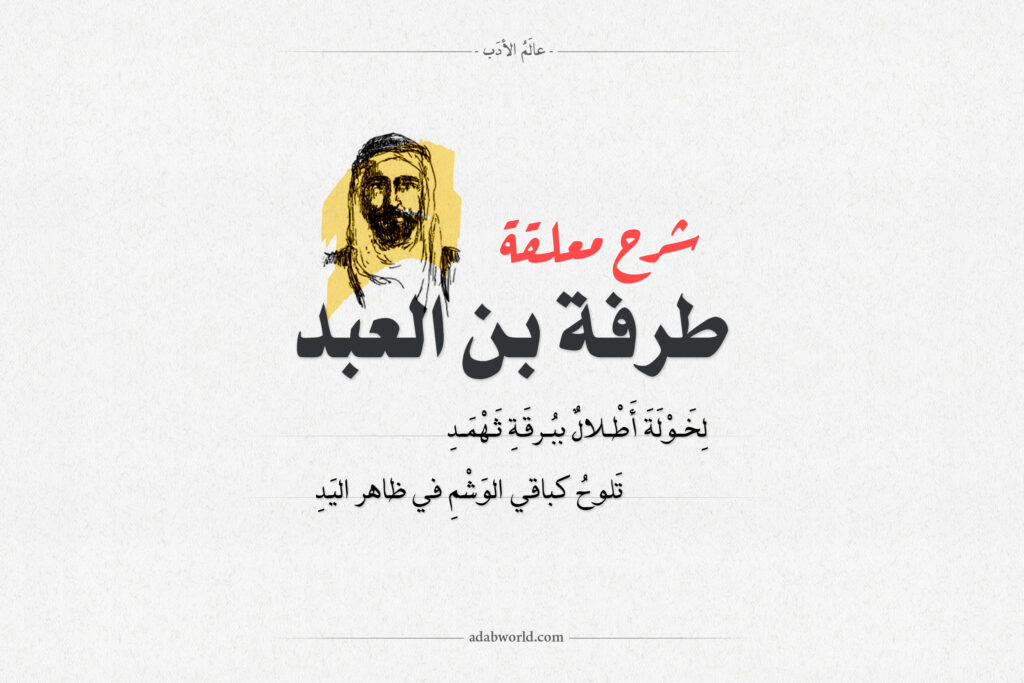
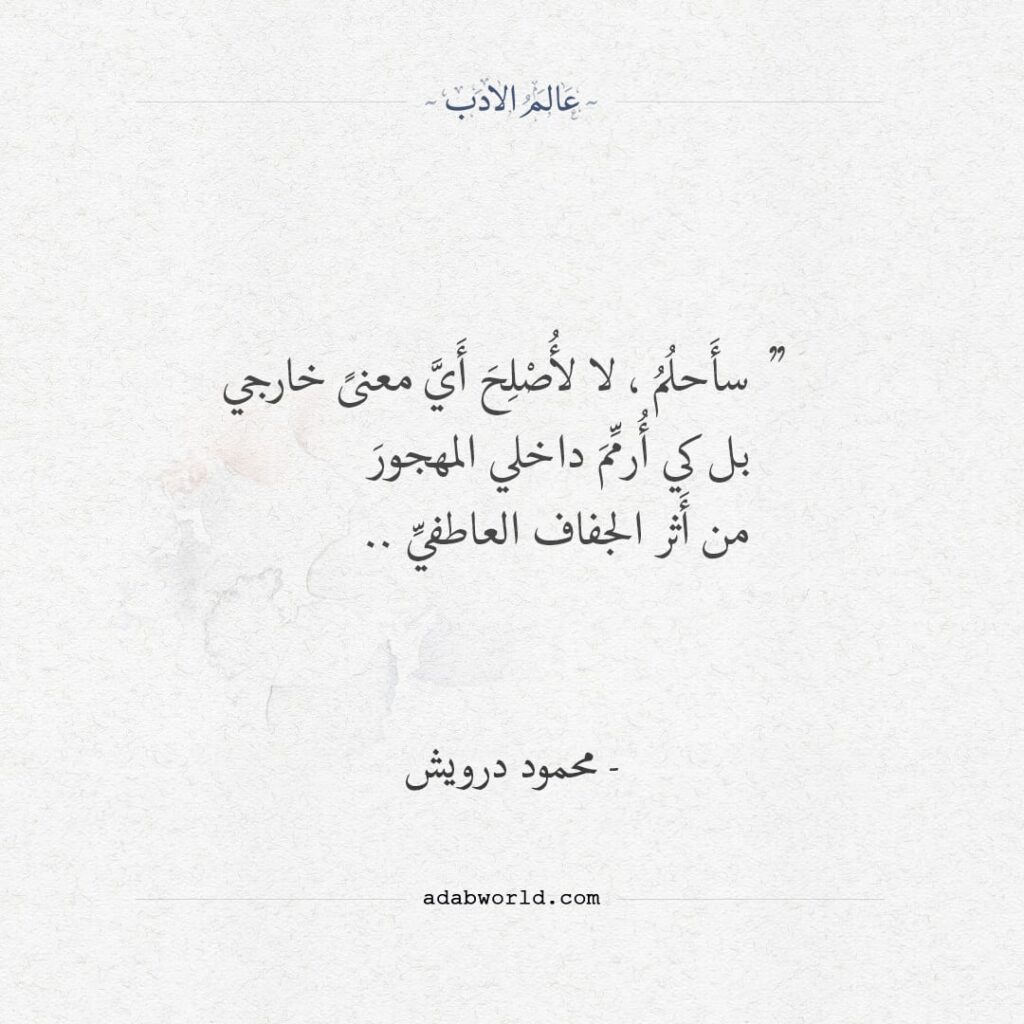
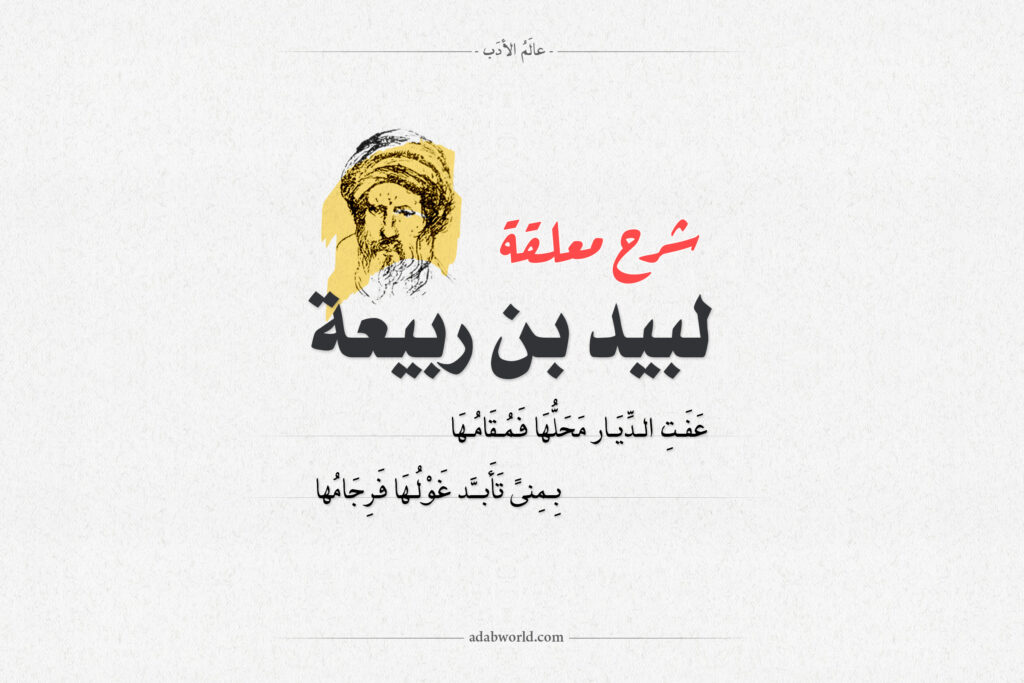
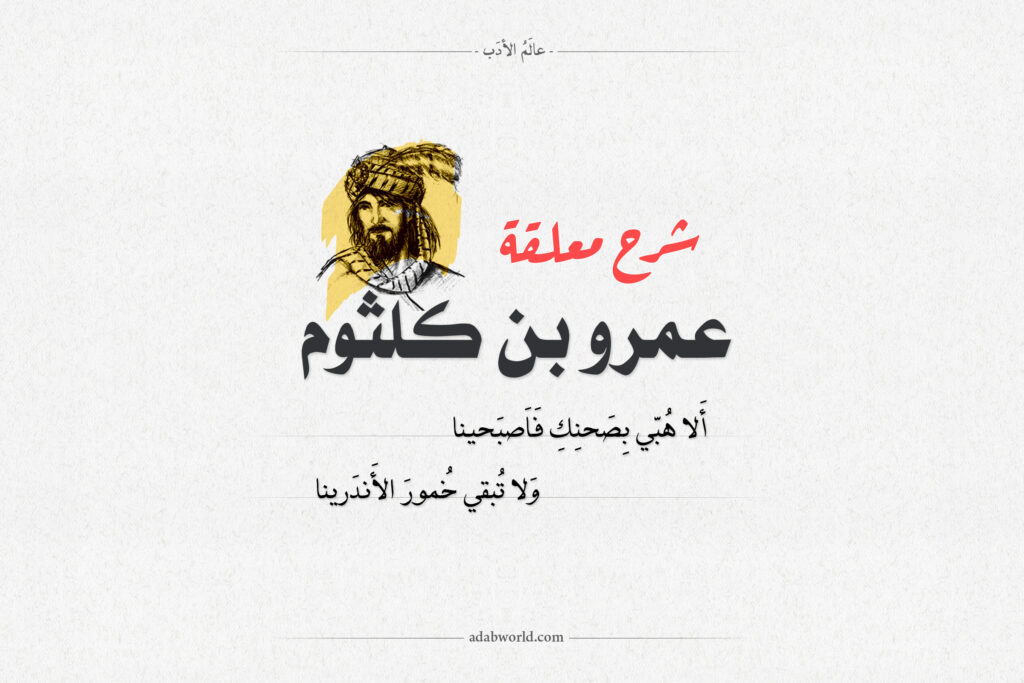
تعليقات