قامُوسُ العاجِزِينَ 1
لكلِّ كائنٍ في الوجودِ ثقافةٌ وفلسفةٌ خاصّةٌ، يتَّسِمُ بها كلُّ مخلوقٍ، ويَتَمايزُ من خلالِها عنْ غيرِه، فإذا نظرْنا إلى عناصرِ الوجودِ غيرِ الحيَّةِ، وتأمَّلْنَاها بإحساسِ الفلاسفةِ والمفكِّرينَ والأدباءِ؛ لأَدركْنَا أنَّ لكلٍّ مِنها فلسفةً خاصَّةً تُسيِّرُه في فلكِ الحركةِ والوجودِ.
فالشَّمسُ مِن يومِ أنْ أنشأَها اللهُ في الكونِ، لها ثقافتُها وفلسفتُها الّتي تُميِّزُها عن غيرِها منَ الكواكبِ؛ ففلسفتُها قائمةٌ على إضاءةِ الوجودِ بما فيهِ من كواكبَ، وما يَعمُّ فيهِ من غياهبِ الدَّيجورِ، وبعثِ الحرارةِ والحركةِ والنَّشاطِ في أوصالِ الكائناتِ، وهذا ديدنُها إلى أنْ تقومَ السَّاعةُ.
ولكنَّ الشَّمسَ لم تتَقاعَسْ ساعةً في أداءِ عملِها، وإنَّما تُؤدّي وظائفَها على أكملِ وجهٍ، دونَ تردُّدٍ أو تذمُّرٍ.
والقمرُ الّذي يستمِدُّ نورَه منَ الشَّمسِ لم يتَقاعسْ ليلةً عن أداءِ وظائفِهِ في إرسالِ أضوائِه المنعكِسَةِ عنِ الشَّمسِ إلى حَنايَا الكونِ المظلِمةِ، بل صارَ رمزاً للجمالِ والرُّومانسيَّةِ، تَغنَّى بهِ الشُّعراءُ في ساعاتِ هُيامِهم، والأدباءُ في هُنَيهاتِ إشراقةِ قرائحِهم.
وأجملُ ما في القمرِ أنّهُ يُوزِّعُ ابتساماتِه على الوجودِ بوجُوهٍ مختلِفةٍ، فمرَّةً يَبتسِمُ ابتسامةَ العاشقينَ، فيَظهرُ بدْراً أينَ مِن جمالِه فاتِناتُ باريسَ؟!
ومرَّةً يُخفِّفُ ابتسامتَهُ إلى ابتِسامةِ الحييِّ فيَبدُو هِلالاً، حتّى صارَ رمزاً للمُسلمينَ يَتغنَّونَ بهِ، ويرفعُونَه شعاراً يَرمزُ لدِينِهم الحنيفِ، وأكثرُ مِن ذلكَ أنَّهم ربطُوا تاريخَهم الهِجريَّ بهِ، وباتَ ظهورُه إيذاناً ببدايةِ الشَّهرِ، وتَوَاريهِ إيماءً بنهايتِه، وصارُوا يصُومُون ويُفطِرونَ لرؤيتِه، حسْبَ ما جاءَ في تعاليمِ الدِّينِ الحنيفِ.
ومرَّةً يَغيبُ عن شطرِ الوُجودِ؛ ليُعانقَ شطرَهُ الآخرَ، فيُودِّعُ حبيباً ليلْقاهُ في غايةِ اللَّهفةِ بعدَ المَغِيبِ، ويا لَروعةِ اللِّقاءِ! وهذا ديدنُه ودأْبُه طوالَ ليَالي السِّنينَ، ولم يُقصِّرْ في أداءِ واجبِه ساعةً من العمرِ.
وإذا مَا قدَّرَ اللهُ أنْ يَعتريَ النِّظامَ الكونيَّ تَغيُّرٌ طارئٌ، فتَرى الشَّمسَ قدْ عبسَتْ في وجهِ الوجودِ، وأخفَتْ خُيوطَها الذَّهبيَّةَ عنْ عيونِ الكائناتِ؛ وذلكَ إذا مَا اعتَرتْها حالةُ الكُسوفِ، وتَرى القمرَ قد شَحُبَ وجهُهُ في غُصَّةِ الحبيبِ، عندَما يَتَوارَى عنهُ المُحِبُّ؛ وذلكَ حينَما تتَصارعُ مشاعرُه في ظاهرةِ الخُسوفِ.
ولكنْ يا لَجمالِ وروعةِ الحبيبِ، عندَما تَعتَريهِ حالةٌ من العُبُوسِ أو هَيْنَمةٌ منَ التَّدلُّلِ والغُنْجِ الجميلِ.
ما أجْملَ الشَّمسَ حينَما تتذمَّرُ في خُسوفِها، وما ذلكَ إلّا إغْفَاءةُ المُحِبِّ على صدرِ الحبيبِ!
وما أرْوعَ القمرَ عندَما يَرْبدُّ في وجهِ الوجودِ اربِدادَ الحبيبةِ في وجهِ الحبيبِ عندَما يتأخَّرُ عن اللِّقاءِ، ثمَّ تَنفرِجُ منهُ الأساريرُ، وتذوبُ النَّفْسُ في النَّفسِ، والرُّوحُ في الرُّوحِ، وإكْسِيرُ الحياةِ في أنفاسِ الحبيبينِ حينَما يمتزِجُ الجسَدانِ في لقاءٍ غراميٍّ عفيفٍ!
أمَّا النُّجومُ الّتي لا يُحصِيها عَدٌّ، ولا تُحِيطُ بها أفْهامُ الجهابِذةِ العبقريِّينَ، فدَيْدنُها -منذُ ولادتِها إلى كنفِ الوجودِ – الإضاءةُ واللّألأَةُ، وقد جعلَها الخالِقُ- سبحانَه وتَعَالى- مصابيحَ، وزيَّنَ بها السَّماءَ، وما أرْوعَها من زينةٍ! فلا يَعتريْها فسادٌ، أو يُصيبُها نُحُولٌ أو شُحُوبٌ، ولم تَتَوانَ يوماً عن لأْلأَتِها، كمَا يَتَوانَى السِّراجُ، حينَما يَنْتهي فتيلُه أو يَخبُو زيتُه. وإذا هبَطْنا بالخيالِ من السَّماءِ إلى الأرضِ، وأطلَقْنا عينَ البَصِيرةِ والتَّأمُّلِ في عالمِ الوجودِ الجامِدِ والحيِّ؛ لأدركْنَا أنَّهُ عالمٌ لا يَعرِفُ للتَّذمُّرِ طعْماً، ولا للشَّكْوى لوناً، ولا للتَّقاعُسِ بارِقةً، بلْ دأْبُه الحركةُ والحيويَّةُ والنَّشاطُ.
فالبحرُ الّذي يَبتلِعُ ثلاثةَ أرباعِ الكرةِ الأرضِيَّةِ، ويَحتضِنُ في أحشائِه كائناتٍ لا يُحيطُ بها عَدٌّ ولا إحْصاءُ، وتختلِفُ أشكالاً وألواناً، لم تَعترِهِ لحظةٌ منَ الضَّعفِ أو حالةٌ منَ الشَّكْوىْ أو اليَأْسِ.
فمُنذُ أنْ أبدعَهُ اللهُ على صدرِ الوجودِ؛ ليكُونَ سبباً جوهريَّاً في استِمرارِ الوجودِ، لم تستقِرَّ أمعاؤُه منَ الحركةِ والصَّخَبِ، ولم يَسترِحْ هُنيْهةً من عَناءِ زمْجرةِ عُبَابِه المُتلاطِمِ في الأعماقِ وعلى خُدودِ الشُّطْآنِ، فهو عالمٌ من النَّشاطِ والحركةِ والحيويَّةِ والانبِعاثِ، تَأْبى أحشاؤُه الأجسادَ الهامِـدةَ، فتلْفِظُها إلى الشُّطْآنِ، لكنَّ هدوءَه في لحظاتٍ أُخْرى، ليسَ إلّا إغْفاءةَ التِّنِّينِ في قيلُولةِ الظَّهيرةِ، وليسَ إلّا أحلامَ يقظةٍ تمُرُّ في مخيِّلتِه، سُرعانَ ما يَنْتفِضُ من لذَّتِها، فيَهُوجُ معَ الرِّياحِ نافِضاً رذاذَ المياهِ عن رملِه، لافِظاً عباءةَ النَّومِ عن جُنُوبِه، باسِطاً عُنْفوانَ التَّحدِّي بكلِّ أطرافِه.
والهواءُ الَّذي يُعَدُّ العُنصرَ الأساسيَّ لعيشِ الكائناتِ يَمنحُها السَّعادةَ والهناءةَ والانتِعاشَ على مدارِ ساعاتِ العُمرِ، ولا يَتوانَى في العطاءِ، ولم يَشْكُ هُنيْهةً من هُنيهاتِ الحياةِ، ولم تَفْتُرَ له عزيمةٌ بالرَّغمِ من جرائمِ البشرِ الوحشيّينَ الّذينَ لوَّثُوه بشتَّى أنواعِ الملَوِّثاتِ والغازاتِ، بلْ أصرَّ على دوامِ البقاءِ؛ ليَمُدَّ الكائناتِ بأنفاسِ الحياةِ، لكنَّه لمْ يَركُنْ ولمْ يستسلِمْ لطُغيانِ الأيديْ الآثِمةِ الّتي تُشوِّهُ جمالَ الحياةِ، فسُرعانَ ما ارتعدَتْ فرائِصُه، واربدَّتْ سُحنتُه، وثارَ أُوارُ الغضبِ في أعماقِه، فتَحوَّلَ من حمَلٍ وديعٍ إلى بركانٍ ثائرٍ يقتلِعُ الأشجارَ والمزارعَ والحقولَ والخِيمَ، ويُثيرُ ثائِرةَ البحرِ؛ فيَمُدُّ أمواجَه، ويُعِيدُها كرَّاً وفرَّاً على أحضانِ اليابسةِ، ولا يتَوانَى في عزيمتِه إلى أنْ يَشفِي غليلَهُ من الأرضِ وممَّنْ عليها، فيُعلِّمُ المتجبِّرينَ درساً تُردِّدُ ذكْراهُ حكاياتُ الشُّعوبِ والأممِ.
وفي السَّماءِ تَجِدُّ الرّياحُ في نشرِ السُّحبِ في الفضاءِ، وتَحمِلُها وتتقاذفُها فوقَ القارّاتِ والدُّولِ، وتُهلِكُ الغمائمَ، فتَبْكي قطـراتٍ منَ الغيثِ المِدرارِ على صدرِ الطَّبيعةِ الحالمةِ بوصالِ حبَّاتِ المطرِ، فتَروِي الحقولَ والمزارعَ والبساتينَ والغاباتِ والصَّحَارَى والجبالَ والوِهادَ والوُديانَ، وتُسربِلُ الطَّبيعةَ جِلْباباً ناصِعاً منَ الخُضرةِ والنَّضارةِ والجمالِ، وتُحِيلُ صمْتَ الجداولِ والأنهارِ إلى خريرٍ يُوقِظُ الحُبَّ والسَّعادةَ والسُّرورَ في أكنافِ الطَّبيعةِ، وتَبْعثُ الأملَ والتَّفاؤلَ في نفوسِ الكائناتِ، فتَشْرئِبُّ لمعانقةِ جمالِ الحياةِ والانتِشاءِ من بهائِها الآسِرِ وإكْسِيرِها السَّادرِ إلى أنفاسِ الوجودِ.
ومظاهرُ الطَّبيعةِ والكونِ أكثرُ ممَّا تُعَدُّ أو تُحْصَى، ممّا يدلُّ على عبقريَّةِ الأداءِ والتَّحدِّي والصُّمودِ والمواظَبةِ والتَّفاني وعدمِ التَّخاذُلِ والتَّراجُعِ والتَّواني.
ولنَنْتقِلْ إلى عالمِ الأحياءِ؛ لنَرى لغةَ التَّحدِّي لا التَّردِّي، والتَّفاؤلَ لا التَّشاؤمَ، والإصرارَ لا التَّخاذُلَ، والإيمانَ لا الانهِزامَ، بأبْهى صُورِها وأنْقى حُللِها عندَ جميعِ الكائناتِ. ولكنْ نكتفِي بالكائناتِ الّتي هيَ علَمٌ على رأسِها نارٌ في أُنمُوذجِ ثقافةِ العزيمةِ لا الهزيمةِ.
فالنَّملُ – وهو من أصغرِ الكائناتِ الحيَّةِ – تتجلَّى عندَه ثقافةُ الاتِّحادِ والتَّعاونِ وتحدِّي العوائقِ، وعدمِ الاستِسْلامِ والخُنوعِ لتحدِّياتِ الطَّبيعةِ، يسْعى طَوالَ النَّهارِ لجمعِ الحَبِّ وتخزينِه في مخازِنَ تحتَ الأرضِ؛ ليَتغذَّى عليها شتاءً، وكلُّ نملَةٍ تُؤدِّي واجبَها، ولا تتَّكِئُ على الآخرينَ، أو تستغِلُّ جهودَهم لتستريحَ، وإنَّما الكلُّ مُتعاضِدٌ مُتآزِرٌ في مجتمعٍ حشريٍّ لا يَعرفُ الظُّلمَ والاستِبدادَ أو التَّفرقةَ والتَّمييزَ أو الحقدَ والكراهيةَ أو المُشاحَناتِ والمُناحراتِ.. الكلُّ يتَفانَى من أجلِ الكُلِّ، والجزءُ يَنْحلُّ في جسدِ الكُلِّ لتحقيقِ سعادتِه، والكلُّ يَذوبُ في الجزءِ من أجلِ رفاهيَّتِه. إنَّهم يمتلِكُون أجملَ مفرداتِ التَّعاونِ والإرادةِ والتَّحدِّي، ولا يَعرفُون طعْماً لثقافةِ الانهِزامِ والانكِسارِ أو التَّمزُّقِ والتَّشرذُمِ.
والنَّحلُ لهُ ثقافةٌ ذهبيَّةٌ في التَّنظيمِ وتوزيعِ المهامِّ والوظائفِ والإيثارِ، فالذُّكورُ تُفْني حياتَها، وتتَجرَّعُ كؤوسَ المنيَّةِ بعدَ أن تُؤدِّي واجبَها المقدَّسَ في تلقيحِ الملِكةِ الّتي تقومُ بدورِها بوضعِ البيضِ لإنتاجِ اليَرقاتِ، والعامِلاتُ يُؤدّينَ واجبَهنَّ في حراسةِ الخليَّةِ وجمعِ رحيقِ الأزهارِ، لكنَّنا لم نسمعْ عن تذمُّرِ نحْلةٍ إزاءَ واجبِها، ولم تتشاءَمْ واحدةٌ منَ النَّحلاتِ، ولم يَعتَرِهَا فتُورٌ، أو يُصِبْها خُمولٌ في القِيامِ بمَهَمَّاتِها الوظيفيَّةِ داخلَ الخليَّةِ أو خارجَها.
والطُّيورُ – على مختلِفِ أنواعِها- لا تَكُفُّ في دورةِ حياتِها عنِ البحثِ عن مصدرٍ آمِنٍ لعيشِها وسعادتِها، فهي تقْطعُ آلافَ الأميالِ عبرَ الدُّولِ والقارَّاتِ بحثاً عن الدِّفْءِ والشَّمسِ، أو البرودةِ والشِّتاءِ، حسْبَ طبيعةِ كلٍّ مِنها.
فالسُّنُونُو يتحَمَّلُ أعباءَ المسافاتِ البعيدةِ، وهو يبْحثُ عن دفءِ الرَّبيعِ وجمالِ الطَّبيعةِ والحياةِ، ولا يَتردَّدُ في البحثِ والاستِقْصاءِ، ولو هلَكَ على الدُّروبِ. والبلابِلُ تَرحَلُ عبرَ الفَيافي بحثاً عن أشِعَّةِ الشَّمسِ الذَّهبيَّةِ ورومانسيَّةِ الأجواءِ الرَّبيعيَّةِ؛ لتُغنِّيَ أجملَ وأعذبَ ألحانِها في أُنشُودةِ التَّلاقُحِ الحيويِّ بين الأحياءِ من جِهةٍ، وبينَها وبينَ عناصرِ جمالِ الطَّبيعةِ من ناحيةٍ أُخرى.
والزَّرازيرُ والسُّمَانَى والشَّحاريرُ وأبو الحِنَّاءِ وغيرُها كلُّ أولئكَ يتَحدَّى سَرابَ البُعْدِ، بحثاً عن لفحَاتِ البُرودةِ ونفحَاتِ حبَّاتِ المطرِ، في شِتاءٍ قارِسٍ تشتاقُ فيه عُيونُ الأحياءِ إلى خُيوطِ الشَّمسِ بين الغَمائِمِ السَّادِرةِ من السَّماءِ إلى ذُؤاباتِ الجِبالِ، الهابِطةِ على صدرِ السُّهولِ والوُديانِ، باسِطةً في أكنافِها ليلاً منَ الضَّبابِ وديْجُوراً منَ البهيميَّةِ والألغازِ والطَّلاسِمِ.
في الطَّبيعةِ والوُجودِ جبالٌ شاهِقاتٌ للتَّحدِّي والصُّمودِ، كلُّ كائنٍ حيٍّ أو قِطعةٌ من الجَمادِ نَقْرأُ في أسرارِها رواياتٍ من المعاناةِ والقُدرةِ على الصَّبرِ والتَّحمُّلِ، ولا تقعُ أفهامُنا على سطرٍ واحدٍ منَ الهزيمةِ والانكِسارِ، أو التَّراجُعِ والانهِيارِ، أو الشَّكْوى واليأسِ.
ولْنتأمَّلْ رويداً رويداً عالمَ إنسانِنا الحيِّ الّذي عِلَّةُ وجودِه عبادةُ الخالقِ عزَّ وجلَّ، وعِمارةُ الأرضِ، قالَ تعَالى: ﴿وما خَلَقْتُ الإنسَ والجِنَّ إلّا لِيعبُدونِ﴾. الآيةُ (56) من سورةِ (الذَّارياتِ).
وقالَ تعالَى أيضاً: ﴿إنَّا عرضْنا الأمانةَ على السَّمَواتِ والأرضِ والجبالِ فأبيْنَ أنْ يحمِلْنَها وأشفَقْنَ منها وحملَها الإنسانُ إنّه كانَ ظَلُوماً جَهُولَا﴾ الآيةُ (72) من سورةِ الأحزابِ.
ولكنْ هلْ حملَ الإنسانُ هذهِ الأمانةَ بأمانةٍ حقَّاً؟
نعمْ لقدْ حملَها بشرفٍ علماءُ البشرِ الّذينَ ضحَّوا بحياتِهم من أجلِ الوصولِ إلى حقيقةٍ علميَّةٍ أو اكتشافِ لُغزٍ من ألغازِ الطَّبيعةِ والكونِ، فكلُّ علماءِ الفيزياءِ والكيمياءِ والطَّبيعةِ والأحياءِ والرّياضيَّاتِ والهندسةِ والجَبرِ والفلَكِ والفضاءِ والذَّرّةِ والفلسفةِ وغيرِها، قدَّمُوا لنا أمثلةً وبراهينَ عظيمةً شحَنُوا بها قاموسَ التَّحدِّي والإرادةِ والتَّصميمِ بأبْهى المفْرداتِ وأنصعِ المعانِي.
وكلُّ نفرٍ من هَؤلاءِ العظماءِ ضحَّى بالغَالي والنَّفيسِ من الجُهدِ والمالِ والنَّفسِ من أجلِ حلِّ لغزٍ، أو فكِّ طلْسَمٍ، أو اكتشافِ حقيقةٍ ضامِرةٍ في سرابِ الوجُودِ، أو اختراعِ آلةٍ أو تِقْنيةٍ متطوِّرةٍ تخدمُ البشريَّةَ؛ وهُو إذْ ذاكَ قد عرَّضَ حياتَه للخطرِ أو الموتِ أو السَّجنِ، ولم يُبالِ بالعواقبِ، حتّى استطاعَ أن يقهرَ المجهولَ ويُطوِّعَه، ويكْبحَ جِماحَ أسرارِه تحتَ مِطْرقةِ فكرِه، وعلى سِندانِ إرادتِه وصبرِه وتضحِيتِه.
فمَن منَّا ينْسَى ما قدَّمَه علماءُ المسلمينَ من اكتشافاتٍ واختراعاتٍ وفلسفةٍ للعالمِ، ما زالتْ جامعاتُ الغربِ، وما زالَ علماؤُه يُكِنُّون لهم كلَّ إعجابٍ وتقديرٍ وعرفانٍ بالجميلِ، أمثالِ أبي بكرٍ الرَّازيّ وابنِ سِينا والخَوارِزْميّ وابنِ الهيثمِ وجابرِ بنِ حيَّانَ وابنِ رشدٍ وابنِ باجةَ وعبّاسِ بنِ فِرناسَ وغيرِهم الكثيرِ الكثيرِ.
ومَن مِنّا ينسَى ما قدَّمَه ويقدِّمُه اليومَ علماءُ الغربِ من دعائمَ حضاريَّةٍ لبناءِ النَّهضةِ والتَّطوُّرِ والإبداعِ في شتّى ميادينِ العلومِ والحياةِ، ونحنُ مَدِينُون لهُم، ونُكِنُّ لهم كلَّ الإعجابِ والتَّقديرِ والاعترافِ بالجميلِ، من أمثالِ: لافْوازيه وآينشْتايْن وداروين وأَرخَميدس وكريستُوف كولُومبُوس ولويس بريلْ ونُوبل وجان جاكْ روسُّو.
فهؤلاءِ العلماءُ والمفكِّرون والفلاسفةُ في الشَّرقِ والغربِ، أقامُوا صرحَ الحضارةِ على عصارةِ فكرِهم وعبقريّتِهم طَوداً شامِخاً تدينُ له كلُّ المخلوقاتِ الكونيَّةِ، وما زالتْ عبقريَّتُهم نبراساً تَهْتدي به كلُّ أفواجِ العلماءِ على مرِّ العصورِ، فمَا بالُنا بعلماءِ هذا العصرِ الّذين أحالُوا العالمَ المتراميَ الأطرافِ إلى قريةٍ صغيرةٍ باستخدامِ تقنيَّاتِ الحاسُوبِ والشَّبكةِ العالميَّةِ للإنترنِت والاتِّصالِ عبرَ الأقمارِ الصِّناعيَّةِ و المحطَّاتِ الفضائيَّةِ الّتي تَنقُلُ إليْنا الحدثَ مباشرةً من أقْصَى أطرافِ المعمورةِ إلى أدناهَا، ومن أحدِ الكواكبِ إلى الكوكبِ الأرضيِّ عبرَ المركبةِ الفضائيَّةِ الّتي تُقِلُّ على متنِها روَّادَ الفضاءِ.
ولا ننْسَى دورَ بعضِ الشُّعوبِ المتميِّزةِ في بناءِ الحضاراتِ، ابتداءً من أقدمِها وانتهاءً بأحدثِها، ولا نستطيعُ إغفالَ دورِ كلِّ فردٍ بشريٍّ عمِلَ ويعملُ بشرفٍ وإخلاصٍ في ميدانِ عملِه واختصاصِه، فهو يَخدمُ الحضارةَ والمدنيَّةَ.
أمّا الّذين خانُوا الأمانةَ، وباعُوا ضمائرَهم، وأسرَتْهم شهَواتُهم وملذَّاتُهم، فعاثُوا في الأرضِ فساداً، وسرقُوا ثرواتِ وخيراتِ شُعوبِهم، وطغَوا وبغَوا، وارتكبُوا أبشعَ المجازرِ، في سبيلِ ثروةٍ أو جاهٍ وسلطانٍ، فلعنَهم اللهُ، ولعنتْهم الشُّعوبُ والأوطانُ؛ لأنَّهم لم يبْنُوا حضارةً، بل دمَّرُوا كلَّ وجهٍ حضاريٍّ جميلٍ في الحياةِ، وحرَمُوا كلَّ أفرادِ شُعوبِهم ومُجتمعاتِهم من الإحساسِ بطعمِ الحياةِ الجميلةِ، وتركُوهم يتجرَّعُون كؤوسَ الفقرِ والبُؤسِ والحِرمانِ.
Recommend0 هل أعجبك؟نشرت في مشاركات الأعضاء
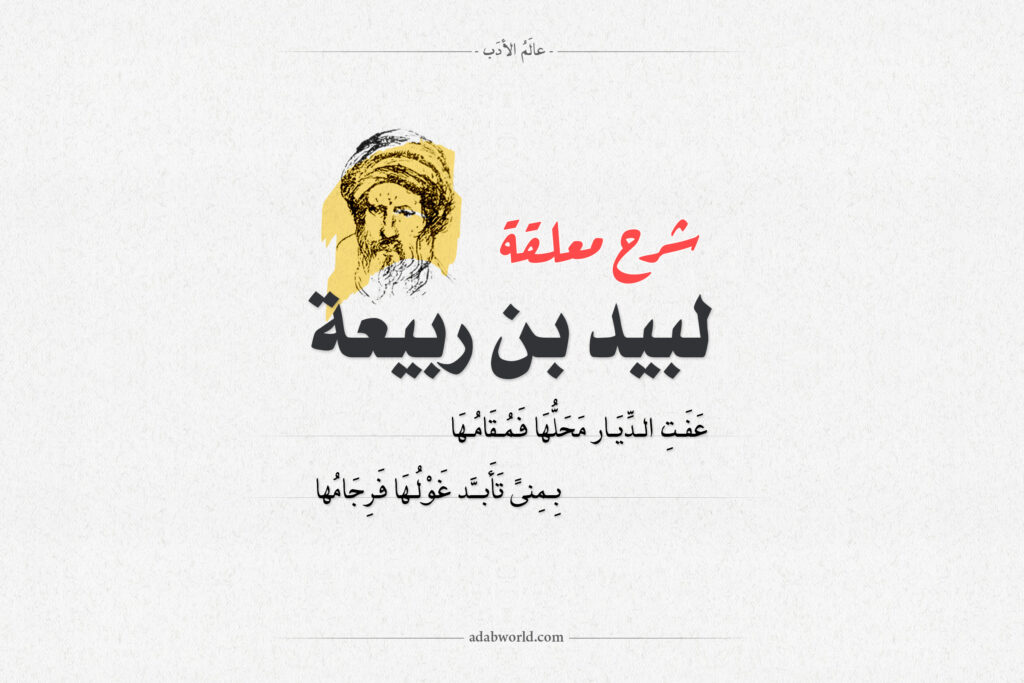
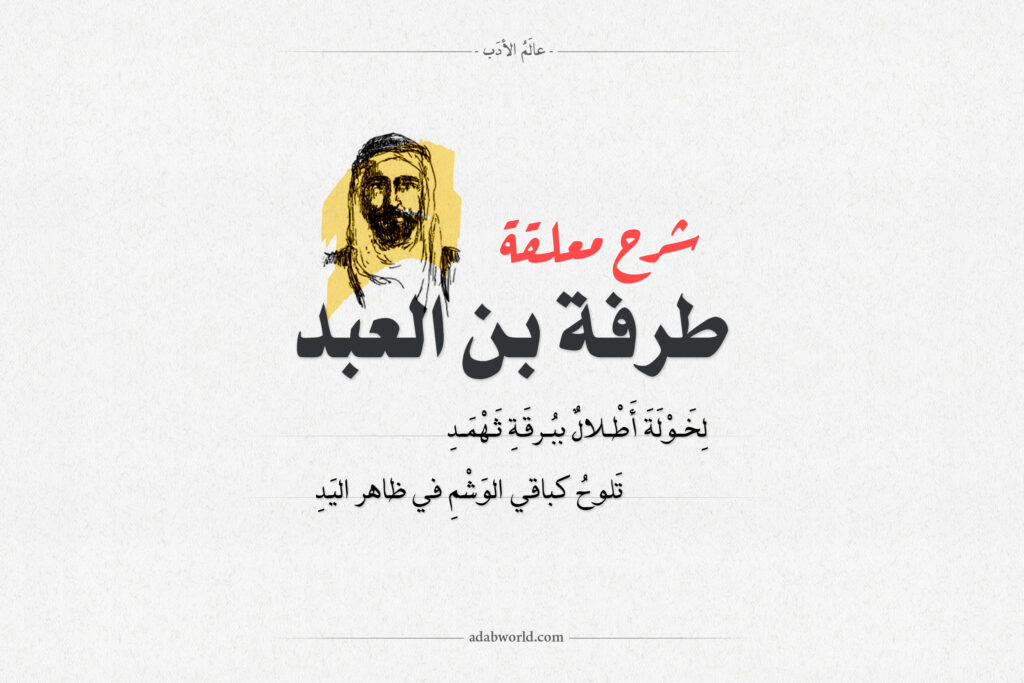
تعليقات