صراعُ الأضدادِ: العدلُ والظّلم
العدلُ أساس الملكِ، وجوهرُ بناءِ الدّول والمجتمعاتِ والأمم، والظُّلم سببُ زوالِ الملك وانهيارِ الدّولِ وتفكُّكِ المجتمَعات وتَقهقُر الأمم، وكلُّ قائدٍ عظيم أَعلَى رايةَ العدلِ خفّاقةً خلّدَه التَّاريخُ ومجَّدَته الأممُ، وتغنّتْ بعدلِه أقلامُ المفكّرينَ والأدباء.
حين عدلَ عمرُ بن الخطّاب (رض) بين الرعيَّةِ نام قريرَ العين مطمئنّاً بلا حرَّاسٍ، وبلغَت خلافتُه ذروةَ المجدِ والقوَّة الّتي هزمَت أكبرَ إمبراطوريَّتينِ -الرّومانيّة والفارسيّة- في التّاريخ، وحين عدلَ حفيدُه عمرُ بن عبدِ العزيز في حكمِه فاضتِ النّعمُ عن الرّعيّة، فنُثِرت الخيراتُ فوق رؤوسِ الجبالِ لتأكلَ الطيورُ.
لكنْ حينَما طغى الجبابرةُ على أعيانِهم بقوّةِ الظُّلم أهلكَهم اللهُ بظلمِهم، فكانُوا عبرةَ الأمم، فحكمةُ موسى أغرقَت ألوهيَّةَ فرعونَ في البحر، وشرفُ الإباءِ عند العربِ في الجاهليّةِ هزمَ غطرسةَ استِعلاءِ الفرسِ في معركةِ ذي قارَ الّتي رفعَت رايةَ العدل ومزّقَت حجُبَ الظُّلمِ والطُّغيان حين قالَ عنها معلّمُ الإنسانيّةِ والإنسان محمّدٌ عليه الصّلاةُ والسّلام: “اليومَ انتصفَ العربُ من العجم”.. وقوَّةُ الإرادةِ والعزيمةِ والإيمان دكّتْ عرشَ كِسرى ومرّغت أنوفَ جيوشِه في ترابِ القادسيّة.. وشجاعةُ وبطولةُ أبي عُديّ هزمَت أحلامَهم وأذلّتْ رايتَهم. وها هي دولةُ العجمِ ذاتُها تصولُ وتجول اليومَ في ربوعِ العروبة، فهل خلتِ الأمّةُ من الرّجال.. وهل ماتتْ نخوةُ الغَيارى والأبطال، وهل أضحَت البطولةُ أسطورةً من المحالِ ومعجزةً سماويّةً من الخَيال؟
العدلُ والظّلمُ في النّثر
العدالةُ فعلٌ وسلوكٌ لا ادّعاءٌ وأقوال، وأبشعُ أنواعِ الظّلم هو ادّعاءُ العدالةِ، كما نرى في سياساتِ الدّولِ والأمم المتحضّرةِ، فما بالكَ بدولِ ما قبلَ التّاريخ الّتي يقودُها أشباهُ عنترةَ بالنّارِ والحديد أو بالمالِ، وقد عبّر عن ذلكَ الفيلسوفُ اليونانيّ أفلاطون بقولِه: “أسوأُ أنواعِ الظّلم، الادّعاءُ بأنَّ هناكَ عدلاً”.
وأجملُ وأرقى أنواعِ العدل أن يأتيَ الإنسانُ بالحججِ على نفسِه وعلى خصومِه على قدْرٍ من العدلِ والمساواة، كما في المثلِ المشهور: “من ساواكَ بنفسِه ما ظلمَك” ، وكما في قولِ الفيلسوفِ الإسلاميّ ابنِ رشد: “مِنَ العدلِ أن يأتيَ الرّجلُ من الحججِ لخصومِه بمثلِ ما يأتي به لنفسِه”.
ومنهُ قولُ الكاتب الأمريكيّ مارك توين: “ليس من العدلِ أن تطلبَ من الآخرينَ، ما لستَ مستعدّاً لفعلِه”.
وقد عبّر عن هذهِ العدالةِ الرّاقية المفكّرُ الإسلاميّ جمالُ الدّين الأفغانيّ حين قالَ: “أقربُ مواردِ العدلِ القياسُ على النَّفسِ”.
وتبلغُ حكمةُ فلسفةِ الحياة وفنِّ التّعاملِ مع البشريّةِ أرقى أشكالِها حينَما يُكافأُ الظّلمُ بالعدلِ والتّشاؤمُ بالتّفاؤلِ والانتقامُ بالتّسامحِ والكِبرُ بالتّواضعِ والكُفرُ بحججِ الإيمان.. ويكُافأُ الإحسانُ بالإحسانِ واللّينُ باللّينِ والمحبَّةُ بالمحبّةِ والجودُ بالجودِ والسّلامُ بالسّلام.. كما في قولِ الحكيمِ الصّينيّ كونفوشيوس: “كافئِ الظّلمَ بالعدلِ، وكافئِ اللّينَ باللّين”.
وتتدفّقُ حكمةُ الرّأيِ السّديد غيثاً مدراراً من فكرِ الإمامِ عليّ (رض) حينَما يرى أنّ: “دولةَ الظُّلمِ ساعةٌ ودولةَ الحقِّ إلى قيامِ السّاعة”. كما أنّ: “يومَ المظلومِ على الظّالم أشدُّ وطأةً من يومِ الظّالمِ على المظلوم”.
وتمتطي فلسفةُ الحياةِ والاجتماعِ صهوةَ المجدِ في تاريخِ الأمم والدّول الّتي تَعلَمُ بالخبرةِ والفكرِ صيرورةَ حركةِ التّاريخ، فتنطقُ بالحقيقةِ ناصعةً كوجهِ الشّمس، كما نطقَ بها قلمُ عالمِ الاجتماعِ الإسلاميّ ابنِ خلدونَ الّذي يرى أنّ الظّلمَ مُؤْذنٌ بخرابِ العِمران؛ لأنّه ليس ثمّةَ ما يمنعُه من القوانينِ والعقوباتِ الزّاجرة: “وَلَوْ كانَ كُلُّ واحدٍ قادراً على الظُّلْمِ لوُضِعَ بِإِزائِهِ مِن العُقُوباتِ الزَّاجرةِ ما وُضِعَ بِإِزاءِ غيرِهِ من المُفْسِداتِ للنَّوعِ، التي يقدرُ كلُّ أَحدٍ على اقْتِرَافِها مِن الزِّنا والقَتْلِ والسُّكْرِ، إِلاّ أَنَّ الظُّلْمَ لا يقدرُ عليه إِلاّ من يَقْدِرُ عليه؛ لأَنَّهُ إِنَّما يَقَعُ مِن أَهْلِ القُدْرَةِ والسُّلْطانِ، فَبُولِغَ في ذَمِّهِ وتكريرِ الوعيدِ فيه؛ عسى أنْ يَكُونَ الوازعُ للقادِرِ عليهِ في نَفْسِهِ “.
ونقفُ على مقولةٍ رائعة في وجوبِ تقديرِ الإمام العادلِ بتقبيلِ يدِه، كما يرى الحسنُ البصريّ: “قُبْلةُ يدِ الإمامِ العَدلِ طاعةٌ”. ونحنُ نؤيّدُ هذا الرّأيَ، بل كنّا نتمنّى أن يمحقَ اللهُ أئمَّةَ الجهلِ الّذين لا يُجيدون القراءةَ إلّا بحدِّ السّيفِ وحبلِ المِشنقةِ وكابوسِ رغيفِ الخبز، وأن يرسلَ أئمَّةً من شياطينِ السّماء ليُقيمُوا العدلَ، فكنّا على استعدادٍ لتقبيلِ أيديهِم وأرجلِهم بكلِّ محبّةٍ وكبرياء.
وتتجلّى فلسفةُ التَّنويرِ حول حقيقةِ العدلِ والظّلم في أبْهى مضامينِها في فكرِ الكاتبِ والمفكّر السّوريّ الكبير عبدِ الرَّحمن الكواكبيّ، إذ يرى أنَّ الحاكمَ المستبِدَّ ما هو إلّا فردٌ عاجزٌ، لكنَّه يستمدُّ قوَّتَه من أعوانِه الكلابِ الّتي تكرهُ العدالةَ وتعشقُ الجَور: “إنَّ المستبِدَّ فردٌ عاجزٌ، لا حولَ له ولا قوَّةَ إلّا بأعوانِه، أعداءِ العدلِ وأنصارِ الجَور”.
ويرى الكواكبيّ أنَّ الظّالمَ جبانٌ، ولو أنّه رأى سيفاً على جنبِ المظلوم ما تجرّأَ على الظُّلم: “لو رأى الظّالمُ على جنبِ المظلومِ سيفاً لما أقدمَ على الظُّلم”.
ويرسمُ الكواكبيّ معالمَ الاستبدادِ حين يُنطِقُه معرّفاً بذاتِه ونسَبِه قائلاً: “لو كان الاستبدادُ رجلاً، وأرادَ أن ينتسِبَ، لقالَ: أنا الشّرُّ، وأبي الظُّلمُ، وأمّي الإساءةُ، وأخي الغدرُ، وأختي المسْكَنةُ، وعمّي الضُّرُّ، وخالي الذُّلُّ، وابني الفقرُ، وابنتي البطالةُ، ووطني الخرابُ، وعشيرتي الجَهالةُ”.
ويطالعُنا الكاتبُ الرّوائيُّ الإيرلنديّ أوسكار وايلد برأيٍ طريف في موضوعِ العدالةِ إذ يُوجِبُ: “على الدَّولةِ أن ترفعَ الضَّرائبَ على العزَّابِ، فليس من العدلِ أن يكونَ بعضُ النّاس أكثرَ سعادةً من غيرِهم”. وهو محقٌّ في طلبِه؛ لأنّ رفعَ الضّرائبِ على العزَّابِ سيجبرُهم على الزّواجِ وبالتّالي يتَساوى الجميعُ في الشّقاءِ والتّعاسة!
وحين يستَشْري الظُّلمُ في العالم، ويصبحُ القانونُ الوحيدُ الّذي يحكمُ العالمَ هو قانونُ الغابةِ يجلسُ الفيلسوفُ الفرنسيّ جان جاك روسو مفكّراً بالجحيم الّذي ينتظرُ هؤلاء الظّالمينَ في العالمِ الآخر: “حين أرى الظُّلمَ في هذا العالمِ، أُسلّي نفسي بالتَّفكير في أنّ هناكَ جهنّمَ تنتظرُ الظّالمين”.
ويذكّرُنا الفيلسوفُ اليونانيّ هِرَقْليطُس بطبيعةِ الحياة القائمةِ على الصّراع بين النّقائضِ، فكلُّ ضدٍّ يظهرُه الضّدُّ: “لم يكنِ النّاسُ ليعرفُوا العدلَ لو لم يكنْ هناك ظلمٌ”.
ونقفُ على آراءٍ متنوّعةٍ للمفكّر العربيّ الكبير عليّ الورديّ في موضوع العدلِ والظّلم، بعضُها في صميمِ الحقيقة، وبعضُها يُجانبُها، إذ يرى أنّ: “من طبيعةِ الإنسان أن يظلمَ إذا لم يجِدْ ما يمنعُه من الظُّلم جدّيّاً.. إنّ الانسانَ ليس ظالماً بطبعِه كما يتصوّرُ البعضُ.. إنّه في الواقعِ يحبُّ العدلَ، ولكنّه لا يعرفُ مأتاهُ.. فهو يظلمُ ولا يدري أنّه ظالمٌ، فكلُّ عملٍ يقوم به يحسبُه عدلاً، ويصفّقُ له الأتباعُ والأعوانُ، فيظنُّ أنّه ظلُّ اللهِ في الأرض”. صحيحٌ أنّ الإنسانَ يظلم إذا لم يجدْ مَن يردعُه عن الظّلم، وقد قال ذلك بشكلٍ جليّ المفكّر عبدُ الرّحمن الكواكبيّ كما أسلفْتُ، ولكنْ ليس صحيحاً على الإطلاق زعمُه “بأنّ الإنسانَ ليس ظالماً بطبعِه وأنّه يحبُّ العدلَ، ولكنّه لا يعرفُ مأتاهُ، فهو يظلمُ ولا يدري أنَّهُ ظالمٌ”. فأيُّ عاقلٍ في الدّنيا ينكرُ أنّ الشّرَّ من طبيعةِ الشّرّير، وأنّ القتلَ نهمٌ أصيلٌ في طبيعةِ المجرمين، وأنَّ اللُّصوصيّةَ عقيدةٌ متجذِّرةٌ في نفوس اللُّصوص، وأنّ الدّكتاتوريّةَ شريعةُ غابٍ نابعةٌ من رؤى وأحلامِ الدّكتاتوريّين، وأنّ احتساءَ دماءِ الأبرياء كاحتساءِ القهوةِ في لحظاتِ السّعادةِ عند مصّاصي الدّماء هوايةٌ بنكهةِ البراعةِ، وأنَّ الظُّلمَ براعةٌ لا يُتقنُها إلّا مَن رضعَ الظُّلم حليباً من ثديِ الظَّلام فصار الجَورُ عقيدةً يتلذَّذُ في عبادتِها المستبدُّون والطّغاةُ والمجرمُون وقطَّاعُ الطّرق.. وهل مَن يستلِذُّ بانتهاكِ حقوقِ الآخرين وحرماتِهم ومقدَّساتِهم لا يعرفُ مأتاهُ إن كان ظالماً أم كان بريئاً، إلّا إذا كان حماراً، والحمارُ منهُ بريءٌ؛ لأنّه يميّزُ الخيرَ من الشَّرّ والحقَّ من الباطلِ والنُّورَ من الدّيجور والإناثَ من الذُّكور!
ويطالعُنا المفكّرُ عليّ الورديّ برأيٍ طريفٍ آخر: “يُقالُ إنَّ القانونَ الّذي يشرّعُه المشرّعُون يؤدّي إلى الظّلمِ إذا طُبّقَ حرفيّاً. وهذا قولٌ لا يخلُو من وجهةِ نظرٍ صحيحة”. لكنّ كلامَ الورديّ لم يُضِفْ شيئاً إلى عالمِ الحقائق، فليس المشرّعُون أنبياءَ ولا رسلاً، وليستْ تشريعاتُهم سوى كرابيجَ تجلدُ الجُناةَ إن صغُروا وإن كبُروا دون مراعاةٍ لظروفِ وأهدافِ الجناية، كما أنّ جميعَ اللّصوصِ ليسُوا على سويّةٍ واحدة، وكذلك المجرمُون ليسوا على درجةٍ معيّنة في مقياسِ الإجرام، فثمّةَ مَن يقتلُ الجسدَ، وثمّة مَن يقتلُ الرّوحَ، وثمّةَ مَن يسحقُ الاثنينِ معاً، كما أنَّ هناك مَن يقتلُ فرداً وهناك مَن يقتلُ شعباً، فهل من قانونٍ عادل في الأرضِ يميّزُ بين القتلةِ والمجرمينَ؟! وهذا إن طُبِّقَ القانونُ حرفيّاً، فما بالُكم لو أنّه لم يُطبَّقْ حرفيّاً، ولن يُطبّقَ حرْفِيّاً ولا حِرَفيّاً! كما أنّ القوانينَ مثلَ مقاييسِ الجمالِ تخضعُ لأهواءِ ورغباتِ وشهواتِ منظرّي علمِ الجمالِ الجسديّ لا الأخلاقيّ! والعالمُ اليومَ ليس إلّا مجموعةَ مقاييسَ يديرُها ذوو الشّهواتِ والرّغبات.. وما على القانونِ إلّا السَّلام!
لكنَّ مخالفتي في الرّأيِ للمفكّر العالِم عليّ الورديّ لا تَعني النَّيلَ من شرفِ فكرِه الأصيلِ القائمِ على التَّنوير وبناءِ الإنسانِ بناءً حضاريّاً راقياً، فها هو في مقولةٍ أخرى يكشفُ زيفَ وعّاظِ السّلاطين الّذين يبرّئُون الطُّغاةَ من مظالمِهم، فيُوقِعُ الخطيئةَ على الفقراءِ البائسينَ ويتوعَّدُهم بالبلاءِ والعقاب السَّماويّ. فأيُّ قانونٍ إلهيّ يحاسبُ فقيراً سرق رغيفَ خبزٍ ليسدَّ به رمقَ أسرتِه الّتي أنهكتِ المجاعةُ أحشاءَها، وأيُّ عقابٍ إلهيّ ينزلُ على شقيٍّ قَطعَ أخشابَ الغابةِ؛ ليصنعَ منها كوخاً يقيهِ وأسرتَه بردَ الشّتاء، وأيُّ قانونٍ سماويّ يلاحقُ متسوّلاً يجمعُ حفنةً من المالِ؛ ليُعالجَ مرضاهُ من وباءٍ خطير؟! فلولا الظُّلمُ والطُّغيانُ والفسادُ لما بقيَ فقيرٌ على المعمورةِ، ولولا وجودُ شياطينِ الأرض من الإنسِ لهبطَت شياطينُ السَّماءِ وكانتْ أرحمَ على البشر.. وأتركُ القولَ للمفكّر عليّ الورديّ: “يهتفُ الواعظُ بالنّاسِ قائلاً: إنّكم أذنبْتُم أمام اللهِ فحقَّ عليكُم البلاءُ من عندِه، والواعظُ بذلك يرفعُ مسؤوليَّةَ الظُّلمِ الاجتماعيّ عن عاتقِ الظّالمين، فيضعُها على عاتقِ المظلومينَ أنفسِهم.. فيأخذون بالاستِغفارِ وطلبِ التَّوبةِ، وبهذه الطّريقةِ يستريحُ الطُّغاةُ، فقد أزاحُوا عن كواهلِهم مسؤوليَّةَ تلكَ المظالمِ الّتي يقومُون بها، ووضعُوها على كاهلِ ذلك البائسِ المسكين الّذي يركضُ وراء لقمةِ العيشِ صباحَ – مساءَ، ثمّ يلاحقُه الواعظون بعد هذا بعقابِ اللهِ الّذي لا مردَّ له”.
وقد أصابَ مفكّرُنا الورديّ حين تحدّثَ عن مَكيدةِ العقلِ البشريّ في اصطيادِ البائسين، وأُورِدُ قولَه الجميلَ دون تعليقٍ: “لم يبتكرِ العقلُ البشريُّ مكيدةً أبشعَ من الحقِّ والحقيقةِ، ولستُ أجدُ إنساناً في هذهِ الدُّنيا لا يدّعي حبَّ الحقِّ والحقيقة حتّى أولئكَ الظَّلمةُ الّذين ملؤُوا صفحاتِ التّاريخ بمظالمِهم الّتي تقشعِرُّ منها الأبدانُ.. لا تكاد تستمعُ إلى أقوالِهم حتّى تجدَها مُفعمةً بحبِّ الحقِّ والحقيقة، والويلُ عندئذٍ لذلكَ البائسِ الّذي يقعُ تحت وطأتِهم، فهو يتلَوَّى من شدَّةِ الظّلم الواقعِ عليه منهُم، بينما هم يرفعُون عقيرتَهم بأنشودةِ الحقِّ والحقيقة”.
ومن أجملِ أقوالِ المفكّر عليّ الورديّ: “نحنُ قد نرى إنساناً تقيّاً قد بحَّ صوتَه في الدّعوةِ إلى العدلِ والصّلاح، فنحسبُه عادلاً في صميمِ طبيعتِه، وهذا خطأٌ. إنّه يدعو إلى العدلِ لأنّهُ مظلومٌ، ولو كان ظالماً لصارَ يدعُو إلى الصَّومِ والصّلاة”. نعمْ صدقْتَ وأصبتَ عينَ الحقيقةِ، فالعاهرةُ غالباً ما تدعُو إلى الشَّرفِ والاستِقامة، وواعظُ السَّلاطينِ يدعُو إلى التَّقشُّفِ والاستِدامةِ، وواعظُ البائسينَ يُلحُّ على الصَّبرِ والتَّحمُّلِ والتأمُّلِ للقيامة! وبينَ الاستِقامةِ والاستِدامةِ والقيامةِ ضاعتِ البشريَّةُ ما بينَ أخواتِ كانَ وخالاتِها حانَا ومانَا!
ومن أقوالِ الورديّ الجميلةِ والمؤثّرة: “إنّ العدلَ الاجتماعيَّ لا يتمُّ إلّا إذا كان إزاءَ الحاكمِ محكومٌ واعٍ يردعُه ويهدِّدُه بالعزلِ”. و “هذهِ هي طبيعةُ الإنسانِ في كلِّ زمانٍ ومكان، فهو يطلبُ العدلَ حين يكونُ محروماً منهُ، فإذا حصلَ عليه، بخِلَ به على غيرِه”.
أمّا الكاتبُ والرّسّامُ والفيلسوفُ المهجريّ ميخائيلُ نعيمةَ فلهُ صولةٌ فريدةٌ في موضوع العدلِ والظّلم، فهو يرى أنّ أسمى أنواعِ العدل تتجلّى في المحبَّة، في حبِّ الحبيبِ لحبيبتِه بكلِّيّتها وفي شتّى الأحوالِ والظّروف، فحبُّ حالةٍ دون حالةٍ أخرى أنانيّةٌ ترتدي ثوبَ المحبَّةِ البهيّ، على نحو ما غنّتْ فيروزُ: “حبّيتَكْ بالصّيف.. حبَّيتَك بالشّتي” وهذا ما فهمتُه، وللفلاسفةِ مذاهبُ بعيدةُ المنالِ، إذ يقولُ: “وأنا أحبُّكِ والمحبّةُ هي العدلُ بأسمى ظواهرِه، فإنْ لم أكنْ عادلاً بمحبَّتي لكِ في كلِّ المواطِنِ، كنتُ ساتراً بشاعةَ الأنانيَّةِ بثوبِ المحبَّةِ البهيّ”.
ويطرح نعيمةُ تساؤلاتٍ كبرى في فلسفةِ الحياةِ والشّريعة تفتحُ للفكرِ آفاقاً في التّأمُّلِ ومراجعةِ نظراتِنا القاصرةِ في جوهر الوجودِ الإنسانيِّ وما يتخلَّلُه من أخطاءٍ يجبُ ألّا تُعالجَ بأخطاءٍ أخرى أكبرَ وأعمقَ إذ يقول: “أَنُقابلُ الشّرَّ بشرٍّ أعظمَ ونقولُ هذه هي الشَّريعةُ، ونقابلُ الفسادَ بفسادٍ أعمَّ ونهتفُ هذا هو النَّاموسُ، ونغالبُ الجريمةَ بجريمةٍ أكبرَ ونصرخُ هذا هو العدلُ؟”.
وأمّا الكاتبُ والمفكّر أنيس منصور فيرى أنّ للظّلمِ أنواعاً كثيرة، كما أنّ للعدلِ أنواعاً جمَّة، ولكنّ أشدَّ أنواعِ الظّلم هو ظلمُ أقربِ النّاس إليكَ؛ لأنَّ طعنتَه قريبةٌ وتكونُ أشدَّ إيلاماً: “هناكَ أنواعٌ كثيرةٌ من الظُّلم، كما أنَّ هناكَ أنواعاً كثيرةً من العدل، وأشدُّ أنواعِ الظّلم أنَّ أقربَ النّاس إليكَ، أبعدُهم عنِ العدل”. وقد عبّر عن ذلك يوليوس قيصر حين فُوجئَ بطعنةٍ قاتلة في ظهرِه، فنظر خلفَه ليعرفَ وجهَ طاعنِه، فإذا به أعزُّ النّاسِ إلى فؤادِه وهو صديقُه بروتوس، فقال قولتَه الشَّهيرةَ قبل أن يلفظَ أنفاسَه الأخيرة: “حتّى أنتَ يا بروتس”.
وقريبٌ من هذا القولِ في بيانِ أشدِّ أنواعِ الظّلم، قولُ المفكّر ديفيد هيلبرت الّذي يرى أنَّ أشدَّ أنواعِ الظّلم هو: ” أن يلعبَ الظّالمُ دورَ الضّحيَّةِ ويتَّهِمَ المظلومَ بأنّه ظالمٌ”.
وقد يدومُ الملْكُ مع الكٌفرِ، لكنّه لا يمكنُ أن يدومَ مع الظُّلمِ، كما عبّر عن ذلكَ الكاتبُ أحمد بهجَت حين قال: “قد يدومُ الملكُ على الكفرِ، ولكنّه لا يدومُ على الظُّلم”. والواقعُ شاهدُ حقٍّ على ذلك، فها هي دولُ الغربِ (الكافرة) تتقدَّمُ وتزدهِر، وها هي دولُ الشّرقِ (المؤمنة) تتساقطُ واحدةً تلوَ الأخرى!
وقد ينشأُ الظّلمُ عن السّكوتِ عن خطأٍ بسيط، ما يلبثُ أن يكبرَ ويتحوّلَ إلى جملةٍ من الأخطاء، وبدايةُ الحريقِ شرارةٌ كما قيلَ، وهذا ما عبّر عنهُ الكاتبُ عليّ إبراهيم الموسويّ في قولِه: “كلُّ أشكالِ الطُّغيان بدأَت بالسُّكوتِ عن خطأٍ بسيط، ثمّ كبُرَ هذا الخطأُ وأصبحَ أخطاءً عديدةً تحوّلَت في النّهاية إلى طوفانٍ من الظُّلم”.
وقريبٌ من هذا المعنى قولُ جوليان أسانج: “في كُلِّ مرّةٍ نرى الظُّلمَ ولا نُحرّكُ ساكناً، فنحن نُربّي أنفسَنا على الرُّضوخ”.
ويعبّر الكاتبُ الكبير أحمدُ خالد توفيق عن دورِ الثّقافة في تفريق قلوبِ النّاس؛ لأنّها بالطّبع تكشفُ للمظلومين هولَ الظُّلم الواقعِ عليهم، وتُطلِع المحظوظين على ما يُمكنُ أن يخسرُوه: “ليستِ الثّقافةُ ديناً يوحّدُ بين القلوبِ ويؤلِّفُها، بل هي على الأرجحِ تفرّقُها؛ لأنّها تُطلعُ المظلومين على هولِ الظّلم الّذى يعانونَه، وتُطلعُ المحظوظينَ على ما يُمكِن أن يفقِدوه”.
ويرى المفكّر ألبرت هابرد أنّه من العدلِ أن يتحمَّلَ المسيءُ ردّةَ فعلِ المُساءِ إليه بما أنّه تحمَّل قسوةَ الإساءة: “من باب العدلِ أن تتحمَّلَ ردّةَ فِعلي بما أنّني تقبَّلتُ قساوةَ فعلِك”.
ونجدُ رأياً يُجافي الحقيقةَ في قولِ المفكّر الفرنسيّ جوستاف لوبون: “نحبُّ العدلَ وقلَّما نحِبُّ العادلين”. فلا يُمكنُ لعاقلٍ أن يحبَّ العدلَ ويكرَهَ العادِلين إلّا إذا كان ذلكَ المرءُ ممّن يسعدُون بالنِّعمِ وينسَون المُنعِمَ عليهم، ويتذكّرُون العَطايا وينسَون الأياديَ البيضاءَ عليهم.
أمّا الكاتبُ والفيلسوفُ الألمانيّ فريدريك نيتشه فيرى أنّ كلَّ إنسانٍ يقشعِرُّ من أيِّ شكلٍ من أشكالِ الظّلمِ فهو رفيقُه: “إذا كنتَ تقشعِرُّ من كلّ أشكالِ الظّلم إذاً أنتَ رفيقي”.
ولكنَّ الكاتبَ الرّوسيَّ العِملاق فيودور دوستويفسكي فيستنكِرُ ويستهجنُ قولَ الزّاعمين بأنَّ وجودَ الإنسان مجبولٌ على الألمِ والظُّلم؛ لأنّهما يهبَانِ الإنسانَ معرفةَ الخيرِ والشّرّ: “يزعم بعضُهم أنّ الوجودَ على هذهِ الأرض لا يُمكنُ تصوُّرُه خالياً من الألمِ ومن الظّلم اللّذينِ يستطيعانِ وحدَهُما أن يهبَا الإنسانَ معرفةَ الخيرِ والشّرّ! ألا بئسَتْ تلكَ المعرفةُ إذا كان ثمنُها هذا الثَّمنَ”.
أمّا الكاتبُ الرّوسيُّ الآخر أنطون تشيخوف فيعبّر عن رضاهُ بما قسمَهُ اللهُ له، لكنّ هذا الرّضا لا يَعني أنّهٌ راضٍ عن الظّلم في توزيعِ الثّروات: “لا أريدُ شيئاً، ولكنَّ الظّلمَ يُثيرُ تقزُّزي”.
ويعبّر الكاتبُ المصريّ أدهم شرقاويّ عن حال أمّتِه القائمةِ على تناقضِ الفعلِ مع القول، فنسمعُ شعاراتٍ ولا نجدُ واقعاً حقيقيّاً لها، وتصرعُنا الخطاباتُ ولا نلمسُ في الحقيقةِ أثراً لها، فأمَّتُنا أمّةُ تنظيرٍ من رأسِها حتّى أخمصِ قدمَيها: “نحنُ أكثرُ الأمَمِ مُمَارسةً للتَّنظِيرِ نتَحدَّثُ عن العَفوِ ونحقدُ، وعن العَدلِ ونَظلِمُ، وعن المُسَاواةِ ونُفرّقُ، ويُؤسفُني أن أقولَ: إنّنَا صُورةٌ مصغّرةٌ عن حُكُومَاتِنا”.
والظُّلمُ يتطلَّبُ موقفاً صريحاً وفعلاً حقيقيّاً في مواجهتِه، ولكنّ الحيادَ إزاءَه يَعني مناصرةَ الظّالم، كما في قولِ ديزموند توتو: “إذا كنتَ محايداً في حالاتِ الظُّلم فقد اخترتَ أن تكونَ بجانبِ الظّالم”.
وممّا يُؤسَفُ له في الحقيقةِ أنّ العالمَ الحرَّ الّذي عانى من ويلاتِ ظلمِ وظلامِ القرون الوسطى سوف يثورُ على الظّلمِ والعدوان كما حسِبَ النّاسُ، لكنّه لم يخطرْ ببالِهم أنَّ الضَّميرَ العالميَّ قد ماتَ، وهذا ما عبّر عنهُ الأديبُ الرّوائيّ الكبير عبدُ الحميد جودة السّحّار: “حسِبُوا أنّ العالمَ الحرَّ سيثورُ على الظّلمِ والعدوان، وما دار بخلَدِهم أنّ الضَّميرَ العالميّ قد مات”.
ونقفُ على مقولةٍ تفيضُ بالسّخريةِ للرّوائيّ الكبيرِ نجيب محفوظ من أصحابِ الشّعاراتِ الّذين يخدعُون النّاسَ بيافِطاتِهم، ولكنَّهم في الحقيقةِ ليسُوا سوى شِرذِمةٍ من الطُّغاةِ الفاسدينَ واللُّصوصِ المارقين: “لا تخدعْكَ في المحاكمِ عبارةُ (العدلُ أساسُ الملْك).. أعرفُ الكثيرَ من اللُّصوصِ يضعُون على مكاتبِهم (هذا من فضلِ ربّي)”.
Recommend0 هل أعجبك؟نشرت في مشاركات الأعضاء
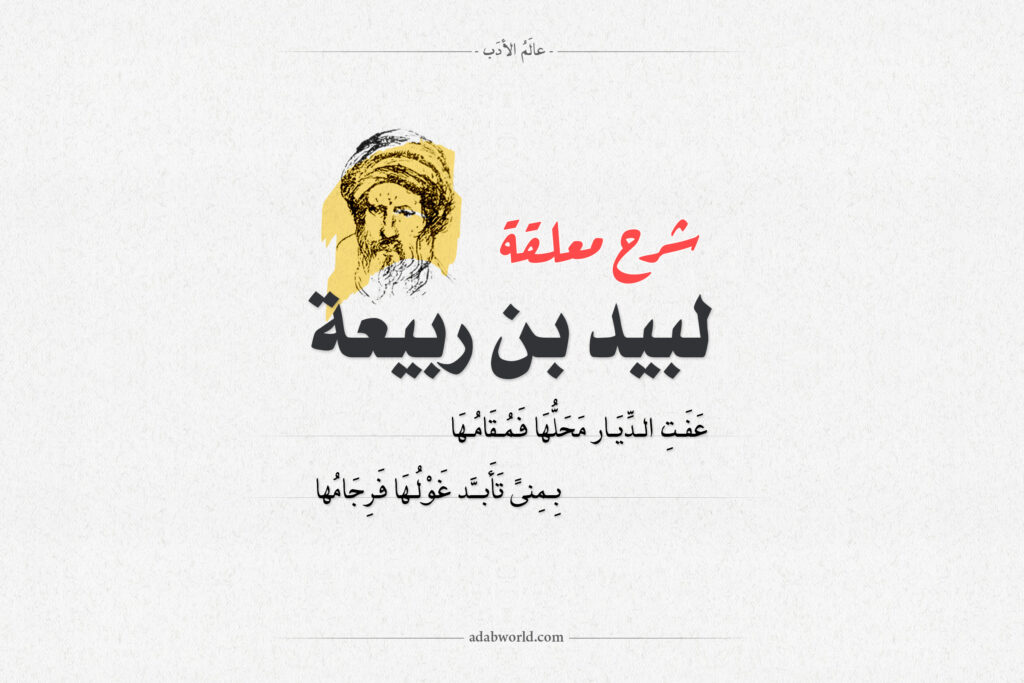
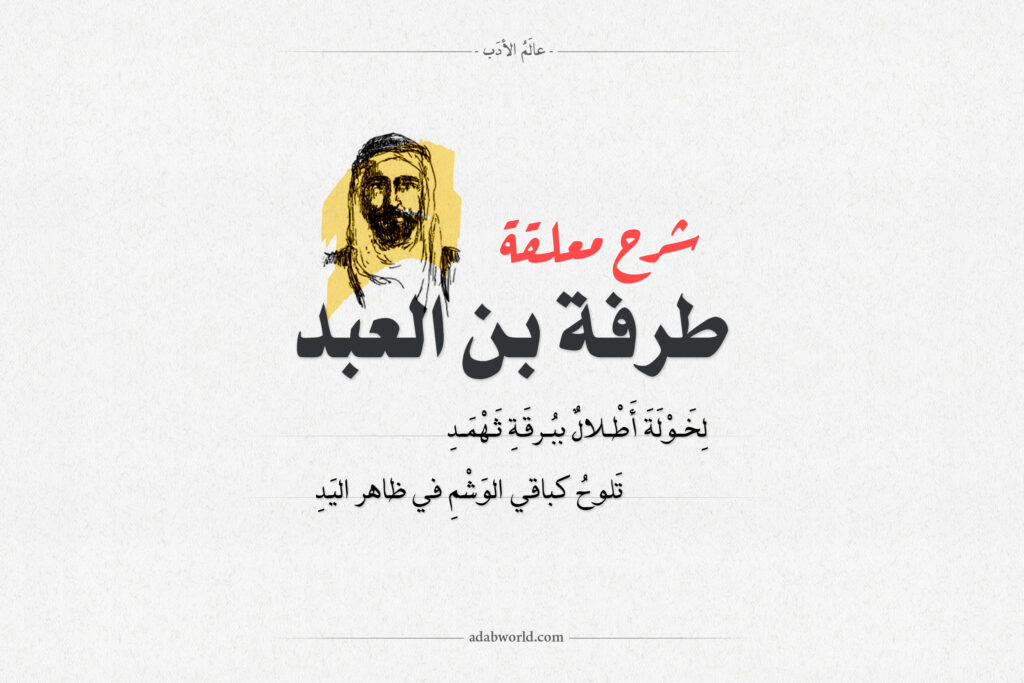
تعليقات