أوَابِدُ التَّحدِّي
انطلقَتْ بنا الحافلاتُ الثَّلاثُ من قريةِ نيصَافَ السَّاعةَ السَّابعةَ صباحاً، برفقةِ الأخِ خالِد يوسُف والجهازِ الإداريِّ والتَّدريسيِّ في المدرسةِ، مع طلَّابِ وطالباتِ المرحلةِ الإعداديَّةِ، وكلٌّ يصطحِبُ عُدَّةَ الرَّحيلِ من طعامٍ وشرابٍ وأدواتٍ وأجهزةِ تصويرٍ.
انطلقْنا صباحاً على أنغامٍ شجِيَّةٍ تتصاعدُ من أفـواهِ آلاتِ التَّسْجيلِ تارةً ومن حناجرِ الطُّلَّابِ تارةً أُخْرى، على قرعِ الطُّبولِ أو الدَّرَبُكَّةِ، وعلى ألحانِ المزْمارِ والعُودِ أحياناً أُخرى.
كانتْ قلوبُ الجميعِ تتراقصُ، وعيونُهم تُحِّدقُ في البعيدِ، تريـدُ أن تستَشرِفَ الآتي؛ لكشفِ المجهولِ، وكانتِ النُّفوسُ تَهفُو في شوقٍ لرؤيةِ إبداعاتِ الله في الكونِ والطَّبيعةِ واختراعاتِ وإنجازاتِ يدِ الإنسانِ على وجهِ البسيطةِ، تارةً تتأمَّلُ، وأُخرى تنفعلُ مـع الموسِيقا والغِناءِ.
وصلْنا إلى بُحيرةِ قِطِّينةَ في الثَّامنةِ صباحاً، وأوَّلُ ما لفتَ أنظارَ الجميعِ تلكَ الأشجارُ الباسِقةُ الَّتي وقفَت بقامتِها الممشوقةِ تتأمَّلُ البُحيرةَ في صمتٍ، وتُبادِلُها مشاعرَ الـوُدِّ والأُلفةِ، فزادَتِ البحيرةَ جمالاً فوقَ جمالٍ، وإبداعـاً إثرَ إبداعٍ، فلولا تلكَ الأشجارُ، بدَتِ البحيرةُ حوضاً كبيراً من الماءِ وسطَ بيداءَ، لكنَّ البحيرةَ أدركَت أنَّ جمالَها زائفٌ دون ثوبٍ أخضرَ يُوشِّي أطرافَها، فمدَّتْ كؤوسَ مياهِها العذبةِ؛ لترويَ تلكَ الأشجارَ التي غرسَتْها يـدُ الإنسانِ سعياً إلى تحقيقِ الجمالِ في الطَّبيعةِ؛ لتنعمَ بالرَّاحـةِ والاستجمامِ والهدوءِ، ولولا مياهُ البحيرةِ أمامَ تلكَ الأشجارِ، بدَتْ غابةً صغيرةً تُناطحُ أشعَّةَ الشَّمسِ وتُقارعُ الرِّياحَ.
وقفْنا على شاطئِ البُحيرةِ نُناجِيها ونُطارحُها هُمومَنا، لعلَّ مُوَيجاتِها المتتَابِعةَ تجتَثُّ من أفئدتِنا المتْعبةِ سُمومَ الحياةِ وهمومَها، ولعلَّ أنسامَها العليلةَ تقتلِعُ من نفوسِنا بذورَ الشَّقاءِ واليأسِ وضَنْكَ المعيشةِ.
لاحتِ البحيرةُ قطعةً منبسطةً مـن مياهٍ زرقاءَ، تعلُوها تموُّجَاتٌ صغيرةٌ، تتراقصُ هنا وهناكَ مُعبِّرةً عـنِ الحيويَّةِ والنَّشاطِ، وهي تتلاعبُ مع نسماتِ الهواءِ العليلِ، وأمضَيْنا ساعةً من المتعةِ والرَّاحةِ والاستجمامِ بين أحضانِ الطَّبيعةِ الخلَّابةِ أمامَ بحيرةِ قِطِّينةَ العاشِقةِ.
وودَّعْنا البحيرةَ بأعيُنِنا، لكنَّ قلوبَنا ظلَّتْ عالقةً بينَ ظِلالِ أشجارِهَا، واتَّجهْنا إلى قلعةِ الحصْنِ، والحافِلاتُ تعلُو وتهبِطُ، مُسابِقةً الرِّياحَ تُريدُ أن تقولَ لنَا: هيَّا أسرعُوا لِتَروا ماذا خلَّفَ لكمُ الأجدادُ الأشاوِسُ؟!
وماذا عساكُمْ تتركُون من بصماتٍ على جدارِ الزَّمنِ تحدِّثُ الأجيالَ القادمةَ عمَّا فعْلتُم، كما تقرؤونَ أحاديثَ البطولةِ والرُّجولةِ والعظمةِ على صفحاتِ هذهِ الأوابدِ الشَّامخةِ أمامَ أبصارِكُمْ.
وما إنْ اقتَربْنا من مَشارفِ مدينةِ الحِصْنِ، حتَّى لاحتْ قلعتُها الشَّامخةُ نسْراً جارحاً يربضُ في أعالي الهضابِ، يريدُ أن ينقضَّ على رياحِ العدَاوةِ في كلِّ عصرٍ من عصورِ الزَّمانِ، وقد بدَتِ القلعةُ قطعةً واحدةً من الصَّخرِ الصَّلْدِ تربَّعتْ قمَّةً عاليةً فوقَ المدينةِ.
ووصلْنَا إليـها في السَّاعةِ العاشرةِ صباحاً، وكانت أسْرابُ الزُّوَّارِ تَتْرى جماعاتٍ وأفراداً، تريدُ أن تقرأَ صفحاتِ المجْدِ والبطولةِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ على جدرانِ هـذهِ القلعةِ الصَّامدةِ، ودخلْناهَا بانتظامٍ كلٌّ يتأمَّلُ بعينينِ يلوحُ منهُما بريقُ الدَّهشةِ والإعجابِ والإكبارِ!! ماذا يستطيعُ المرءُ أن يقرأَ خلالَ هذهِ الزِّيارةِ القصيرةِ؟
كلُّ جـزءٍ في القلعةِ يَرْوي حكاياتٍ وأسَاطيرَ! فالبوَّابـةُ الأُولى تفتحُ أمامَك كتابَ التَّاريخِ، فماذا تقرأُ؟! هلْ تقرأُ أسرارَ عظمةِ الأجدادِ، أمْ هلْ تقرأُ أسرارَ خلودِ هذهِ القلعةِ؟ أمْ هلْ تُفسِّرُ أسـرارَ صُمودِها؟ أمْ هـلْ تقرأُ ألغازاً لا يمكنُ فكُّ طلاسِمِها فـي الَّلحظةِ الرَّاهنةِ؟
كلُّ شيءٍ يُوحِي إليكَ بالعظَمةِ والجَـلالِ ، وكلُّ خُطوةٍ تَخطُوهـا إلى الأمامِ في هذهِ القلعةِ تحثُّكَ على مزيدٍ مـنَ التقدُّمِ، لكنَّ الخيالَ يأسرُكَ بالتَّأمُّلِ في كلِّ جزءٍ، ويدفعُكَ للعودةِ إلى الوراءِ؛ وكأنَّهُ يُدركُ أنَّ صُورَ التَّاريخِ لم تكتمِلْ فيهِ، فلا بدَّ من وقفَاتِ تريُّثٍ طويلةٍ؛ حتَّى تستطيعَ الذَّاكرةُ العودةَ إلى الوراءِ لإدراكِ أسرارِ عظمةِ مَنْ تركُوا لنَا هذهِ الأمجادَ!
يا لَعظمةِ الأجدادِ! كيفَ استطاعُوا أنْ يبنُوا هـذهِ القلعةَ الشَّامخةَ؟! فكلُّ صخرةٍ منحوتةٍ بإتقانٍ تعجزُ الآلاتُ الحديثةُ عـن نحتِها ورفعِها بهذهِ الدِّقَّةِ والبراعةِ والإحكامِ، علماً بأنَّ هؤلاءِ العظماءَ لم تكُنْ لديْهم أدواتٌ كهرَبائيَّةٌ لتَصنعَ المستحيلَ، ولم يمتلِكُوا رافِعاتٍ ميكانيكيَّةً تُدهِشُ النَّاظرينَ!
ثمَّ من أينَ أتَوا بهذهِ الصُّخورِ الضَّخمةِ! وكيفَ استطاعُوا نقلَها ورفعَها إلى أعالي تلكَ القمَّةِ؟ ثمَّ كمْ قضَوا من السِّنينَ في بنائِها؟ وكم فَنيَ من العبادِ مـن أجلِ إنجازِ هذا الصَّرِح العظيمِ؟ ومـا هيَ المقاييسُ والهندساتُ الدَّقيقةُ التي استعملُوهَا ليصلُوا إلى هذهِ الدَّرجةِ من الرَّوعةِ والإتقانِ؟ كلُّ شيءٍ يدعوكَ إلى التَّساؤلِ! إنَّكَ لستَ أمـامَ مدينةٍ أو قريةٍ عاديَّةٍ، بل أنت أمامَ مدينةٍ متكاملةٍ بكلِّ معالمِها ومضامينِها وتاريخِها!
ففي هـذهِ المدينةِ الأثريَّةِ عرشُ الملكِ والملكةِ، وفيهـا مهاجعُ الجنودِ، ومرابضُ الخيولِ، وفتحاتٌ وثغراتٌ لرميِ النِّبالِ والسِّهام واختباءِ الجنـودِ، وفيها أسوارٌ تُحيطُ بها من كلِّ صوبٍ، وفيها طوابقُ يقودُك كلُّ واحدٍ منهَا رويداً رويداً إلى الأعلى، ومن كلِّ طابقٍ تستطيعُ أن تتأمَّلَ الطَّوابقَ السُّفْلى عبرَ نوافـذَ مبتكرةٍ، وتجدُ فيهـا المسجدَ والمصلَّى للعبادِة، وأفراناً لصناعةِ الخبزِ، ومعاصرَ لعصرِ الزَّيتونِ، ومطابخَ لإعـدادِ الطَّعامِ، وآباراً لا تَدري مـن أينَ جُرَّتْ إليهَا المياهُ العذبةُ، والأبراجَ العاليةَ الَّتي كانتْ تُوقَدُ فيها شُعلُ النِّيرانِ؛ لتكونَ إشاراتٍ يفهمُها الجنودُ في القلاعِ الأُخرى الرَّابضةِ على الهضابِ في أنحاءٍ أُخرى من هذا البلدِ التَّاريخيِّ، وفيها بِركةٌ للسِّباحةِ، وفيها نقوشٌ وكتاباتٌ تَروي قصَّةَ هذه المدينةِ، وفيها صورٌ منحوتةٌ على الصُّخورِ للأسودِ تَروي حكايةَ أبطالِ تاريخِـنا المشرِقِ.
وحينَما تصعَدُ إلى قِممِ الأبراجِ، ترى أمامَك السُّهولَ والهِضابَ منبسِطةً؛ وكأنَّها في قبضةِ يدِكَ، على الرَّغمِ من امتدادِها البعيدِ!
وإذا تأمَّلْتَ تاريخَ بناءِ القلعةِ وأنواعَ الحجارةِ الَّتي بُنيَتْ منْها، والتَّواريخَ الَّتي دُوِّنتْ على صخورِها، وقفْتَ في دهشةٍ أمامَ صوَرٍ غامضةٍ من هَذا التَّاريخِ، فالقلعةُ رومانيَّةُ الملامحِ، إسلاميَّةُ التَّطويرِ والتَّجديدِ، عثمانيَّةُ الصُّمودِ والاستمرارِ، فرنسيَّةُ التَّغريبِ والتَّحديثِ، عصريَّةُ التَّرميمِ والتَّمكينِ.
ويتساءَلُ المرءُ معَ نفسِهِ: وماذا فعلَ الرُّومانُ في هذهِ البِلادِ؟ هل كانُوا محتلِّينَ ودُخَلاءَ؟ أم كانُوا من سكَّانِ البلادِ الأصليِّين، ثَّم تغيَّر الَّزمانُ، فحلَّ محلَّهمُ العـربُ والمسلمونَ بعد انتشارِ الفتوحاتِ الإسلاميَّةِ؟!
لكنَّ التَّاريخَ يجيبُك بشفافيةٍ بأنَّهم كاُنوا محتلِّين، ولا يُمكنُ أن ننسَى احتلالَهم لمملكةِ تَدْمرَ، وأسرَهم ملِكتَها زنُّوبيَا وقضاءَهُم على حضارتِها.
وتارةً أُخرى تَرى آثارَ المسلمينَ واضحةً كعينِ الشَّمسِ من خلالِ بعضِ الأقسامِ، فالكتاباتُ الإسلاميَّةُ سِمةٌ مميَّزةٌ، وعلامةٌ بارزةٌ تدلُّ على عظمتِهم وتأثيرِهمْ في التَّاريخِ. كيفَ لا؟!
أَوَلمْ تكنْ هذهِ القلعةُ رمزاً لصُمودِ بطَلِ الشَّرقِ العظيمِ صلاحِ الدِّينِ الأيُّوبيِّ أمامَ زحفِ الصَّليبِّيينَ وهجماتِهم المتتَاليةِ على المشرِقِ الإسلاميِّ، كمَا كان غيرُها من القلاعِ والحصُونِ المتربِّعةِ على ذؤاباتِ الجبالِ الشَّامخةِ، كقلعةِ دمشْقَ وحِمْصَ وحمَاةَ وحلَبَ ومَرْقبَ وشِيزَرَ ومِصْيافَ وبَعْريْنَ وجَعْبرَ.. رموزَ النُّسُورِ أبطالِ الفتوحاتِ الإسلاميَّةِ الَّذينَ أضاؤُوا تاريخَ الإسلامِ، فكانُوا كوكبةً يُستَضاءُ بنورِ جهادِهِم في كلِّ زمنٍ من أزمانِ التَّاريخِ؟
كلُّ قلعةٍ لا تستطيعُ أنْ تَنسَى عظمةَ صلاحِ الدِّينِ الأيُّوبيِّ، هـذا البطلِ الَّذي صنعَ تاريخاً مشْرقاً حافلاً بالنَّصرِ والمجدِ والغارِ، حينَ وحَّدَ كلمةَ المسلمينَ، مُقتدياً بالبطلِ الفذِّ الشَّهيدِ نورِ الدِّين زِنْكي بنِ البطلِ عمادِ الدِّين زِنْكي، فرصَّ الصُّفوفَ وقادَ الجيوشَ مستضيئاً بسِيَرِ الكواكبِ النيِّرِة التي سبقتْهُ إلى فِردَوسِ النَّعيمِ بعدَ أن شرتْ نفوسَها في اللهِ، وإعلاءِ كلمةِ الحقِّ والدِّينِ الحنيفِ، وتاجُ مفرِقِهم في ذلكَ الرَّسولُ الأعظمُ محمَّدٌ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ثمَّ صحابتُه الأفذاذُ وتابِعوهُم المخلصونَ، فالتَّاريخُ عبِقٌ نشوانُ بسيرِهم الصَّالحةِ.
كمْ تمنَّيتُ أن يُصنَع تمثالٌ لبطلِ التَّصدِّي للحملاتِ الصَّليبيَّةِ أمامَ هـذهِ القلعةِ الصَّامدةِ، على شاكلةِ التِّمثالِ الذي نُحتَ له أمامَ قلعةِ دمشقَ! فهو يُوحي بالرَّهبةِ والجلالِ، ويجعلُك تشعرُ بنشوةِ النَّصرِ والبطولةِ وإشراقةِ التَّاريخِ العربيِّ الإسلاميِّ الَّذي غَدَا امتدادُه في الحاضرِ صفحاتٍ من اليأسِ والمرارةِ والخيبةِ والهزيمةِ والتَّفكُّكِ والضَّعفِ والذُّلِّ والخنوعِ والاستسلامِ! لم يعُدْ إنسانُنا يشعرُ بوجودِه إلَّا حينَما يقفُ أمامَ ذلكَ التَّاريخِ المشرِّفِ، ولم يعدْ إنسانُنا العربيُّ المسلمُ يشعرُ بهُويَّتِه الحقيقيَّةِ إلَّا بالانتماءِ إلى ذلكَ التَّاريخِ الَّذي يشهدُ العالمُ، وتشهدُ السَّماءُ والأرضُ على عظمةِ مَن صنعُوهُ بشكيمةٍ من حديدٍ وعزيمةٍ من فولاذٍ وإيمانٍ من ذهبٍ!
يَحارُ الفكرُ، ويعجزُ القلمُ، وتَغصُّ آلاتُ التَّصويرِ، وتضيقُ العقولُ ذرعاً، ويعجزُ الخيالُ عنِ الوصفِ أمامَ صفحاتِ تاريخِ هذهِ القلعةِ الصَّامدةِ في وجهِ أعدائِها من غُزاةٍ مرُّوا بها مرورَ الرِّياحِ من النَّوافذِ، والشَّامخةِ أمامَ أعدائِها من عواملِ الطَّبيعةِ الَّتي لا تُبقِي ولا تذَرُ حيَّاً أو جمَاداً إلَّا وتنالُ منهُ ما تنالُ بصفعَاتٍ مِن أعاصيرِ الزَّمنِ العاتيةِ أو لفحاتٍ من لهيبِ النَّارِ السَّاطيةِ أو صدماتٍ من زلازلَ مدمِّرةٍ قاضيةٍ.
الطُّلَّابُ يتساءَلونَ ويَسْألون! وأنا أُجيبُ عمَّا ألغزَ عليهِم، وهم يرافقُونَني خطوةً تلوَ خطوةٍ. وهكذا أمضَيْنا ساعتينِ منَ الوقتِ؛ وكأنَّها ثوانٍ! كنَّا ما نزالُ نشعرُ بالحاجةِ إلى مزيدٍ من البحثِ والتَّجوُّلِ والاستقصاءِ، لكنَّ سيفَ الوقتِ داهمَنا دونَ شفقةٍ، فراحَ يدعُونا إلى الرَّحيلِ؛ لأنَّ برنامجَ الرِّحلةِ سيقودُنا إلى أماكنَ أُخرى. وانطلَقْنا من هناكَ إلى نبعِ الفَوَّارِ قربَ بلدةِ (الزُّوَيتِينَة)، وحطَّتْ بنا الحافلاتُ على مشارفِ النَّبعِ في السَّاعةِ الثَّانيةَ عشْرةَ ظُهراً.
النَّبعُ في مغارةٍ منحدِرةٍ يبدُو كالسِّرِّ في وادٍ سحيقٍ، ومياهُهُ عذْبةٌ رقراقةٌ تفترُّ ضاحكةً للحياةِ، لكنَّها تُخبِّئُ في ابتسامتِها أسراراً أعظمَ مـن أسرارِ الموناليزا؛ إذْ إنَّ هذهِ الابتسامةَ سَرعاَن ما تتحوَّلُ إلى بركانٍ، فتتدفَّقُ المياهُ من أعماقِ الأرضِ بغزارةٍ لتسيلَ على خدودِ الأرضِ، وعندما يهدأُ رَوعُ اليُنبوعِ، تنحسِرُ المياهُ إلى الخلفِ، وينحدرُ إليهِ المسافرُ على درجٍ بانخفاضِ مترينِ تقريباً، أمَّا حينمَا تثورُ المياهُ في الأعماقِ، فإنَّها تتقاذفُ كالحِممِ، فتفورُ وتصعَدُ عبرَ هذا الدَّرجِ الحجريِّ، حتَّى تصعَدَ إلى أعلى وتسيلُ في مجْرى ساقيةٍ إلى نهرٍ قريبٍ.
وقد سُمِّيُ النَّبعُ بهذا الاسمِ (الفوَّار)؛ لأنـَّه يفورُ كلَّ شهرٍ مرَّةً أو أكثرَ، فتَسيلُ مياهُهُ غزيرةً مُهرَاقةً؛ وكأنَّها في دورةٍ شهريَّةٍ خَصَّها الخالقُ بالأنُوثةِ والإخْصابِ، فالدَّورةُ الأنثويَّةُ تُنتِجُ معها بُويضاتٍ تشرئِبُّ في مرحلةِ الإخصابِ لتُعانقَ وتُلاقِحَ ذلكَ الحيوانَ المنويَّ الذَّكريَّ الَّذي يفوزُ بكأسِ البطولةِ في الوصولِ إلى سريرِ الرَّحمِ، وبذلكَ يتواصلُ النَّسلُ البشريُّ كما قدَّرهُ الخالقُ عزَّ وجلَّ.
أمَّا مياهُ اليُنبوعِ، فإنَّها تتدافعُ لتُلاقِحَ عناصرَ الطَّبيعةِ، فيَنتجَ عن تناكُحِها نسْلٌ من الخُضرةِ والجَمالِ يحيَا ويموتُ، كما يموتُ النَّسلُ الآدميُّ في دورةِ الحياةِ البشريَّةِ.
والنَّبعُ منهَلٌ ثرٌّ لإرواءِ البَشرِ، ومصدرٌ ثريٌّ لرَيِّ الحقولِ، تحيطُ به المقاصفُ والمتنزَّهاتُ، في جوٍّ رومانسيٍّ تعبقُ منه رائحةُ الخُضرةِ والنَّدى والشِّواءِ.
جلسْنا تحتَ الأشجارِ الباسقةِ؛ لنتناولَ فطورَنا، وأمضيْنا حوالي ساعتينِ نسرحُ ونمرحُ بين أحضانِ الطَّبيعةِ الخلَّابِة في ذلكَ الوادي الَّذي يتدفَّقُ من مغارتِه نبعُ الفوَّارِ الَّذي فارَتْ معه مشاعرُنا، وتأجَّجتْ حبـَّاً وشغفاً؛ لتنسابَ مع أنغامِ الموسيقَا والغناءِ والرَّقصِ والضَّحِكاتِ والابتساماتِ.
ثمَّ انطلقْنا إلى عُيونِ الغارِ في صافِيْتا، ووصلْنا إليها في السَّاعةِ الثَّانيةِ والرُّبعِ بعدَ الظُّهرِ، وأوَّلُ ما لاحَ من مناظرِها ذلكَ النَّهرُ الجاريْ الَّذي تصُبُّ فيه المياهُ العذبةُ من ينابيعَ تتدفَّقُ على جانبَي النَّهرِ، الطَّبيعةُ هادئةٌ، والأشجارُ باسقةٌ، والعيونُ الرَّقْراقةُ ناطقةٌ، والظِّلالُ الرُّومانسيَّةُ وارِفةٌ.
كلُّ شيءٍ يدعُوكَ للتَّأمُّلِ والتَّمتُّعِ: المياهُ الصَّافيةُ، والنَّهرُ الجاريْ المترَقرِقُ الأمواهِ، والطَّبيعةُ الخضراءُ الَّتي تكسُوهَا الوُرودُ والأزهارُ والأشجارُ أبْهى الحُلَلِ، والأبنيةُ والمتنزَّهاتُ والمقاصفُ المتناسقةُ المتناهيةُ الجمالِ.
وقفْنا على ذلكَ الجسرِ الواصِلِ بينَ ضفَّتَيِّ النَّهرِ على ارتفاعٍ لا بأسَ به، وكان يرتجُّ تحت قدمَيَّ؛ وكأنَّه يُنذرُ بزلزالٍ أرضيٍّ، ويبدُو من ملامِحهِ القديمةِ أنَّه هشُّ البناءِ، ضعيفُ الصَّنعةِ والإتقانِ، يكلِّمُكَ في صمتٍ بلغةٍ لا تكادُ تفهمُها في الَّلحظةِ الرَّاهنةِ، وكانتِ المياهُ الزَّرقاءُ تبدُو من تحتِنا سماءً تحتَ سماءٍ، ويشعرُ الواقفُ بأنَّه يسبحُ في الفضاءِ!
ثمَّ علَوْنا قليلاً إلى منطقةٍ مجاورةٍ للينابيعِ، يقبَعُ فيها (مزارٌ) تُحيطُ به الأشْجارُ الكثيفةُ العاليةُ، فجلَسْنا هناكَ لنتناولَ طعامَ الغَداءِ، فراحَ كلٌّ منَّا يُعِـدُّ شيئاً من أجلِ تحضيرِ الطَّعامِ، وتناولْنا طعامَ الغداءِ حوَالَي السَّاعةِ الخامسةِ.
وأمضَيْنا ساعاتٍ مـنَ المتعةِ والجمالِ، وكم تمنَّيْنا أن يبسُطَ الوقتُ جناحَيهِ هُنا، حتَّى لا يطيرَ بنا إلى مكانٍ بعيدٍ؛ لأنَّ النَّفسَ لا تُريدُ أن تُفارقَ مَواطنَ الجمالِ، ولكنْ هيهاتَ لناعورةِ الزَّمـنِ أن تتوقَّفَ عنِ الدَّورانِ، فسَرعانَ ما أدارَتْنا بأدراجِها؛ لتنقُلَنا إلى مِنطقةٍ أُخرى!
وغادرْنَا المكانَ إلى موقعِ (النَّبْعاتِ) على شاطِئِ طَرطُوسَ، وحطَّتْ بِنا مراكبُ النَّقلِ على الشَّاطئِ في السَّاعةِ السَّابعةِ مساءً، ولكنَّ رحلتَنا إلى هناكَ لم تكنْ ذاتَ هدفٍ معروفٍ؛ وكأنَّهـا كانَت على هامشِ السَّفرِ، كما أنَّ طائراً يحطُّ في مكانٍ ما ليستريحَ، ثمَّ ينطلِقَ؛ ليعودَ إلى حيثُ يَأْوي!
وقفْنا أمامَ الشَّاطئِ والشَّمسُ تُودِّعُ نهارَها؛ لتقضيَ نَحْبَها مُوزِّعـةً على الأفقِ لونَ الوَرْسِ، وتبدُو صفحةُ البحرِ حالمةً بجمالِ الحياةِ!
وحينَ بدأَ الشَّاطئُ بالنُّعاسِ، أخذْنا نرقُصُ وندبُكُ ونُغنِّي على أنغامِ المِزمارِ وضرباتِ الطَّبلِ، ولسانُ حالِنا يقـولُ للبحرِ: أيقظْ جفونَك، فمازالَ الوقتُ مبكِّراً للأحلامِ؛ ولكنَّ البحرَ غرقَ في نومِه، وأخذتْ آلاتُ التَّصويرِ تلتقِطُ مشاهدَه، وهو يغْفُو؛ ليحلُمَ ليلتَه وتحلُمَ في أعماقِه كلُّ مخلوقاتِ اللهِ من الكائناتِ!
يا إلهيْ! ما أعظمَ قدرتَكَ! وما أجَلَّ روعتَكَ! اليابسةُ غرِقَت في نومِها، وبدأَ معَها البحرُ يُعلنُ عن سُباتِه في أعماقِه، لكنَّ أمواجَهُ تغدُو وتروحُ كشعرِ صبيَّةٍ تتلاعبُ بها النَّسماتُ!
ومضَتْ ساعةٌ مـن المرحِ والفرحِ وقلوبُنا سَكْرى بنشوةِ الغناءِ والرَّقصِ والدَّبكةِ، وما لبِثَ أن اقتربَ منَّا شُبَّانٌ تُوحِي أشكالهُم وملامحُهم بأنَّهم من رجالِ (شيخِ الجبلِ) فاقتربُوا منَّا يتلاعبُون، ونصحُونا بالرَّحيلِ مباشرةً، وعندمَا استوضَحْنا الأمرَ، قالُوا: إنَّ جماعةً من شذَّاذِ الآفاقِ المتمرِّدينَ على الأعرافِ سَتأتي بعدَ قليلٍ، فيُجَنُّ جُنونُهم، ويُطلِقون النَّارَ في الهواءِ وعلى النَّاسِ… فتفهَّمْنا الموقفَ، وقطعْنا أوتارَ النَّشوةِ والفرحِ، قبلَ أن تُقطعَ أوصالُنا أشلاءً متراميةً على السَّبعِ نبعَاتٍ، وعُدْنا أدراجَنا سالمينَ.
وانتهَتِ الرِّحلةُ، لكنَّ ذكرياتِها لم تنتَهِ.. وعُدنا أسفارَنا إلى حمصَ، وحطَّتْ بنا القافلةُ في السَّـاعةِ التَّاسعةِ والنِّصفِ أمامَ مسجدِ البطلِ العبقريِّ خالدِ بنِ الوليدِ الَّذي خلَّدهُ التَّاريخُ؛ لعظَمةِ بطولاتِهِ وعبقريَّتِه القياديَّةِ العسكريَّةِ الفذَّةِ. وقد بدَاْ المسجدُ آيةً من الجمالِ بين أحضانِ الأشجارِ والورودِ، وعيونُ المصابيحِ تبثُّه أضواءَها، فيبدُو صرْحاً متألِّقاً من النُّورِ في حلكِ الظَّلامِ!
وأمضيْنا هناكَ ساعةً من الوقتِ، وتناولْنا الحلَوِيَّاتِ الحمـصيَّةِ والمرطِّباتِ، ثمَّ عدْنا إلى نيصافَ، والكَرى يُدغدِغُ أجفانَنا، ووصلْنا في السَّاعةِ الحاديةَ عشْرةَ والنِّصفِ ليلاً، وبقيَتْ أمامَنا مسافةُ الطَّريقِ من نيصافَ إلى قريتِنا (حُوَّيْرِ التُّركمانِ) القابعةِ بينَ الجبالِ، المختبِئَةِ بينَ الحقولِ والبساتينِ، الغَارقةِ في أحلامِ الأشْقيَاءِ، تغُـطُّ في سباتٍ عميقٍ، ولم تكنْ معنَا وسيلةٌ للنَّقلِ، فمشيْنا على الرَّغمِ من ضَعفِ العزيمةِ وشدَّةِ النُّعاسِ، حتَّى وصلْنا وغابتْ عيونُنا وغابتْ معهَا أحلامُنا.
وانقضَتِ الرِّحلةُ ولم تتركْ خلفَها سوَى الذِّكرياتِ (وما الحياةُ الدُّنيا إلَّا لهْوٌ ولعبٌ). فكمِ انقضَتْ رحلاتٌ! وكمْ مرَّتْ ذكرياتٌ! يموتُ الإنسـانُ ويفنَى، ولا تبقَى من تاريخِه المفْعَمِ بالأحداثِ سـوى الذِّكرياتُ! وأجملُ الذِّكرياتِ ما سطَّرَه يراعُ الأديبِ بكلِّ صـدقٍ وأمانةٍ وموضوعيَّةٍ عن الحياةِ وما تكتنفُه في أحضانِها من أحـداثٍ وتفاعُلاتٍ!
إنَّ أصدقَ الذِّكرياتِ ما يجعلُك تعيشُ في زمنِ حدوثِها، وكأنَّك صاحبُ الذِّكرياتِ، وإنْ كانتْ مْنتبذِةً ركناً قصِيَّاً عن زمانـِك ومكانِك! فمَن منَّا لا يطربُ ولا يتأثَّرُ ولا ينفعِلُ حينَ يقرأُ مذكِّراتِ أدبائِنا وكتَّابِنا وشعرائِنا وعلمائِنا في أعمالهِم الَّتي خلَّدتْهم، وكانت تاريخاً وسِجلّا ًحافِلاً لعصورِهم وأزمنتِهم؟! ومَن منَّا لا يبكِي حينَ يقـرأُ كتابَ العبَراتِ للمنفَلوطيِّ أو السِّيرةَ الذَّاتيةَ للشُّعراءِ والأدباءِ الذينَ رسمُوا ألوانَ المرارةِ والأسَى على دفاترِ ذكرياتِهم صوَراً تُذيبُ قلوبَ الجماداتِ قبلَ أن تذوبَ قلوبُ البشريَّةِ!!
مصياف في 17\7\1997م
Recommend0 هل أعجبك؟نشرت في مشاركات الأعضاء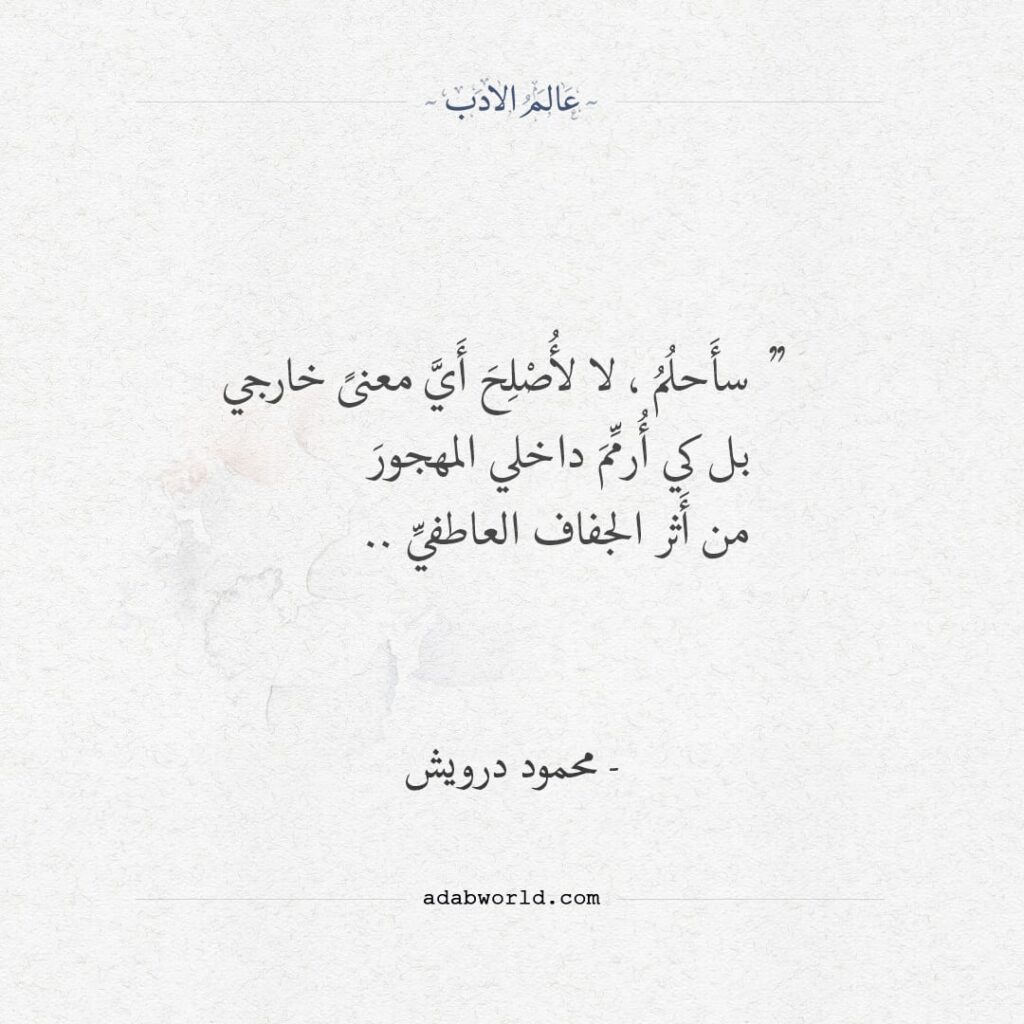

تعليقات