أنقذْتُ غريقاً
النّاسُ يتراكضُون.. أصواتُهم تتعالى: غريقٌ.. غريقٌ!
أخذتُ أركضُ معهم، وما هي إلّا لحظاتٌ، وإذا بجماعةٍ تحملُ الغريقَ، وإذ به شابٌّ في مقتبلِ العمرِ يحملُونه على نعشٍ، جاؤُوا به من نهرِ السّارودِ الواقعِ في منحدرٍ عند أسفلِ قريةِ عينِ حلاقيم.
تأمّلتُ هذا الغريقَ الذي بدتْ على ملامِحه أنّه ودّع الحياةَ، لكنّ فكري ما كان ليصدِّقَ أنّه مات، وما زال يقيني يأبى أن يموتَ هذا الفتى اليافعُ.
اندفعتُ كالنّسرِ، وأخرجتُه من النّعشِ، وألقيتُه ظَهراً على الأرض، أحسستُ بأنّه ما زال حيّاً، فقد رأيتُ يدَه تتحرّك.. وما هي إلّا ثوانٍ حتّى أخذتُ أضغطُ على بطنِه بسرعةٍ، فراح يتقيّأُ ماءً وتراباً بكميّاتٍ هائلةٍ.. تابعتُ العملَ بكلتَي يديَّ ضغطاً ورفعاً، إلى أن فتحَ عينيهِ، ورحتُ أنفخُ بأنفاسي على فمِه وأنفِه، كرّرتُ العمليّةَ مرّاتٍ عديدةً، وفجأةً نهض كالفرسِ الذي أصابتْه كبوةٌ مفاجئةٌ، فأبى أن يكونَ فريسةَ كبوتِه، فوثب كالبرقِ يتحدّى الموتَ، وعندما صحَا نظرَ إليّ نظرةً ملؤُها الامتنانُ والتّقديرُ، وقبّلني وكأنّني أخوهُ، فرحتُ أهنّئُه على سلامتِه وأقبّلُه أيضاً.
نظر إليّ الحاضرونَ نظراتٍ تُوحي بالفخرِ والاعتزازِ، ولكنّ عيونَهم لا تكادُ تصدّقُ.. شابٌّ غريب! كيف حضرَ؟ ومن أين جاءَ؟ يا لَلقدَر! كيف استطاع أنْ يُنقذَ هذا الفتَى بعد أن أيقنَ الجميعُ أنّه ودّع الحياةَ وقضَى نحبَه!؟
رحتُ أتساءلُ في ذهني: ما الّذي جاء بي في هذِه اللّحظةِ إلى هذه البلدةِ (عين حلاقيم) الّتي درستُ فيها المرحلةَ الثّانويّة، ونلتُ منها الشّهادةَ الثّانويّة العامّة منذُ أعوامٍ وأعوامٍ خلتْ؟! ثمَّ إنّني تخرّجتُ من الجامعةِ، وأصبحتُ مدرِّساً، وتركتُ بلدي كلَّه خلفَ البحارِ والصّحارى، وأنا الآنَ في دولة الإماراتِ العربيّةِ المتّحدة التي تبعدُ آلافَ الكيلو مترات عن موطِني؟ فما الّذي حملَني بهذه السُّرعةِ إلى هذه البلدةِ حتّى أرى هذا المشهدَ؟! يا لَلعجبِ أمرٌ غريبٌ حقّاً، سبحانَ اللهِ!
وما هي إلا هُنيهةٌ، مددتُ بصري لأرى النّاسَ من حولي، وأتأكّدَ من شخصيّةِ الغريقِ، ففتحتُ عينيَّ، ورحتُ أتأمّلُ: أين هـذا الغـريقُ؟ وأين هؤلاءِ النّاسُ؟ لم أرَ نفسي إلّا في جنحِ الظّلامِ على سريري في غرفتي التي تقعُ على شاطئِ الخليجِ العربيِّ! وأخيراً أيقنتُ أنّني كنتُ في حلمٍ، ويا لَروعةِ الحلمِ!
لقد شعرتُ بارتياحٍ طيلةَ ذلك الصّباحِ؛ لأنّني ما زلتُ معتقداً بأنّني أنقذتُ غريقاً حتّى ولو كان حلماً!
وربّما كان هذا الحلمُ نتاجَ ذكرياتٍ من المعاناةِ والكفاحِ عشتُها أيّامَ كنتُ في مرحلةِ الثّانويّةِ العامّة، حين كنتُ طالباً على مقاعدِ الدّراسة في ثانويّة عينِ حَلاقِيمَ، إذ كنّا نستيقظُ قبلَ العصافيرِ، وننطلقُ من قريتِنا القابعةِ بين الجِبالِ ( حُوّير التُّركمان.. نسبةً إلى شجرِ الحورِ العالي على طرفَي طريقِ العينِ الّتي تَروي سكّانَ القريةِ ومزروعاتِها) والتي تبعدُ عن مدرستِنا الثّانويّةِ في عينِ حلاقيمَ مسافةً تناهزُ العشرينَ كيلو متراً، كنّا نقطعُها ذهاباً وإياباً مشياً على الأقدامِ، عابرينَ أكثرَ من أربعةِ أنهارٍ، لكنّ امتحانَ البطولةِ والمغامرةِ يبدأُ مع هطولِ الأمطارِ وتساقطِ الثّلوجِ، إذ تَثورُ ثائرةُ نهرِ السّارودِ المشهورِ في الخرائطِ الجغرافيّةِ، فتأتي السُّيولُ الجارفةُ كحِممِ البراكينِ صابّةً جامَ غضبِها على الأراضي الزّراعيّةِ جارفةً الحجارةَ والأتربةَ، حاملةً في أحشائِها حكاياتِ الفقراءِ البؤساءِ والفلاّحينَ الأشقياءِ.
وذاتَ يومٍ قرّر زملائِي الثّلاثةُ من قريتِي الهربَ من الحصّةِ السّادسةِ، حصّةِ الفيزياءِ، وحاولُوا إقناعي بأنَّ السّماءَ عابسةٌ بغيومِها الدَّاكنةِ، ربّما ستصفعُنا بحبّات أمطارِها بعد قليلٍ، كما أنَّ نهرَ السّـارودِ يتوعَّدُنا بطوفانِه الّذي لا يُبقي ولا يذرُ.. وليس ثمّةَ جسرٌ للعبورِ عليهِ.
فكّرتُ في الأمرِ قليلاً، إلّا أنّ إرادةَ التّحدّي وعشقَ المقعدِ الدِّراسيِّ، ووُدَّ زملائي وزميلاتي استنهضتْ هِممي، وأبتْ إلّا الإصرارَ والتّحدّي، ولو جاء طوفانُ نوحٍ.
غادرَ زملائي الثّلاثةُ مقاعدَ دراستِهم قبلَ إنذارِ السّماءِ ببرقِها ورعدِها، ومكثتُ على مقعدي يتيمَ قريتي بينَ زملائي وزميلاتي مستمتِعاً بحصّةِ الفيزياء، وما هي إلّا دقائقُ، حتّى اكفهرَّ وجهُ السّماءِ، وزحفتْ جافلُ السُّحب الدّاكنةِ على الجبالِ، وتسلَّلتْ رائحةُ حبّاتِ الغيثِ المدرارِ إلى أنفاسِي، واحلولَكتِ الطّبيعةُ بسدولِ الظّلام، وكأنَّ اللّيلَ قد أطبقَ معلِنا رحيلَ ضياء النّهارِ! وما إن انتهتِ الحصّةُ الأخيرةُ، حتّى أطبقتْ عليْنا السّماءُ، وفاضتْ دموعُها على الطّبيعةِ، تلثمُ خدودَها راسمةً آثارَ عشقِها وعنفوانَ وصالِها على زجاجِ النّوافذِ الّتي راحتْ تتراقصُ فرحاً في ليلةِ الاستِحمامِ لزفافِها من غبارِ الأيّامِ الغابرةِ.
انصرفَ الطُّلّابُ إلى بيوتِهم مع وقعِ ضرباتِ حبّاتِ المطرِ على مظلّاتِهم، ودعاني بعضُهم لأبيتَ ليلتِي عندَهم، ونصحُوني بعدمِ المغامرةِ، وظلّتْ أيديهم تشدُّني للبقاءِ، لكنَّ كفَّ التَّحدّي كانت أشدَّ وأعتَى، فانتزعَتْني من بينِ أكُفِّهم ودفعتْني إلى الرّحيلِ.
حزمْتُ كتبي ودفاترِي، وضممْتُها إلى صدرِي، وكفَّنْتُها تحتَ ملابسي خوفاً عليها من أن تعبثَ بها حبّاتُ المطر، وحملتُ مظلّتي الشّتويّةَ لعلَّها تردُّ عن جسدِي صفعاتِ المطرِ، وانحدرْتُ مع السُّيولِ صوبَ النّهرِ، وما إنْ حطّتْ بي قدمايَ على حافّتِه، حتّى كان هديرُه يصفعُ أذنيَّ، ويطرقُ مسامعِي بمطارقِ التّحذيرِ مخاطباً فكرِي: عدْ من حيثُ أتيتَ، فأنا ثائرٌ وجوفي يجيشُ بالصُّخورِ والأتربةِ والحَصى، ومِزاجي مُعكَّرٌ.
لم أصغِ لنصائحِ النّهرِ، وصمَمْتُ مسمعِي عن نداءاتِه، وقرَّرتُ التّحدّي، وعندما هبطتْ قدمايَ إلى قاعِه، كانت الحجارةُ تدكُّ رجليَّ، لم أبالِ بخطورةِ المعركةِ الّتي تنتظرُني، وفي غَمـرةِ انهماكِي بحركةِ قدميّ، سقطتْ حقيبتِي من فراشِها الدّافئِ على صدرِي، وقرَّرتِ الرّحيلَ إلى البحرِ، فنسيْتُ رجليَّ، وانطلقتُ وراءَ حقيبتي الهاربةِ منّي، فأمسكتُ بها، وأعدتُها إلى مخدعِها تحتَ سُترتي، وضيّقتُ الخناقَ عليها.
وقرّرتُ التّراجعَ، لعلّني أستدركُ ثغراتِ خطّتي في اقتحامِ المعركةِ، وعدتُ أدراجي، وأمسكتُ بجذورِ أشجارِ التُّوتِ الّتي عرَّتْها مياهُ النّهرِ، واندفعتُ نحو سيقانِها أستمدُّ منها قوّةَ الصُّمودِ، واسترحْتُ استراحةَ المحاربِ؛ لأُعِدَّ خطّةً جديدةً للمواجهةِ. ولمحتُ شجرةَ زيزفونٍ مقطوعةٍ من أسفلِ جذعِها، فحملْتُها وألقيتُها في عرضِ النّهرِ، حتّى ثبتتْ بين الصّخورِ المنغرسةِ في جوفِه، وقفزتُ نحوَها غارساً قدميَّ عندَ جذعِها، ورحتُ معتصماً بقدَري، واحتضنْتُها احتضانَ الحبيبِ لحبيبِه، فقطعتُ نصفَ الشَّوطِ في وسطِ النّهرِ، وبقيَ أمامِي نصفُ الشَّوطِ الآخرِ، وكان أسهلَ عليَّ وأقلَّ خطورةً؛ وذلك لقلَّةِ عمقِه، وانكشافِ الصُّخورِ أمامَ ناظريَّ.
ودَّعتُ الزَّيزفونةَ، وتابعتُ المسيرَ، مثبِّتاً قدميَّ في قاعِ النّهر، إلى أن وصلتُ إلى الضِّفّةِ الأخرى، فصعدتُ أتفقّدُ أمتعتِي، وأتلمّسُ رجليَّ، إن تصدَّعتْ من وقعِ ضرباتِ الحجارةِ عليها، وحمِدتُ اللهَ على سلامتي، وقرّرتُ عَودَ المسيرِ إلى مأوايَ، حيثُ عيونُ الأهلِ تنتظرُ عودتي عَوداً بهيجاً لفتاهَا الغائبِ منذُ انطلاقِ الرُّعاةِ إلى البراري مع شياهِهم بحثاً عن الكلأِ.
حينما قرعتُ جرسَ بابِ الدّار، كانت لهفةُ الانتظارِ حاميةً كمدفأةِ الشّتاء، شعرتُ بالدِّفءِ والحنانِ، واستبدلتُ سترةَ النّومِ بملابسِي المغرَورِقَةِ بالماءِ والتُّراب من قاعِ النّهر، واحتضنتُ المدفأةَ تحتَ مظلّةِ حنانِ أبي وأمّي ورعايةِ أخَواتي، ثمّ تناولْنا الغداءَ، وشعرتُ بالرّاحةِ تَسري في أوصالِي، وتعلَّمتُ من درسِ الفيزياءِ أعمقَ فيزياءِ التّحدّي والإصرارِ، وأنضجَ قوانينِ المواجهةِ مع قِوى الطّبيعةِ.
هذه الحكايةُ الفيزيائيّةُ الّتي نامت في عقليَ الباطنيِّ منذُ خمسةٍ وعشرينَ عاماً، قد هبطتْ إلى أحلامي على شاطئِ الخليجِ العـربيِّ، وأينعتْ ثمارُها قطفاً من المشاعرِ الإنسانيّةِ النّبيلةِ ورفداً ثريّاً في حبِّ مساعدةِ الآخرينَ ومناصرةِ المنكوبينَ والضُّعفاءِ المضطهدينَ في شتّى بقاعِ الدُّنيا.
حينَما قصصْتُ الحلمَ على أصدقائِي، أجمعُوا على أنّني أحملُ نفْساً إنسانيّةً عظيمةً، وروحاً خيّرةً تحبُّ السَّلامَ، وأخلاقاً عاليةً تتفانى في سبيلِ ترسيخِ القيمِ الإنسانيّةِ النّبيلة.
وفي نهارِ ذلك اليومِ أمسكتُ بجريدةِ الخليجِ الإماراتيّةِ، أقرؤُها، وإذا بصورةِ فتاةٍ ترفعُ جرّاراً، وتنجحُ في إنقاذِ سائقِه من براثنِ عجلاتِه، ورحتُ أقرأُ الخبرَ بشغفٍ، وقد ذكَّرني بحلمِيَ الماضي، أنقذتُ شابّاً بعد أن أيقنَ الجميعُ بأنّه لفظَ أنفاسَ الحياةِ، وها هي فتاةٌ ترفعُ جرّاراً تعجزُ عن إزاحتِه هِممُ الرّجالِ.
وملخّصُ المقالةِ أنّ هذهِ الفتاةَ رأتِ الحادثَ أمام ناظرَيها، ثمّ سمعتْ صوتَ استغاثةِ رجلٍ يشكو من ألمِ ساقيهِ، فسرعانَ ما هبّت لنجدتِه واندفعَت كالبرقِ نحوَ الجرّارِ، وراحتْ ترفعُ عجلاتِه عن ساقَي الرّجلِ، وما هي إلّا هُنيهةٌ، حتّى خلّصتِ الرّجلَ المنكوبَ من وطأةِ العجلاتِ، وقد أُصيبَت الفتاةُ نفسُها بالدَّهشةِ، فلا تكادُ تصدّقُ ما حصلَ معها، فهي لا تكادُ ترفعُ ابنَها الكبيرَ إلّا بشقِّ الأنفسِ. فكيف استطاعتْ أن ترفعَ جرّاراً يزنُ نصفَ طنٍّ؟!
إنّني لا أستغربُ هذهِ الحادثةَ ولا أمثالَها؛ لأنّ الإنسانَ يحملُ في أعماقِه قوّةً روحيّةً عجيبةً، سرعانَ ما تمنحُ الجسدَ قوّةً عظيمةً لا يعلمُها إلّا اللهُ عزَّ وجلَّ، فيتحوّلُ الضَّعفُ إلى جسارةٍ وقدرةٍ لا يصدّقُها عقلُ الجاحدينَ، لكنْ تؤمنُ بها عقولُ وأرواحُ المؤمنينَ بعظمةِ اللهِ جلَّ وعلَا.
وفي مساءِ ذلك اليومِ جلستُ في فناءِ غرفتي عندَ الغروبِ أتأمّلُ السّماءَ، فشعرتُ بنشوةٍ روحيّةٍ عظيمةٍ، ويا لَسعادةِ هذهِ النّشوةِ!! فقد تحرَّرتُ من أدرانِ الحياةِ المادّيّةِ، وسمَوْتُ بفكري وروحي إلى السَّماءِ؛ لأعانقَ النُّجومَ، وألثمَ وجهَ القمرِ، حتّى نسيتُ كلَّ سفاسفِ الحياةِ اليوميّةِ المملَّةِ.
جاذبَني شعورٌ ملِحٌّ إلى المطالعةِ، فأمسكتُ مجموعةَ ميخائيلَ نُعيمة، ورحتُ أطالعُ ما كتبَه عن وجهِ بوذا، وما قالَه هذا الحكيمُ الهنديُّ: “أنا لستُ جسمي؛ لأنّه سائرٌ كلَّ لحظةٍ إلى الانحلالِ. وبانحلالِه ستنحلُّ وتفنَى كلُّ حاجاتِه وشهواتِه وملذَّاتِه وأوجاعِه. ولا يَبقى غيرُ حقيقتي -غيرُ (ذاتي) -غيرُ (أنا)، هي من (الذّاتِ العالميّة) الكائنةِ في كلِّ شيءٍ، وكلُّ شيءٍ فيها والتي لا تنقصُ ولا تزيدُ. ولا تتحوّلُ ولا تتبدّلُ. فيها تلتقي الأزليّةُ والأبديّةُ. ومنها تنبثقُ كلُّ ذاتٍ. وإليها معادُ كلِّ ذاتٍ”.
“فالحكيمُ الحكيمُ مَن سهّلَ لذاتِه طريقَ العودةِ بإعتاقِها من روابطِ الوجودِ. إذ إنَّ مَن مات وفيه عطشٌ إلى الوجودِ، سيعودُ حتماً إلى الوجودِ. فالأرضُ تجذبُ محبّيها إليها، حتّى من وراءِ القبرِ، كما يَجذبُ المغناطيسُ الحديدَ حتّى من اللُّجّةِ”.
ثمّ رحتُ أقرأُ ما كتبَه ميخائيلُ نُعيمة عن الفيلسوفِ الصّينيّ لاوتسَه، وحلّقْتُ معه بفكري وروحي، وكأنّني أمسكتُ بأفكارِ هذا الفيلسوفِ، وكادتْ روحي تُجاذبُ روحَه، وشططْتُ أسبحُ في سماءِ فكرِه، وأُطلِقُ تأمُّلاتي عبرَ الزّمانِ والمكانِ، وكلُّ عبارةٍ تهزُّ وجداني وضميري، وباتتْ تُوقِظُ في نفسي تلك الأفكارَ الإنسانيّة الرّائعةَ التي انغمسَتْ في كياني الإنسانيِّ، فطفِقتُ أحلمُ، بل شعرتُ بإرادةٍ حقيقيّةٍ تُمكِّنُني من إنقاذِ الضُّعفاءِ والمظلومينَ والمنكوبينَ.
يقولُ لاوتسَه: “العظيمُ لا يُدرَكُ، والّذي لا يُدرك فهو القصِيُّ. والقصِيُّ أبداً يدنُو. الرّجلُ الحكيمُ ليس لقلبِه مقرٌّ محدودٌ. فهو يجدُ قلبَه في قلبِ كلِّ إنسانٍ. وهو يُعامِلُ الصّالحَ بالصَّلاحِ. ويُعاملُ الطَّالحَ بالصّلاحِ أيضاً. الرّجلُ الحكيمُ يضمُّ في قلبِه كلَّ القلوبِ. فيُعطيه النّاسُ أعيُنَهم وآذانَهم، ويعاملُهم كما لو كانُوا أبناءً له”.
ورحتُ أغوصُ في خاصرةِ كلِّ عبارةٍ، أستنضحُ معانيَها العميقةَ فيما كتبَه نُعيمةُ عن وجهِ المسيحِ عليه السّلامُ.
يقولُ المسيحُ منادياً ربَّه طالباً الغفرانَ لمن يتأمّلُون صلبَه: “أبتاهُ اغفرْ لهم لأنَّهم لا يعلمُون ماذا يفعلُون”. ويتساءلُ نعيمةُ: كيف لمثلِ هؤلاء أنْ يُدركُوا سمُوَّ حكمتِكَ القائلةِ:” لا تقاوِمُوا الشّرَّ” ؟ أنّى لهم أن يَفهمُوا، مثلما فهِمتُ، أنّ الأعمالَ والأقوالَ تَحبلُ وتلِدُ، كما تحبلُ النّساءُ وتلِدُ. فإنّ حَبِل الشّرُّ بالشّرِّ وَلَد شرّاً. وإنْ حبِلَ الخيرُ بالخيرِ وَلَد خيراً. وإنْ لم يكنْ للشّرِّ ما يَحبَلُ به من جنسِه انقرضَ من تلقاءِ ذاتِه”.
ولبِثْتُ أَهِيمُ بروحيَ العطْشى إلى المثالِ، وبفكريَ الولهانِ إلى الحقيقةِ، مع كلِّ عبارةٍ وكلِّ حكمةٍ وفكرةٍ نبيلةٍ تَسيلُ فيضاً عذباً على يراعِ نُعيمةَ.
وأعودُ إلى نفسِي؛ لأفسِّرَ كثيراً من جوانبِها الإنسانيّةِ على ضوءِ ما ينغرسُ في فكري ووجداني من حقائقِ عالَمِ الرُّوحِ، بعيداً عن البراقعِ التي يُسْدلُها عالمُ المادّةِ أمامَ بصيرتي، فأجدُني أقربَ إلى السَّماءِ من الأرضِ، وأراني بعيداً بعيداً عن النّاسِ. البشرُ منهمِكُون في لذّاتِهم وشهواتِهم، يلهثُون وراءَ المادّةِ لُهاثَ الأسودِ الضّاريةِ في مطاردةِ فرائسِها.
أمّا أنا فأعيشُ وحيداً مع ذاتي، لكنّني لا أشعرُ بالوحدةِ قطُّ، بل أشعرُ بأنَّ السّماءَ هي مسكَني ومأوايَ، وبأنَّ الطّبيعةَ الرّائعةَ الجمالِ هي ملجَئِي ومثوايَ، وبأنّ قدرةَ اللهِ تلفُّني برعايتِها الرّحيمةِ، فلا أُحسُّ بغربةٍ ولا بانفرادٍ، ولا يُخامرُني يأسٌ أو خيبةُ أملٍ، وإنّما أجدُ في روحي تواصُلاً حميماً مع السّماءِ، وانسجاماً فكريّاً مع ذاتي.
إنّ انتشائيَ الرّوحيَّ والفكريَّ والجسديَّ يدفعُني إلى الصَّمتِ كثيراً، وأبتعدُ عن الثّرثرةِ التي لا طائلَ منها غيرُ قتلِ الوقتِ والمواهبِ، ومن صفاءِ صَمْتي تَفيضُ روحي بينابيعِ المحبّةِ والعطاءِ، وينسابُ فكري بجداولِ التّأمُّلِ والإبداعِ والغـَورِ إلى أعماقِ الكونِ والحياةِ وفلسفةِ الوجودِ والانعتاقِ من أسْرِ الجمودِ والقوالبِ الصَّنميَّةِ المتغوِّلةِ في الأعرافِ والمفاهيمِ المتوارَثةِ والمنقوشةِ في الأفهامِ والألبابِ.
إنّني ضعيفٌ ولا أدّعي القوَّةَ؛ لأنّني مُدرِكٌ سرَّ ولادتي من جيفةٍ قذِرةٍ، وسأعودُ ضعيفاً حينما يحينُ خريفُ حياتي، ويضمَحِلُّ عنفوانُ صِبْوتي، وفقيرٌ إلى اللهِ، ولو كنزتُ كلَّ أموالِ الدُّنيا، وبسيطٌ لا أدّعي الحكمةَ، وجاهلٌ لا أرقى إلى درجةٍ واحدةٍ من سلَّمِ العلماءِ، فكيف بي أمامَ الغيبِ؟! وإنسانٌ عاديٌّ لا أنسُبُ إلى نفسِي غيضاً من فيضِ العظمةِ.
بمثلِ هذهِ الرُّوحِ يحكمُ الحكماءُ على إنسانيَّتي، وبمثلِ هذا الفكرِ يُقدِّرُ المثقَّفونَ قدْرَ أفكاري، وبمثلِ هذا التّواضعِ أجدُ مأوايَ في قلوبِ البشرِ.
إنَّ ما حلَمْتُ به لم يكنْ إلا لمعاناةٍ إنسانيّةٍ في أعماقِ روحي وفكري، وما هي مُناجاتِي لعناصرِ الطّبيعةِ، أستَجْديها لتُخلِّصَ البشرَ من آلامِ الحياةِ؛ لتُنقذَهم من ضلالاتِهم الدُّنيويّةِ، إلّا صدىً عميقاً لما يعتصِرُ روحي وعقلي ووجداني وضميري.
دبي في 15/4/1998
Recommend0 هل أعجبك؟نشرت في مشاركات الأعضاء

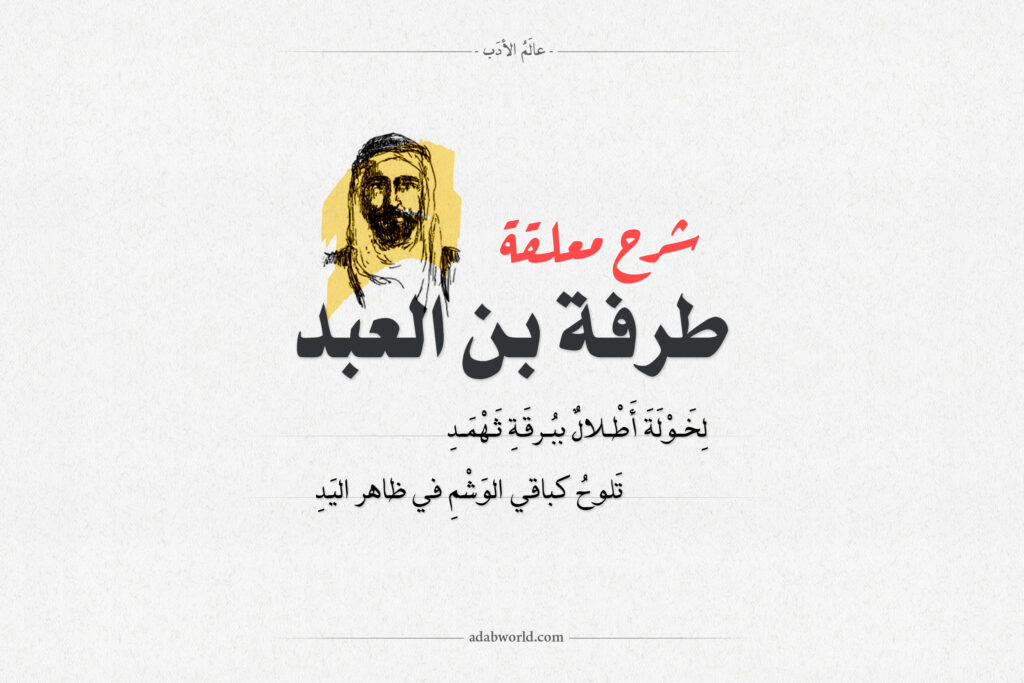
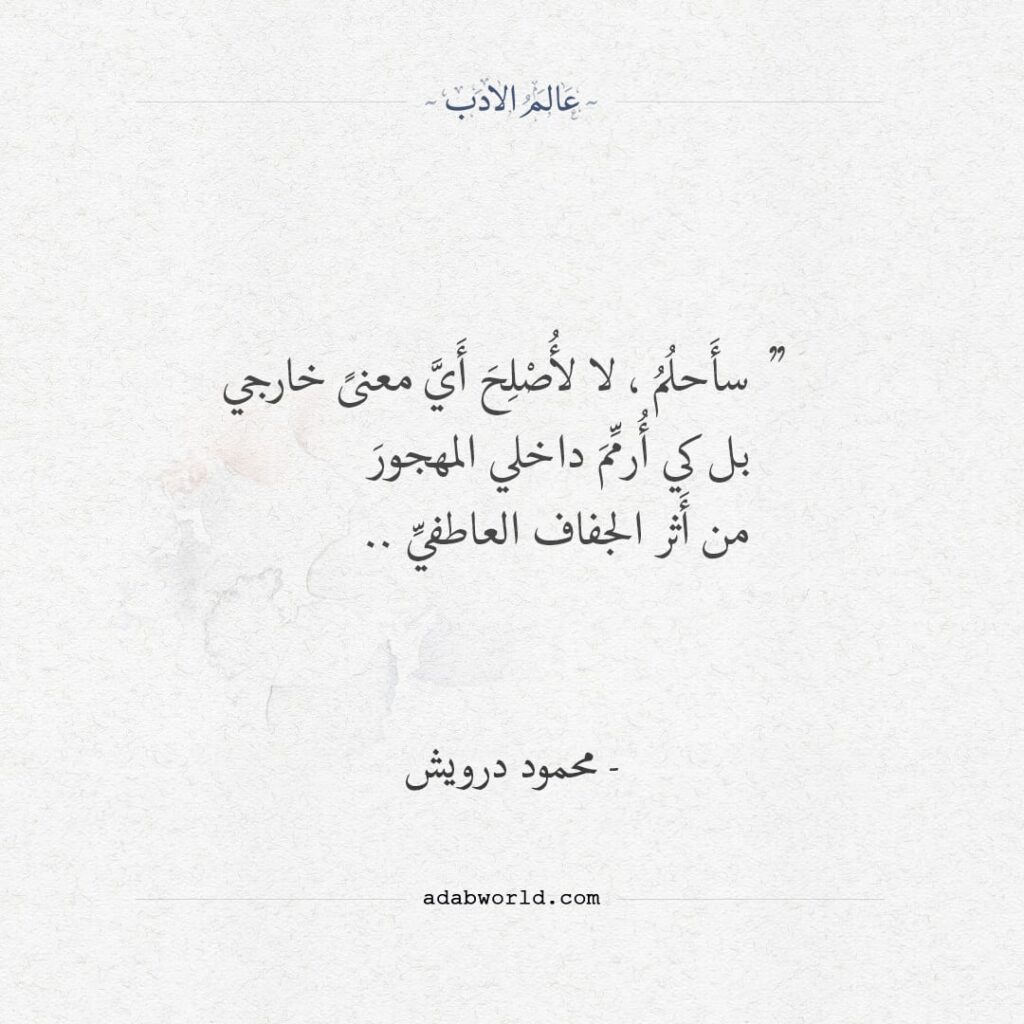
تعليقات